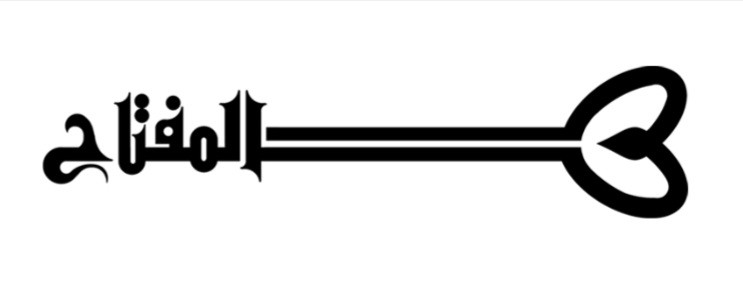منذ الاجتياح الفرنسي لمصر في عهــد بونابرتَ، والعالم الإسلامي والعربي يزدادان تشتتا وترسيما لمفهوم جديد ساد وهو “الدولة الوطنية” [Nation State]؛ هذا على مستوى الخارج، ومستوى الموضوع، أما على مستوى الداخل، ومستوى الذات، واجه خطط الاستبداد والعسكرة، متأهبةً لنفْي المخالفين، ومسارعة إلى الدماء، وإزهاق الأنفس ماديا ومعنويا. وتبدو هاته الخلاصة للوهلة الأولى وكأنها حُكْــمُ قيمة، أو تحيزا ضد الجهود التي تُبْذَل طيلة التاريخ الحديث على الأقـل، في استنهاض الهمم، وإيقاظ الفِكَـر، وتجاوز الواقع السيء المبني على تاريخ سحيق هاته الممارسات، وغيرها، غير أن القصد لدينا هو الانكفاء على نقد ذاتي فعّـال ينهض بهِمم عالية متوفرة، وينبه إلى أخطاء الماضي والحاضر، ويستعجل المساءلة من أجل المصالحة الفورية، والتعالي إلى إنسانية فكرا وممارسة، نابعيْن من إعادة حضورنا بصفتنا أُمَّة، أو أمة أمم، لا ضير، تتطلع إلى أن تكون مزيدا في العالم، ومساهمة في تطوير القيم الأخلاق، بدلا من المرابطة على ثغر الإرهاب، والتدمير، ولوم بقية الإنسانية على كونها تتآمر على هاته القطعة الجغرافية، وإنسانِها.
نقف اليوم بصفتنا أفرادا متفرقين من هذا الكمّ الهائل من الناس الذين وضعهم القدر في منطقة ملتهبة، واجهت التحرشاتِ الصليبيةَ، وقاومت الاحتلالَ بأنواعه، وصارعت من أجل تحديات الاستقلال، وتصفية الاستعمار، وانقسمت بين أُمم الحرب الباردة، وخدمت أمّة الشرق تارة، ورعت مصالح أمّة الغرب تارة أخرى؛ ولكنها لم تستفد شيئا من هاته الرعاية، إذ من توسل غطاء الآخرين بقي بغير كساء.
إلا أن الذي لم يفارق منطقتنا كان متلازمة واحدة، وهي الاستبداد، وقهر أبناء البلد، والتآمر على أبناء المنطقة على أن عرض هذه الأزمة الذاتية والبنيوية بقيَ ولم يتغير ونعني به “إسرائيل”، التي تشكل حقا أزمة ضمير إنساني عالمي مزمنة بامتياز. غير أن الذي يمكن ملاحظته هم ما يصرفه هذا الكيان على الطفل إلى أن يتخرج من الجامعة يضاعف بسنوات ضوئية ما تصْرفه “خير أمة أخرجت للناس” على إنسانها، مما يجعل أي مواجهة لهذا الكيان العنصري خاسرةً قبل دخولها، لأن المسألة لا تتعلق بمقاومة مادية وعسكرية، وحسب، بل هي مواجهة بين إنسان صالح، وآخر أينما توجهه لا يأت بخير، وهو كَلّ على عدوه، فهو يطعمه، ويسقيه، ويكسيه، ويسلحه، لمواجهته، إلى غير ذلك من سخريات القضاء ومآسي القدر التي تدفعنا إلى وجوب إعادة النظر في القضية برمتها، ونقد الذات دون خوف أو وجل، ولا أي عقد نقص، سواء أمام أصدقاء الأمة الذين يقلون يوما عن يوم بسبب بعدهم الإنساني عنها، أو أمام أعدائها المفترضين، أو أولئك الدائمين، أو الموقتين لسبب علينا رفعُه، أو لسبب سيرفعه الزمن، وتحسن الظروف المحيطة.
لقد ضحت منطقتنا بأهلها قبل أن يُضحيَ بهم شركاؤها المتشاكسون، لأنها ضحت بالتعليم والعناية الصحية، ونبذت العدل القضائي المستقل، واتخذت من الاحتكار الاقتصادي عقيدةً وديناً، وردمت الأخلاق في هُوّة سحيقة، وقبحت الجمالَ وعادت الفنونَ عداءً عقديا حتى تصحّر ذوقُ أبنائها وتاهوا، وضلت الرحمة قلوبَهم، فأصبحوا كأنهم بهائم تهيم في الأرض، وهي تظن أن الدينَ يقودها، وأن الشريعةَ الصحيحةَ رائدتُها. وفي هذا الباب، إذا نحن لم نواجه ديننا، وإيمانَنا بقوة، فلا ينبغي انتظار رسوما كرتونية جديدة، أو أفلاما.
أما من بقيَ من هذا الكيان؛ وخصوصا بلدان المغرب،(بلدان الغرب الإسلامي في التسمية القديمة) فهي تتلمّس طريقا غير السلامة، لأن أعراضَها هي أعراض البلاد الضعيفة؛ حيث تجدها مُمْعِنـةً في إعلاء الحَجَــر على البَشر، وترفع معدَّل نمو المباني دون التفات أو اكْتِـراثٍ لبنيها، وتستعرُّ من لسانها العربي المبين (الفصحى وليس اللغة العامية)، فهما على طرفي نقيض، وشتان بين لسان قوي بذاته، وآخر لغو لا قرار له، يتغير بتغير الطوارئ، كما أنها تستعير لسانا آخر فتتيه مقاصدها، ويا ليتها استعارت لسان العصر، وسايرت تقدمها العلمي، وقوّت من الترجمة وأنفقت عليها حتى تستطيع أن تبلغ الإشعاع اللازم، والاستقلال بآدابها وتراثها الفني والعلمي، في تصالح مع الحداثة المتأصلة من الذات، والنابعة من حاجاتها النفسية ومشاغلها الحقيقية، وليس تلك التي تقوم باستيراد الأسئلة واستيراد أجوبتها، وفي المحصلة لا نجد أن مشاكلها عولِجَت بالقدر الكافي وهي على مثل هذه الحال أزيد من قرن.
وعليه، فإن استمرار الحال كذلك بات خطرا على البيئة الإنسانية، ولذا، ومع هذا العُسْـــر، وهذه العُسْــرة، وعِظَـــمِ العيْلة (الحاجة ماسة التطرف) ينبغي لرواد أمتنا المعاصرين أن يأخذوا زمام المبادرة، وأن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية، وأن يسترخصوا المصالح العاجلة لدرء المفاسد الآجلة، وهي غروب كيانات الأمة الغائبة. فقد رأى من له قلب، وأحس أن شهادتَه على العصر أن الغرب، الذي حافظ كثير من نخبنا سياسيين ومثقفين واقتصاديين، ورجال أعمال، وعمال، لم يشفع لهم ذلك عنده، أن يبقيَنا موجودين، ولو كنا بدون حضور؛ أبى إلا أن يُجْهِز على كياناتنا ويشتتنا أيدي سبإ، لأن وجودَنا بات مشكلة في حد ذاته، وبات يشكل خطراً عليه، بعد أن استيقظ منا من استيقظ، وأعانه على هذا كثيرون من بني جلدتنا، ممن ارتموا في أحضان بريقه الخادع، ودعاواه، ومنها ما يوظف ضدنا من أيديولوجيا حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا يريد لأحد أن ينافسه فيها ولا أن يكون لأحدنا من استقلال وتفكير غير غربي. والمعنى أنه لم يعد جائزا في العالم أن تفكر خارج الدائرة الغربية، لذلك عواقب سيئة جدا، أن تفكر باستقلال عن الجاري به العمل، ولا أن تخرج عن دائرة التفكير الغربية.
لكن، لا نود أن يُفْهًــمَ من مقالنا هذا أننا نعلِن حربا على جهة، لا أننا نقبل بالموجود، وإنما هدفنا أن نعلن الحرب على الخمول والكسل، والاستبداد والاحتكار، وليعلم كل فرد من هذه الأمة الموجودة ماديا والغائبة تأثيرا في محيطها والعالم أن الوقت قد حان لنقف استهلاك أفكار وعقائد عفا عنها الزمن لكونها استحالت مثل غذاء انتهت صلاحيته. لنجعل من كرامة الإنسان، واحترام القانون وعدم الرضا بالاستبداد والاحتكار الاقتصادي دينا واعتبار ما عداه طقوسا خادعة ومخدرة وأفيونا (ليس مثلما قال ماركس)؛ بل ندعو إلى الانتباه إلى أن الدين الذي يقهر أتباعه، ويمنع عنهم العيش كرماء، وأسوياء ومتساوين وأحرارا أحق أن يحارب أكثر من عدو خارجي، لأن هذا الأخير لن يستطيع القضاء على أمتنا مادام أهلها مُكرَّميـن وعلى خُلُق عظيم، وغير مستقوين بالخارج.
أمتنا، أو ما بقي منها، لا تواجه اليوم خطر التأخر وحسْب، والغياب، فهذا بيّن منذ وقفت إنتاج المعرفة، وإنما تواجه خطر العدم والتلاشي.
فماذا نحن صانعون؟ من ذا الذي بإمكانه الحياةُ، ويفضل العدم والموت والغياب؟
المقال من espacemre/ فضاء مغاربة العالم