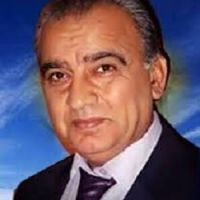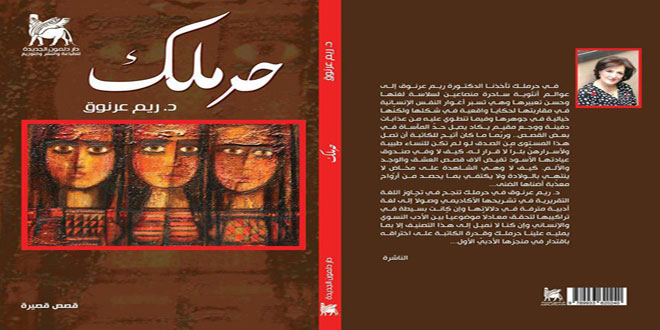يوسف إدريس.. “الطبيب المشاغب” دخل عالم الأدب بـ”المصادفة”!
- تعرّض للسجن 3 مرات في شبابه بتهمة ممارسة “العمل السري” ضد المستعمر البريطاني الذي كان يحتّل مصر
- حارب بجوار الثوار الجزائريين كتفاً بكتف في معارك استقلالهم عن المستعمر الفرنسي لمدة 6 أشهر
- “طبيب القصة” كان أكثر الكُتّاب ارتباطا بنبض المجتمع الحقيقي.. واهتم في أعماله بحياة البسطاء والمُهّمشين
- سجّل النقاد عليه أنه لم يحفل كثيرا بالتراث الأدبي العربي ولم يكن يرى فيه سوى “ألف ليلة وليلة” فقط!
- تُرجمت أعماله إلى 24 لغة عالمية وحصل على جائزة الدولة “التشجيعية” في الأدب عام 1966 و”التقديرية” سنة 1991
الأديب الكبير الراحل د. يوسف إدريس، طبيب “اختطفه” الأدب من مهنة الطب، فعاش حياة حافلة بالمعارك الأدبية والسياسية بل حتى “الحربية”، حيث اعتُقل أثناء دراسته الجامعية في الخمسينات من القرن الماضي، بتهمة ممارسة “العمل السري” ضد المستعمر البريطاني الذي كان يحتل مصر وقتها، كما قاتل كمحارب حقيقي مع الثوار في الجبال أثناء الثورة الجزائرية أوائل عقد الستينات، وخاض معارك فكرية شرسة، حتى استحق لقب “الأديب المشاغب” عن جدارة!
وُلد “إدريس” يوم 19 مايو 1927، في قرية تُسمى “البيروم” تابعة لمحافظة الشرقية في دلتا مصر، لأسرة من متوسطي المزارعين تضم عدداً من المتعلمين “الأزهريين”، وكان والده متخصصاً في استصلاح الأراضي، مارس مهنته هذه في مناطق مختلفة من الدلتا، وأرسل ابنه الكبير “يوسف” ليعيش مع جدته في القرية، فتركت حياة الريف أثراً بالغاً في نفس الصبي الموهوب، حيث صار خبيراً بحياة الفلاحين البائسة التي صوّرها – فيما بعد- في قصصه ورواياته بدقة لا تخلو من القسوة.
اعتقال “طالب طب”
أراد الطفل “يوسف” منذ صباه المبكر أن يكون طبيباً، فالتحق بكلية “الطب”. وفي سنوات دراسته الأولى بالكلية شارك في مظاهرات ضد المستعمر البريطاني. وفي 1951 أصبح السكرتير التنفيذي لـ”لجنة الدفاع عند الطلبة” التي كانت تتولى أمور الطلاب والطالبات أمام الجهات الرسمية، ثم سكرتيراً لهذه اللجنة، وبهذه الصفة نشر “إدريس” مجلات ومطبوعات ثورية ضد الاستعمار البريطاني، وضد رجال حاشية “الملك فاروق” الفاسدين، وتعرض للاعتقال 3 مرات لبضعة أشهر بسبب نشاطه السياسي، وتم فصله من الكلية لعدة أشهر، ثم عاد فاستأنف دراسته مجدداً.
وكان “إدريس” منذ صباه غزير الثقافة واسع الاطلاع بشكل يصعب معه تحديد مصادر ثقافته، حيث اطلع الرجل على الأدب العالمي وخاصة الروسي، وقرأ لبعض الكتاب الفرنسيين والإنجليز، كما كان له قراءاته في الأدب الآسيوي، حيث عشق الكُتّاب الصينيين واليابانيين، ولكن ما سجله النقاد عليه أنه لم يحفل كثيرا بالتراث الأدبي العربي، ولم يكن يرى فيه سوى “ألف ليلة وليلة” فقط!
وفي أثناء سنوات الدراسة الجامعية كان يحاول نشر كتاباته القصصية، حيث بدأ نشر قصصه القصيرة في عدة مطبوعات صحافية كانت رائجة وقتها، منها صحيفة “المصري” ومجلة “روز اليوسف” وغيرهما، وفي 1954 ظهرت مجموعته القصصية الأولى تحت عنوان “أرخص الليالي”.
وبعد تخرجه في الكلية، وحصوله على “بكالوريوس الطب” عام 1947، حصل على دبلوم الأمراض النفسية ودبلوم الصحة العامة، وعمل في المستشفيات الحكومية وكان مفتشاً صحياً في “الدرب الأحمر” وهو حي شعبي في القاهرة.
وعمل الكاتب بعدها كطبيب “ممارس عام” في مستشفى “قصر العيني” بين أعوام 1951 – 1960؛ ثم تخصص في الطب النفسي، وعمل “مفتش صحة”. وبعد نحو 10 سنوات من ممارسة الطب ترك المهنة نهائياً، واشتغل بالصحافة كمحرر في صحيفة “الجمهورية” لسان حال نظام 23 يوليو الذي كان يقوده جمال عبد الناصر و”الضباط الأحرار”.
وأصدر الكاتب مجموعته القصصية الأولى “أرخص ليالي” عام 1954، لتتجلى موهبته في مجموعته القصصية الثانية “جمهورية فرحات” عام 1956، الأمر الذي دعا عميد الأدب العربي طه حسين لأن يقول: “أجد فيه دائماً من المتعة والقوة ودقة الحس ورقة الذوق وصدق الملاحظة وبراعة الأداء، مثلما وجدت في كتابه الأول (أرخص ليالي) على تعمق للحياة وفقه لدقائقها وتسجيل صارم لما يحدث فيها”.
وفي سنة 1957 تزوج “إدريس” من السيدة رجاء الرفاعي، ورُزق منها بثلاثة أبناء هم “سامح” و”بهاء” و”نسمة”. وتحدث الرجل عن قصة زواجه قائلاً: “تزوجت في مرحلة من حياتي أحسست فيها بالوحدة فعلاً! وفي هذه الظروف قابلت زوجتي وأحسست أنها من الممكن أن تكون رفيقة العمر، أحسست أنني أريد أن أجلس معها وأتعرف عليها، وأصادقها.. فتزوجت! وقلت لنفسي بهذا الارتباط لا أتزوج! وضعت في قرارة نفسي لافتة داخلية مكتوب عليها: هذا العمل الذي قمت به ليس زواجاً وإنما أنا أريد أن أعرف هذه الإنسانة معرفة حقيقية وتعرفني هي الأخرى، ولكن مجتمعي يمنعني من أن افعل ذلك إلا بالزواج، فتزوجت!”.
وعن مخاض الإبداع عند “إدريس” قالت زوجته السيدة “رجاء”: “حينما كان يوسف يكتب كنت أجلس أمامه، ويقتصر دوري علي إعداد الشاي أو القهوة فقط. وبعد أن يكتب جملة أو جملتين يندمج تماماً ويغيب عن كل ما حوله ويبدأ في التشويح والإشارة، ويتمثل الشخوص التي يكتب عنها، ويشعر بأنها حوله تكلمه وتلمسه!”.
مقاتل في جبال الجزائر
في عام 1961 انضم “إدريس” إلى المناضلين الجزائريين في الجبال، وحارب معهم كتفاً بكتف في معارك استقلالهم عن المستعمر الفرنسي لمدة 6 أشهر، وأُصيب خلال ذلك بجرح خطير، فأهداه الجزائريون وساماً رفيع المستوى إعراباً عن تقديرهم لجهوده في سبيلهم، وعاد إلى مصر، وقد صار صحفياً معترفاً به حيث نشر روايات قصصية، وقصصاً قصيرة، ومسرحيات.
وبعد عودته من الجزائر في عام 1963، حصل “إدريس” على “وسام الجمهورية” واعترف به الجميع ككاتب من أهم كُتّاب عصره. إلا أن هذا النجاح والتقدير الرسمي لم يمنعه من الانشغال بالقضايا السياسية المثارة في عصره، وظل مثابراً على التعبير عن رأيه بصراحة مطلقة، يبدو أنها لم تكن تناسب نظام 23 يوليو، حيث نشر في عام 1969 مسرحيته “المخططين” منتقداً فيها نظام عبدالناصر بشدة، فمنعت “الرقابة” عرض المسرحية، وإن ظلت قصصه القصيرة ومسرحياته غير السياسية تنشر في القاهرة وفي بيروت. وفي 1972 اختفي من الساحة العامة، على أثر تعليقات له علنية ضد الوضع السياسي في عصر “السادات”، ولم يعد للظهور إلا بعد حرب أكتوبر 1973 عندما أصبح من كبار كُتّاب صحيفة “الأهرام”.
عايش “إدريس” في مرحلة الشباب فترة حيوية من تاريخ مصر من جوانبه الثقافية والسياسية والاجتماعية، حيث الانتقال من الملكية بكل ما فيها من متناقضات، إلى نظام 23 يوليو بكل ما حمله من آمال، ثم وقوع “النكسة” سنة 1967 وما خلفته من هزائم نفسية وآلام، ومن ثم النصر العربي العظيم على العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1972، بكل ما كان انطوي عليه ذلك من استرداد لعزة وكرامة الشخصية العربية، وبعد ذلك تطبيق سياسة “الانفتاح الاقتصادي” في مصر، وما تبع ذلك من آثار سلبية وخيمة على المجتمع المصري، من تخبط وتغير في بنيته الثقافية والنفسية والاجتماعية.
وأحدث نهج “إدريس” القصصي تغيّراً جذرياً في كتابة القصة القصيرة، في نهاية الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، فالتصوير الواقعي، البسيط، للحياة كما هي في الطبقات الدنيا من المجتمع الريفي، وفي حواري القاهرة، يتلاشى، ويظهر نمط للقصة أكثر تعقيداً. وتدريجيًا، لتصبح المواقف والشخصيات أكثر عموميّة وشموليّة، إلى أن قارب نثره تجريد الشعر المطلق. ويشيع في أعماله جو من التشاؤم، وينغمس أبطال القصص في الاستبطان والاحتدام، ويحل التمثيل الرمزي للموضوعات الأخلاقية والسياسية محل الوصف الخارجي والفعل المتلاحق.
وقدمت أعمال “إدريس” في مجال القصة القصيرة وعياً مختلفاً عن كل من كتبوا القصة قبله، ولا يكمن اختلافه فقط في التقنيات، ولا في طريقة مقاربة الواقع، ولا في تخلصه من شوائب “الرومانتيكية” والغنائية، إنما في عينه التي تنفذ إلى الجوهر، ولا تعميها غشاوة التعاطف المجاني التي تمنع الكاتب من الوصول إلى أعماق شخصياته وعالمه.
وفضلا عن أعماله الإبداعية، كتب الرجل عدداً كبيرا من المقالات التي جمعها في كتب كان آخرها بعنوان “فكر الفقر وفقر الفكر”، غير أن مقالاته لم ترق أبداً إلى مستوى إبداعه القصصي. وعن ذلك قال الناقد الراحل فاروق عبد القادر إن “مقالات إدريس لا تثبت لنقاش جاد إذ كان يعبر في معظمها عن حساباته ومصالحه أكثر منها عن اقتناعاته الحقيقية”.
واعترف الرجل في أكثر من حوار صحافي وإذاعي بأنه دخل عالم الإبداع القصصي بـ”المصادفة”، وقد أهلّته دراسته الطبية وأفقه العلمي وسعة معرفته، لتشخيص أزمة الركود والجمود التي تعيشها القصة العربية عامة، خوفاً عليها من الوصول إلى “طريق مسدود”.
أزمة آخر العمر
يرى بعض النقاد أن ثمة أزمة فنية وإبداعية سيطرت على حياة “إدريس” الأدبية وغلفت أعماله في أواخر مرحلة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، حتى إنها بدت شكلاً من أشكال “الانهيار” الفني والفكري مر به الكاتب الكبير، إذ صمت الكاتب عن الإبداع والعطاء صمتاً طويلاً ومريباً. ومن المحزن أن هذا الكاتب المبدع راح خلال أخريات فترة الصمت هذه يحاول محاولات يائسة لينقذ سمعته ويسترد موهبته الذائعة الصيت ؛ فقد كتب في أواخر السبعينيات بعض المحاولات القصصية، منها على سبيل المثال قصة “الرجل والنملة” والتي نشرها في مجلة “الدوحة”، لا يكاد القارئ يصدق أنها من إبداع إدريس، حيث جاءت القصة بعيدة عن الإشراق الباهر الذي تميّزت به قصصه القصيرة السابقة.
ويعلل الناقد د. اسكندر نعمة ذلك بـ”اعتماد الكاتب الراحل على الموهبة الطامحة فحسب، فاضطرب عالمه القصصي على الرغم من النجاح الكبير الذي بلغه، والشأن الرفيع الذي ناله، ودليل هذا الاضطراب التداخل في عالم إدريس القصصي بين أجناس أدبية مختلفة ، لقد صمم الأديب أن يدخل عالم المسرح، فكانت تجربة المسرح عنده على حساب اهتماماته القصصية لفترة غير قصيرة من الزمن، إلا أن أهم مظاهر أزمة إدريس القصصية تتضح في ممارسته وبنشاط محموم وعزيمة كاملة كتابة المقالة، خاصة بعد أن كرس ذاته ووقته للصحافة فقط، فقد انساق بقوة جارفة إلى معالجة أزمة الحرية والحياة الاقتصادية والاجتماعية عربياً ومحلياً، فكان ارتداده لكتابة المقالة السياسية والاجتماعية أحد جوانب الانجراف لمعالجة هذه الأزمة الحضارية والإنسانية، فتوقف عن كتابة القصة وجرفه تيار المقالة السياسية والاجتماعية، وازدادت الأزمة لديه عمقاً ووضوحاً”.
وقدم الأديب الراحل خلال رحلة إبداعه للأدب العربي 20 مجموعة قصصية و5 روايات، وكان الطبيب القاص أو “طبيب القصة” أكثر الكُتّاب ارتباطا بالشارع والمجتمع، واهتم في أعماله بحياة البسطاء والمهمشين الذين يصنعون تفاصيل الحياة اليومية، فقد جمع في أعماله بين نظرة الصحافي والأديب والمفكر، وكان على معرفة عميقة بواقع المجتمع المصري الذي تناوله بالنقد بالسخرية الأدبية اللاذعة والجريئة.
وتُرجمت أعماله إلى 24 لغة عالمية، منها 65 قصة ترجمت إلى الروسية وحدها، وحصل على جائزة الدولة “التشجيعية” في الأدب عام 1966 والجائزة “التقديرية” سنة 1991 قبل وفاته بأشهر قليلة.
وبعد “رحلة شغب” طويلة مع الكتابة والسياسة، استمرت نحو 40 عاماً، توفي الكاتب الكبير في أول أغسطس سنة 1991، وترك أعمالاً شهيرة لا تزال تتمتع بمقروئية عالية حتى الآن.