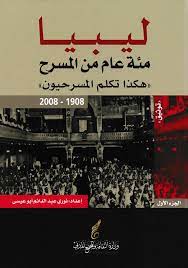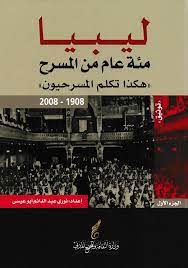


ليبيا مائة عام من المسرح”1908م- 2008م”أوهكذا تكلم المسرحيون -2-54 – نوري عبدالدائم
**************************************
” الميت الحي ” .. عندما يفقد الإنسان إنسانيته
بقلم / نجيب نجم
الموت بتعريفه المطلق دلالة على انفصال الروح عن الجسد وتعطل كل أجهزة الاحساس والشعور لدى الإنسان ولكن هذه
الصفة تطلق مجازاً على الكائن البشري الذي ينبض قلبه وتتحرك أعضاؤه من دون أن يدرك مجريات الأمور المحيطة به
وتتعطل مراكز الحس لديه وتعمى بصيرته عن تمييز الأشياء ويحق عليه القول بأنه ” الميت الحي ” .
كثيراً ما تتضارب الآراء وتحتدم المناقشات الجدلية حول الانفصال الواضح بين جذور الماضي وبراعم الحاضر وأزهار
المستقبل بحيث تبدو معالم الحياة وكأنها سلسلة مفصولة الحلقات كل منها يعتبر الأخرى في عداد الموتى على الرغم
من وجودها في بحر الحياة الديناميكي وتلقى كل حلقة بأوزار هذا الأمر على الأخرى.
ويتبادر إلى الذهن المحلل والمدقق السؤال عن السبب الحقيقي لهذا الانفصال هل هو من ذات الحلقة أم من
المتغيرات التي تطرأ بجنون على الساحة.
حول هذه المفاهيم والتساؤلات جاءت صياغة مسرحية (الحي الميت) للأديب الفنان (محمد العلاقي) قدمها معهد جمال
الدين الميلادي ممثلاً لدولة (ليبيا) في مهرجان (أيام قرطاج المسرحية 93) داخل المسابقة الرسمية.
تتصدر الفراغ المسرحي لوحة لبنايات إحدى المدن يغلفها السكون وفي المقدمة وجه لفتاة بزيها الدال على زمن
الماضي تحجرت عيونها وبدت نظراتها الزائغة وهي شاردة كمن يحاول اختراق حاجز الزمن والاطلال على ما يدور في
الساحة في الوقت المعاصر ويصاحب ذلك نبرات وترية لموسيقا هائمة في فراغ المجهول.
تبدأ اللوحة في التشقق وتظهر من هذه الشقوق بالتتابع أقدام لشاب وجه لشخص يطلق عليه لقب (الحاج) جسد نصفي
لشخص يطلق عليه (الشيخ) ثم جسد فتاة وفي حركة ترقب وتأمل ذات إيقاع بطيء تبدو علامات الحذر من خروج هذه
المجموعة من عالم الماضي البعيد إلى دائرة الواقع.
تستمر حركة الظهور لهذه الأشخاص رويداً رويداً إلى أن تتجسد كاملة في فراغ المنصة ويقفون على مسافات متباينة
حول تابوت مغلق يتوسط المنصة وتستمر حركة الترقب مع الدوران واحتلال الأماكن بالتبادل على غرار لعبة الكراسي
الموسيقية ويبدو خلال هذه الحركة مدى التنافر بين أطراف اللعبة.
لعبة التابوت
يجلس الرجال الثلاثة فوق التابوت ومازالت علامات التنافر بادية عليهم بينما تقف الفتاة في عمق منصة المسرح
وعيناها تجولان في المكان في محاولة للتعرف إلى أسرار العالم المعاصر وبعد فترة من هذا الجو السائد على
المكان تبدأ عمليات المناقشة حول رفع هذا التابوت من مكانه وتنتحيه إلى مكان آخر حتى لا يعوق حركة البحث
والتقصي عن اسرار الحياة السائدة في المكان.
وتنطلق عبارات التحاور بين الحاج والشاب في صراع محتدم:
-لابد من نقله من جهة اليسار إلى جهة اليمين.
-لا يجب نقله من جهة اليمين إلى جهة اليسار.
-أنا مصر على نقله من جهة اليسار إلى جهة اليمين.
-أنا أيضاً مصر على نقله من جهة اليمين إلى جهة اليسار.
يحاول (الشيخ) أن يقرب وجهات النظر بينهما ولكن من دون جدوى فكل منهما مصر على رأيه ولا يقبل التنازل للآخر
ويقف (الشيخ) في اتجاه الماهدين ويطلب منهما النظر إلى أن ما هو يمين بالنسبة إليهما هو يسار بالنسبة إلى
المشاهدين ويقتنع الاثنان بوجهة النظر التي تحقق رغبة كل منهما من دون أي تنازل.
يقوم الثلاثة بنقل (التابوت) إلى إحدى الجهات وابقائه في مكانه ثم يعاودون رحلة البحث في فراغ الساحة وتعود
المناقشات بينهما حول الاحتفالية الخاصة بالتابوت وتعود عمليات التضادي في رغبة كل منهما في إلقاء أغنية
معينة وتبرز إلى أرض الواقع مدى الاختلاف في الآراء لمجرد الاختلاف وعدم القدرة على الاتفاق على رأي واحد بينما
تصرخ (الفتاة) معلنة أنها لا تفهم شيئاً مما يدور.
تتطرق الاحداث الجدلية إلى خصائص الأشياء التي تمر في الحياة اليومية حيث تبرز أمنيات كل منهم في تصور للحياة
التي يريدها وتلقى ظلالا حول العبث الذي يسود النظريات والعقائد والمعتقدات ومدى ما جنح إليه العقل من تصورات
خيالية لا تمت للواقع بصلة كل هذا والفتاة مازالت على صراخها وقولها إنها لا تفهم شيئاً.
تتجه أنظار الرجلين (الحاج والشاب) إلى (الفتاة) وتلمع في الأعني رغبات الشهوة والرغبة في الاستحواذ عليها
وتنتقل هذه المشاعر إلى قلبها وينتابها الرعب والفزع ونراها وهي تجري خلف اللوحة هرباً من تلك الرغبة الزائغة
في أعين (الحاج) بينما نجد (الشاب) يصعد درجات ملتصقة بجانب اللوحة في محاولة لاعتلاء القمة الحاكمة على
بنايات المدينة الساكنة وكلما اقترب من الفتاة ناداها (اصعدي معي .. سوف تكونين في أمان معي) ولكنها مازالت
على حذرها ومخاوفها وترفض الانصياع لرغبات كل منهما معلنة إنها لا تفهم شيئاً مما تسمع.
يخلع (الشيخ) عمامته ويبدو على حقيقته المغلفة وراء القناع الذي يرتديه وتنتابه أيضاً نفس الرغبة في الاستحواذ
على الفتاة ويستمر الصراع بين الرجال الثلاثة وبين الفتاة التي تحاول أن تجد لها ملاذ يكفل لها الأمن من الأطماع
البربرية.
ينشق التابوت وسط ذهول الأربعة الموجودين ويخرج منه جسد يتحرك في شكل الإسان الآلي وبعد فترة من الخوف الذي يعم
المكان تتم عدة محاورات بين الموجودين وبين الميت الآلي يتضح منها عدم إمكانية التفاهم حيث فقد ذلك الميت كل
أسباب ومسببات الحياة فهو بل عقل يفكر وليست لديه أي بادرة من بوادر الاحساس وكأنه قد تحول من حالة الحياة
الحقيقية إلي حالة الحياة الإكلينيكية حيث يتحرك آلياً بطريقة البرمجة.
يتراجع الأفراد الأربعة بنفس إيقاع الظهور إلى اللوحة وتبدأ عمليات الاختفاء التدريجية والتي تعيدهم إلى الحالة
الأولى التي ظهروا عليها مع رفضهم لهذا الواقع المشين وتوعدهم بضرورة العودة مرة أخرى وهم أقوى على السيطرة
الكاملة على هذا الواقع وتغييره وإعادة الصورة الجميلة للإنان الذي يحيا بالصورة اللائقة المحملة بالاحساس
والشعور بالذات والقيم والعادات والبعد عن كل المساوئ التي فرضها متغير القوة الواحدة في هذا العصر بحيث حكم
على الإنسن أن يكون الميت الحي.
التأليف
كاتب النص هو الفنان “محمد العلاقي” رئيس قسم الدراما بمعهد جمال الدين الميلادي ، وهذه هي التجربة الأولى في
مجال التأليف المسرحي ، ولعل ثقافته وأفكاره في الحياة ،ورحلة معاناته الذاتية ، وتفاعله مع واقع مجتمعه ،
وما يدور فيه من متغيرات مفروضة جعلته يحدد الهدف الأساس لموضوع مسرحيته ، فاختار الإنسان كقيمة اصطفاها
الخالق وأولاها الخلافة في الأرض وفضلها على سائر المخلوقات ، حيث خصه بالعقل والتفكير والاحساس ،وحاول أن يجعل
منه العمود الفقري لرؤيته المسرحية .
كان تصوره لحقبة الماضي ،وما تحمله من قيم واخلاقيات ، في منتهي الذكاء والتصوير المسرحي المحنك ، حيث جعله
باديا وكأنه صورة رسمها رسام وأبرز فيها جماليات ذلك الزمن ، وصدّر فيه وجه “الفتاة” الدالة كرمز على الوطن ،
وهي ذات عينين واسعتين جامدتين ، تبحثان عن ذلك العالم الحالي المجهول ، المليء بكل التناقضات ، كما أوجد
الخلفية الدالة على البنايات المحتفظة بجمالياتها ، ولكن في جمود باعث على الأسى لما هو دائر حاليا من تشويه
لكل ماهو جميل .
عندما دبت الحياة في احداث القادمين من الماضي ،ولدى انصهارهم مع الواقع الحالي ، تغلغلت في نفوسهم
المتناقضات والمشاحنات ، نتيجة للخلاف والشقاق الذي أكدته القوة لواحدة ، وأصرت على بذره في النفوس ، حتى
تحقق مبدأ ” فرق تسد” .. وبهذا التصوير يدق الكاتب ناقوس الخطر ، ويطلق إشارات التحذير مبينا مغبة هذا
الاختلاف والوقوع في منزلق ” الاتفاق على عدم الاتفاق”.
أوضح الكاتب في أسلوب رمزي واضح وغير مبهم مدى سيطرة الأهواء الشخصية ، والرغبات الذاتية والاطماع الأنانية ،
التي تسود المجتمع ، حيث يحاول كل فرد ان يحقق مصالحه الشخصية من دون الالتفات إلى المجتمع وصالحه كوحدة
متكاملة ،وذلك من خلال مشاهد مجادلات السيطرة على ” الفتاة”، باعتبارها رمزاً “للوطن” كما كشف المستور خلف
الأقنعة التي يرتديها الأفراد لإخفاء تلك المطامع والأهواء.
وصلت ذروة الحبكة الدرامية ، وتحقيق الهدف المنشود ، من خلال تجسيد شخصية الجسد الخارج من التابوت ،والذي
يتحرك آليا ،وهو بذلك يقرر حقيقة ربما غفلت عن الكثير ،والتي توضح مدى ماوصل إليه الإنسان في الوقت المعاصر ،
خصوصاً في دول العالم الثالث ، من فقدانه للإحساس والتفهم لما يدور حوله ،وضعفه وخنوعه أمام تلك القوى
المسيطرة ،وتفككه كإنسان يحمل قيماً وأخلاقيات ، كما يترحم على الصورة التي كانت عليها البشرية في الزمن
الماضي ويطلق شعارا هاما بأن الإنسان إذا ما فقد جذوره وانتماءه لقيمه وعاداته وتقاليده فانه من دون شك ”
الميت الحي”.
الصورة التي جاءت عليها الصياغة المسرحية ، من حيث الاعتماد على الحركة والانفعالات للشخوص ،وقلة الحوار اللفظي
، تدل دلالة كافية على تمكن المؤلف من أدوات اللعبة المسرحية بكل أبعادها ، ومعرفته الجيدة لإطلاق الفنان
لفكرته للتجسد على منصة العرض ، وهو باستخدامه للمزج بين الرمز والواقع يؤكد نضجه الفني وقدرته العالية
كمؤلف مسرحي على مستوى عال من الكفاءة .
الممثلون
عبد الله الأزهري “الشيخ ” ممثل خفيف الظل ، له حضور مسرحي متوهج تفهم أبعاد الشخصية بكل متناقضاتها ، وبرع في
إبراز كل جوانبها ، واستطاع ان يجسد الانفعالات الداخلية بشكل ساخر وأسلوب سلس أوصله لقلوب المشاهدين .
محمد عثمان ” الشاب” وجه معبر قادر على إبراز الايماءات الموحية بمدلول الموقف ، متمكن من التلاعب الصوتى
تفوق على نفسه في المحاورات المتناقضة مع “الحاج” وأكد ذاته كممثل واعد في حواره مع “الفتاة ” عندما كان
يحاول بث الأمان لديها ،وهو مكسب حقيقي للمسرح الليبي .
عائشة عثمان “الفتاة” على الرغم من صغر المساحة الممنوحة لها ، إلا أنها استطاعت بكفاءة تجسيد الشخصية من خلال
نظرات عينيها الزائغة ، وحركات أطرافها الواعية بكل الانفعالات التي أرادها مؤلف النص ، وتبشر بكل الخير
كممثلة مثقفة مدركة لكل أدوات الفن المسرحي.
عبد الحميد التائب “الحاج” ممثل متمرس ، راسخ القدم ، قادر على التحكم في مخارج الألفاظ ، والتدرج في درجات
التعبير الصوتي ، أبرز شخصية الطامع الانتهازي بشكل متميز استحق التقدير والإشادة .
محمد العجيلي “الميت” على الرغم من صعوبة الدور ، والاعتماد على التعبير الحركي فقط ، إلا أنه انتزع إعجاب
المشاهدين وتصفيقهم أكثر من مرة ، وأثبت انه ممثل إيمائي من الطراز الأول .
الإخراج
تعامل الفنان ” محمد العلاقي” مع النص من خلال مخزونه الأكاديمي ودراساته المتعددة وأستاذيته بمعهد جمال الدين
، وحدد أسلوبه الإخراجي من خلال عملية المزج بين الرمزية والواقع ،وروح الكباريه السياسي.. ولعل نجاحه في ذلك
يرجع الى كونه المخرج الأصلي على الورق ، الذي ألفه وحرك شخوصه قبل ان تتم عملية التشخيص ،وبذلك جاءت قدرته
القائمة في إحكام قبضته على حركة الممثلين ، وإبرازه للكادر المسرحي بكل جمالياته ..من حيث التلاحم بين
الديكور والأشخاص والتغليف الموسيقي ، كما استخدم الإضاءة استخداما علميا ، بحيث أصبحت شخصا حياً يتحرك ويتفاعل
مع الممثلين ،وليس هناك شك في انه ضرب مثلاً أمام كوكبة المخرجين من جميع أنحاء العالم في أيام قرطاج على
كفاءة ومقدرة المخرج الليبي العالمية .
ويجدر التنويه إلى أن عرض “الميت الحي” يعتبر نموذجاً مشرفا لمدى ما وصل إليه فن المسرح الليبي ، الذي فرض
نفسه على ساحة المهرجان الدولية .