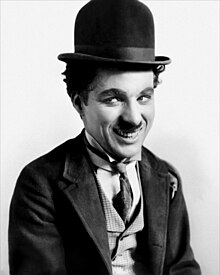المسرح في سورية
المسرح ظاهرة فنية مركبة، لا تتحقق نتاجاً بصرياً-سمعياً إلاّ في عمل جماعي تتضافر فيه جهود مجموعة من البشر، منسجمة أو متقاربة في مشاربها وتوجهاتها الفنية والفكرية، ولا يتخلق العرض المسرحي إلاّ على قاعدة اقتصادية توفر أكلافه قبل أن يتلقي بالجمهور الذي هو الطرف الآخر في هذه المعادلة الثنائية. وقد أثبت التاريخ منذ البدايات أن المسرح لا ينهض ويزدهر إلاّ عندما يمر المجتمع بمنعطف حاسم في تطوره، يوطد أركانه وطنياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، مما يتيح للحركة الثقافية أن تنفتح، ومنها المسرح.
أما بصدد المسرح العربي الذي بدأ في شكله الحديث المستورد من أوربا مع عرض مسرحية «البخيل» لمارون النقاش في منزله ببيروت عام 1848، فقد كانت انطلاقته امتداداً لأفكار عصر النهضة العربية، التي حملتها البرجوازية المدينية الناشئة على أكتاف مثقفيها، ممن احتكوا بالغرب وأتقنوا لغاته، أو بالأستانة العثمانية المهيمنة. هذا إلى جانب امتلاك هؤلاء المثقفين معرفة واسعة بتراث وطنهم ولغته، ووعياً كافياً بضرورات المرحلة التي يمر بها على مستوى الثقافة التنويرية. إلا أن مبادرات هؤلاء المثقفين لإيجاد المسرح على مستوى الإعداد والتأليف والترجمة والعرض كانت فردية ومتباعدة لأسباب عدة، منها ظروف الهيمنة العثمانية وسياسة التتريك المعادية لأي توجه عروبي، إلى جانب الرجعية الدينية آنئذ المناهضة لحركة التنوير، وما حدث مع أبي خليل القباني في دمشق خير دليل على ذلك. وعلى الصعيد العملي المادي، لم تتوافر شروط تضافر أو استمرارية هذه المبادرات، إذ لم تكن هناك دور عرض مسرحي أو ممثلون وفنيون كي يتحقق للعرض المسرحي المبتغى شرطه الفني اللائق الذي كان سيشكل عنصر الجذب نحو هذا الشكل الفني الجديد الطارئ الذي لم يألفه الجمهور العربي ولم يتقبله آنئذ.
لقد أبرز النصف الثاني من القرن التاسع عشر في بيروت ودمشق عدداً من المسرحيين الرواد الذين تولعوا بالمسرح وشغفوا بدوره الاجتماعي الفني والفكري، فوقفوا له حيزاً كبيراً من وقتهم، لكنهم لم يحترفوه، لاستحالة ذلك اقتصادياً. من هؤلاء مارون ونقولا وسليم النقاش، وأديب إسحاق، ويوسف خياط، وأبو خليل القباني وجورج دخول وسليمان القرداحي وإن تمكن أحد هؤلاء من تشكيل فرقة مسرحية أو الانتماء إلى إحداها، فقد كانت عروضهم تقدم لليلة أو اثنتين في الأندية أو الجمعيات أو المدارس أو حتى في الخانات. وفي ظل هذه الأوضاع الخانقة في بيروت ودمشق، وتوافر جو مختلف اجتماعياً وسياسياً في مصر، في عهد الخديوي إسماعيل، هاجر معظم المسرحيين الشاميين إلى الإسكندرية والقاهرة، وأسسوا مع من لحق بهم فيما بعد، ومع المسرحيين المصريين الحركة المسرحية العربية التي انعكس شعاعها على الوطن العربي في جميع بلدانه من خلال الجولات التي قامت بها الفرق المسرحية المحترفة، مثل فرقة الشيخ سلامة حجازي، وفرقة جورج أبيض، وفرقة فاطمة رشدي، وفرقة رمسيس، وفرقة سليمان القرداحي، معتمدة في عروضها على نصوص مؤلفة أو مقتبسة أو مترجمة. إلاّ أن التأليف كان يشغل الحيز الأكبر من عروض هذه الفرق، كمسرحيات فرح أنطون، وإبراهيم رمزي، ومحمود تيمور، واسكندر فرح، إلى جانب القباني، وإسماعيل عاصم على صعيد المسرح الغنائي أو الأوبريت التي بلغت ذروة ألقها مع موسيقى سيد درويش.
ثمة وجوه للتشابه وأخرى للاختلاف بين المسرح السوري في العقود الستة الأولى من القرن العشرين، وبين المسارح العربية الأخرى ولاسيما في لبنان. فبسبب فرار السلطان العثماني الذي كاد أن يخنق العمل المسرحي، والذي أدى إلى هجرة فرقة أبي خليل القباني إلى مصر عام 1884، كانت الفرق المسرحية تتشكل في دمشق وتغادر، بعد عرض واحد أو اثنين، إلى مصر ابتغاء لحرية العمل، وكانت تطلق على نفسها تسمية «جوق» من أجل اجتذاب الجمهور إليها. فقد كانت تقدم الهزل والفصول الفكاهية إلى جانب غناء الطرب والرقص الشرقي. وكان معظمها من تلامذة مدرسة القباني، مثل فرقة اسكندر فرح التي انضم إليها الشيخ سلامة حجازي، والجوق الدمشقي برئاسة نقولا مصابني والجوق السوري الجديد برئاسة يوسف شكري وجوق حبيب الياس وجوق جورج دخول مما أدى إلى تطوير رقعة العمل المسرحي واتساعه في مصر. ولكن سرعان ما انقلبت الآية بين الحربين العالميتين، إذ زار المدن السورية ما يزيد على ثلاثين فرقة مسرحية واستعراضية غنائية قدمت عروضها في مسرح القوتلي وزهرة دمشق وقصر البللور والإصلاح خانة والعباسية والروضة والفرح والهبرا واللونا بارك والأزبكية وغيرها، إلى جانب دور العرض السينمائي، المسرح السوري حتى الثورة السورية الكبرىأسير تقاليد المدرسة الشامية، من حيث هيمنة الجانب الموسيقي الغنائي على الجانب الدرامي الضعيف، على صعيد البنية، ولاسيما في مدينة حمص.
إن البداية الثانية للمسرح السوري بعد القباني ترتبط باسم عبد الوهاب أبو السعود الذي أسس فرقته في دمشق عام 1912 وكان ممثلاً ومخرجاً وكاتباً في الوقت نفسه. وإلى جانبه برز اسم معروف الأرناؤوط كاتباً ومقتبساً ومترجماً، ومسرحيته الشهيرة «جمال باشا السفاح» 1919 هي التي رفعت أبا السعود إلى مصاف الشهرة، بالدوي الذي أحدثته حين عرضها في دمشق. وهو كغيره من مترجمي المسرح آنذاك، كان يتصرف بالنصوص وفق ذوقه وطبيعة الجمهور. وعلى صعيد التأليف كانت النصوص في تلك المرحلة تستقي موضوعاتها من التراث العربي والإسلامي، ومن الأدب الشعبي، تماماً كما كانت الحال في لبنان ومصر. وبين الحربين العالميتين، عادت الفرق المسرحية للظهور بكثرة، أنديةً فنيةً وجمعياتٍ خيرية وفي المدارس، في دمشق وحمص وحلب واللاذقية والقامشلي ونشطت معها حركة التأليف المسرحي الذي اتخذ طابعاً سياسياً وطنياً ضد الأتراك ثم ضد الفرنسيين فبرزت أسماء أمين الكيلاني الحموي ومحمد خالد السلبي الحمصي وعمر أبو ريشة وسعيد تقي الدين وداوود قسطنطين الخوري وعبد الرحمن أبو قوس ورضا صافي ووصفي المالح ومراد السباعي وبهيج غاتا وفؤاد سليم وعبد الرحيم الغزاوي كان المخرج آنذاك يضطلع بالمهام المرتبطة بتحقيق العرض كافة، من تدريب الممثلين حتى توجيه الدعوات. وعلى الرغم توافر عد كبير من الممثلين، بقيت مشكلة العنصر النسائي قائمة حتى أواخر الخمسينات، إلاّ فيما ندر، ولهذا كان الشباب اليافعون يؤدون الأدوار النسائية من دون أي حرج، إذ كان هذا الوضع رائجاً ومقبولاً اجتماعياً في وسط جمهور المسرح. وغالباً ما كان المؤلفون هم المخرجون ومديرو الفرق في آن معاً.
توقف النشاط المسرحي في أثناء الثورة السورية الكبرى، وعاد عقب انتهائها 1928، مع جيل جديد من الشباب يحمل عن المسرح مفاهيم وغايات جديدة، فاختلف عمله وتوجهه عن المسرح السابق. واتسم بالواقعية في الأداء والإلقاء والديكور في أكثر المدن السورية، ولاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً، مما أدى إلى انتشار التمثيل في المدارس الأهلية والرسمية والأجنبية. كما توسعت الجمعيات النسائية في نشاطها الفني فشملت التمثيل المسرحي، كما كانت اللغة العربية الفصحى معتمدةً في جميع عروض المسرح الجاد. إلاّ أن السمة التي طغت على التوجه الجديد هي ابتعاده عن المواجهة السياسية، إلاّ في حلب. وهذا يعني أن التوجه الاجتماعي الناقد طغى على حركة التأليف والترجمة، إلى جانب المسرحيات التاريخية والشعبية. وفي هذه المرحلة أيضاً ظهر المسرح التجاري نقيضاً ساخراً للمسرح الجاد، وشاع تحديداً قي العاصمة رافداً للتسلية الرخيصة، وكثرت فرقه وتنوعت حتى طغت على المسرح الجاد. ومع ذلك فقد استطاع مسرح عبد اللطيف فتحي ومسرح محمود جبر استغلال المسرح التجاري بتقديمه من وراء الكوميديا أعمالاً هادفة مثل مسرحية «صابر أفندي» لـحكمت محسن ومسرحية «مدير بالوكالة» لمحمود جبر.
بقي المسرح السوري على هذه الحال حتى تأسيس «ندوة الفكر والفن» 1959 بإشراف د. رفيق الصبان العائد حديثاً من فرنسا، وقد ضمت أهم وجوه الفن والثقافة في دمشق وقتذاك. وفي عام 1960 تأسست فرقة المسرح القومي التابعة لوزارة الثقافة، وضمت معظم العاملين في الفرق الخاصة والأندية والجمعيات، ومنهم أهم نجوم الكوميديا مثل عبد اللطيف فتحي وسعد الدين بقدونس ثم اندمجت «ندوة الفكر والفن» عام 1963 مع فرقة المسرح القومي الرسمية، فتشكلت بذلك نواة النهوض المسرحي الجديد الموجه ثقافيا ً والمموّل رسمياً. وفي أثناء الستينات والسبعينات اغتنى المسرح القومي بعد مهم من المخرجين والممثلين والممثلات كذلك، إضافة إلى الفنيين، وقدم في مواسمه عدداً كبيراً من النصوص العالمية والعربية والسورية، بالفصحى، التي دامت لغة المسرح القومي الوحيدة حتى أواخر الثمانينات.
في البداية، اعتمد المسرح القومي على المخرجين رفيق الصبان ونهاد قلعي وهاني صنوبر ثم قدم إليه علي عقلة عرسان وأسعد فضة وخضر الشعار ومحمد الطيب الذين درسوا المسرح في القاهرة. وتلاهم العائدون من شرقي أوربا وغربيها مثل: حسين إدلبي ويوسف حرب وفردوس أتاسي وحسن عويتي وتوفيق المؤذن وفواز الساجر وشريف شاكر وغيرهم كما انضم إلى العمل الإخراجي كل من سليم صبري وسليم قطاية وفيصل الياسري وشريف خزندار وبهذا كان المسرح القومي البوتقة التي انصهرت فيها خبرات وتيارات المسرح العالمي من الشرق والغرب، إلى جانب التجربة المحلية والعربية، على مستوى الإخراج والتمثيل والتأليف والسينوغرافيا. وبعد سبع سنوات، تأسس مسرح حلب القومي الذي ضم خيرة ممثلي وممثلات حلب مع قلة من المخرجين المتفرغين، مثل: بشار القاضي وحسين إدلبي وكريكور كلش وفواز الساجر الذي أسس بعدئذ في دمشق مع سعد الله ونوس «المسرح التجريبي» عام 1976، أي في العام نفسه الذي استقبل فيه المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق أول دفعة من طلبته في قسم التمثيل، وهو العام نفسه الذي تأسست فيه مجلة «الحياة المسرحية» في وزارة الثقافة بإشراف الكاتب ونوس والناقد نبيل الحفار.
كان لهزيمة حزيران 1967 أكبر الأثر في توجه المسرح السوري وتطوره. فالأسئلة المقلقة التي طرحتها الهزيمة على الصعد كافة، كان لابد للمثقفين من إيجاد أجوبة لها. ولما كان المسرح المكان الأنسب لطرح الأسئلة وتلقي ردود الأفعال من خلال اللقاء المباشر بين الخشبة والصالة، فقد تحول في مدة قصيرة إلى بؤرة للعمل السياسي الثقافي، رفده شعراء وقصاصون، فبرزت آنذاك مسرحيات سعد الله ونوس ومحمد الماغوط وعلي عقلة عرسان وفرحان بلبل ووليد إخلاصي ومصطفى الحلاج ورياض عصمت وممدوح عدوان وغيرهم، إلى جانب المسرحيات العربية الصادرة عن الأجواء والقضايا نفسها. قد تجلى هذا التفاعل منذ الدورة الأولى «لمهرجان دمشق المسرحي» 1969، سواء على مستوى العروض ومناقشاتها الحارة مع الجمهور الذي تبدى من وراء مسرح الشوك لـعمر حجو ودريد لحام ونهاد قلعي أو على مستوى الندوات الفكرية المرافقة، لاسيما منها ما طرح قضية «المسرح السياسي ومسرح التسييس» و«هوية المسرح العربي» و«العلاقة مع الجمهور». وظهرت منذ مطلع سبعينات القرن العشرين حركة المسرح العمالي والجامعي والشبيبي التي تشكلت من الهواة المندفعين إلى العمل المسرحي للتعبير عن مواقفهم الفنية والفكرية التي جاءت في أحيان كثيرة أشد جرأة ومصداقية من عروض المسرح القومي، ولاسيما أن كثيراً من المخرجين المحترفين قد تعاونوا مع هؤلاء الهواة ووجهَوهم.
وكان منذ سبعينات القرن العشرين بحث دائب عن سبل تعبير فنية وفكرية تتلاءم مع القضايا الجديدة المؤرقة. ومن هنا جاء استلهام وتجريب كل ما عرفه الكتّاب والمخرجون على الساحة المسرحية شرقاً وغرباً، بدءاً بما يرخولد وبرشت، وانتهاء بغروتوفسكي ومنوشكي، إلى جانب محاولات استلهام الظواهر المسرحية في التراث العربي، مما أدى إلى تخبط وعشوائية في العمل المسرحي أبعده عن أهدافه الاجتماعية الحقيقية، أي بناء وعي جديد لدى المتلقي بشرطه التاريخي، لكي يتمكن من استيعاب ظروف واقعه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتجاوزها عبر العمل على تغييرها بما ينسجم مع المستقبل المنشود.
وفي هذه المرحلة عاد المسرح التجاري المحترف إلى نشاطه السابق، واستقطب فئات معينة من الجمهور المحلي والطارئ بزعمه معالجة قضايا اجتماعية وسياسية بحدة لا يجرؤ عليها المسرح الرسمي مثل مسرح «دبابيس» للأخوة قنوع، إلا أن دبابيسه النقدية لم تكن في واقع الأمر أكثر من وخزات تنفيسية. أما الوجه الآخر للمسرح الخاص فقد تجلى في تجربة «فرقة تشرين» التي جمعت الشاعر والمسرحي محمد الماغوط مع النجم الكوميدي دريد لحام والتي امتدت من منتصف السبعينات حتى مطلع التسعينات من القرن العشرين.
ونتيجة للتحولات السياسية الاجتماعية والضائقة الاقتصادية التي حلت بالمنطقة، منذ منتصف الثمانينات، ومع صعود الدراما التلفزيونية السورية، تراجع دور المسرح وانكمش جمهوره، وتحول عدد كبير من الممثلين والمخرجين والكتاب عن المسرح إلى التلفزيون الذي جلب الرخاء المادي السريع والشهرة الواسعة، على المستوى العربي. غير أن المسرح القومي والمعهد العالي للفنون المسرحية، التابعان لوزارة الثقافة، استطاعا، بما قدماه من عروض مسرحية عالمية وعربية ومحلية على مسارح دار الأسد للثقافة والفنون وقصر المؤتمرات ومسرح الحمراء، إعادة الحياة المسرحية التي كبت بعض الشيء في ثمانينات القرن العشرين إلى سابق عهدها وبعض تألقها الذي عرفته في ستينات وسبعينات القرن العشرين منذ أواخر القرن المذكور. وكذلك قامت دار النشر ومجلة الحياة المسرحية التابعتان لوزارة الثقافة بدور مماثل في تنشيط حركة التأليف المسرحي وتنشيط الحركة المسرحية الدؤوبة ثقافياً وفكرياً.
===
المصدر: الموسوعة العربية، نبيل الحفار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسرح سوري
من ويكيبيديا،
‘تاريخ المسرح السوري’
تاريخ انطلاق المسرح السوري في عام 1871 على يد رائد المسرح السوري والعربي أحمد أبوخليل القباني حيث يعتبر القبانى أول مؤسس لمسرح عربي وقد اسسة في دمشق، أبدع القباني في بداياته وقدم عروض مسرحية وغنائية كثيرة منها ناكر الجميل – انس الجليس – هارون الرشيد – عايده – الشاه محمود – وغيرها، وكان له الفضل في قيام حركة مسرحية في سوريا وفي الوطن العربي بعد ذلك.
البداية
كانت البداية للمسرح السوري مبكره وقد وأنطلق وازدهر المسرح في سورية في القرن التاسع عشر على يد أبوخليل القبانى في مدينة دمشق وواجه القباني من اجل نشر فنه العديد من الصعاب والعقبات إلى ان نجح في استقطاب الجماهير في مدينة دمشق لمتابعة عروضه ومسرحياته ولاقى نجاحا كبيرا بالعروض التي قدمها في بداياته بدمشق وكانت الناس تتهافت لحضور مسرحياته وعروضه الغنائية، وكان القبانى في البداية متابعآ ومعجبآ للعروض التي كانت تقدم في مقاهي دمشق مثل قصص الحكواتى ورقص السماح والعروض التي كانت منتشرة في مقاهي مدينة دمشق وكان أبوخليل القباني يحضر ويتابع اجتماعات وعروض موسيقا ابن السفرجلاني بدمشق وتعلم منها واختلط القبانى بالفرق المسرحية التي تمثل في مدرسة العازرية بمنطقة باب توما ، ومن كل هذا كون احمد أبو خليل القباني أسس هذا الفن الراقي لينطلق به من دمشق ويطوره واضعآ آسس المسرح الغنائي العربي.
أول عرض مسرحي
قدم أبو خليل القياني أول عرض مسرحى خاص به عام 1871 وهي مسرحية الشيخ وضاح ومصباح وقوت الارواح وهي أول مسرحية سورية وعربية وفق مفاهيم المسرح ،وقدم بعد ذلك مسرحيات وتمثيليات ناجحه اعجب بها الجمهور الشامى بدمشق وفي عام 1879-1880 الف فرقته المسرحية وقدم في السنوات الأولى حوالي 40عملا مسرحيا ووضع الاسس الأولى للمسرح العربي وخاصة المسرح الغنائي وسافر أبوخليل القباني إلى مصر حاملا معه عصر الازدهار وبداية المسرح العربي وكان مع أبوخليل القبانى مجموعه من الفنانين والفنانات السوريين حوالي 50 فنان وفنانةنذكر منهم جورج ميرزا وتوفيق شمس وموسى أبوالهيبة وراغب سمسمية خليل مرشاق ومحمد توفيق وريم سماط واسكندر فرح وغيرهم وسافر أبوخليل القبانى إلى مدن سورية ومصر وأمريكا وعاد إلى دمشق متابعا عروضه المسرحية إلى ان توفي عام 1903 ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق.
وقبل أبوخليل القباني عرفت سوريا عروضا للمسرح لكن ليس بالشكل المعروف للمسرح الذي ظهر على يد أبوخليل وكان ذلك في منتصف القرن التاسع عشر مثل عروض كركوز وعواظ وخيال الظل ورقص السماح والمولوية والحكواتي وكانت جميها تقدم في نوادى ومقاهى دمشق وبعض الأماكن العامة.
ومن أهم رواد المسرح السورى كذلك اسكندر فرح عمل اسكندر فرح مع أبوخليل القباني وكون بعد ذلك فرقته المسرحية الخاصة وكان المعلم الأول للكثير من رواد المسرح في سوريا ومصر ولد اسكندر فرح بدمشق عام 1851 وتوفى عام 1916 وقدم مسرحيات هامة في تاريخ المسرح العربي : شهداء الغرام – صلاح الدين – مملكة اورشليم – مطامع النساء – حسن العواقب – اليتيمين – الولدان الشريدان – الطواف حول العالم وغيرها الكثير.
بداية ظهور الفرق المسرحية
بعد فرقة (أبوخليل القباني) والرواد الأوائل للمسرح السوري، ظهرت في بداية القرن العشرين فرق مسرحية سورية كثيرة أخذت بالتزايد مثل فرقة نادي الإتحاد وفرقة جورج دخول وكانت تقدم عروضها على مسرح القوتلى في السنجقدار فرقة عبد اللطيف فتحى وكانت تظم عددا كبيرا من الفنانين ونذكر كذلك الفنان جميل الاوزغلي وفرقة أنور مرابط وفرقة ناديا المسرحية لصاحبتها ناديا العريس حيث كانت الفرقة من أكبر الفرق المسرحية العربية في الثلاثينات من القرن العشرين ضمت الفرقة أكثر من 120 فنان وفنانة وكانت تقدم عروضها على مسرح الكاريون بدمشق أحد مسارح دمشق.
قدمت الفرق المسرحية السورية الكثير من المسرحيات العالمية وعروض مسرحية كوميدية واستعراضية وغنائية وسياسية واجتماعية ودرامية وتاريخية كثيرة لمؤلفين سوريين وعرب ومسرحيات مترجمة لروايات عالمية.
بعض الفرق المسرحية السورية منذ بداية القرن العشرين
فرقة نادي الاتحاد 1906
فرقة الصنائع (حلب 1928)
فرقة ايزيس 1931 (جودت الركابي- سعيد الجزائري – علي حيدر كنج – نصوح دوجى – أنور المرابط – ممتاز الركابي)
فرقة ناديا المسرحية (ناديا العريس)
الفرقة السورية (الثلاثينات)
الفرقة الاستعراضية (الثلاثينات)
فرقة الكواكب (الاربعينات) محمد علي عبده
فرقة عبد اللطيف فتحي
فرقة اتحاد الفنانين
فرقة العهد الجديد
نادى الفنون (توفيق العطري)
فرقة حسن حمدان (الثلاثينات)
فرقة سعد الدين بقدونس (الخمسينات)
فرقة فنون الاداب
فرقة نهضة الشرق
فرقة المسرح الحر (رفيق جبري – توفيق العطري – نزار فؤاد)
ندوة الفكر والفن (الستينات) رفيق الصبان
النادى الفني (منذر النفوري)
فرقة المسرح الكوميدي
فرقة المسرح الشعبي
فرقة الفنانين المتحدين (محمد الطيب)
فرقة الأخوين قنوع (فرقة دبابيس)
فرقة زياد مولوي
فرقة هدى شعراوي
فرقة مظهر الحكيم
فرقة محمود جبر
فرقة مسرح اقهوة (طلحت حمدي)
فرقة مسرح الشوك (عمر حجو – دريد لحام -أحمد قبلاوي)
فرقة ناجي جبر
فرقة رفيق السبيعي
فرقة تشرين
فرقة ياسين بقوش
فرقة المسرح القومي
مختصر عن تاريخ المسرح في سوريا.
















 هذه المرة الثانية التي يقوم فيها سانجاي ليلا بهانسالي بالتلحين لفيلم، الأول كان فيلم Guzaarish عام 2010.[13][15] القصائد الغنائية كتبت من قبل سيدهارث – جاريما.[15] صدر الألبوم الموسيقى في 2 أكتوبر 2013 بعد التأخير بسبب المشاكل الصحية لرانفير سينغ. قائمة الأغاني # عنوان المغنين المدة 1. “Ram Chahe Leela” بومي تريفيدي 4:04 2. “Lahu Munh Lag Gaya” شايل هادا 5:00 3. “Ang Laga De” أديتي باول، شايل هادا 5:27 4. “Poore Chand” شايل هادا 4:08 5. “Nagada Sang Dhol” شريا غوشال، عثمان مير 4:33 6. “Laal Ishq” أريجيت سينغ 6:27 7. “Ishqyaun Dhishqyaun” أديتيا نارايان 4:51 8. “Mor Bani Thanghat Kare” عثمان مير، أديتي باول
هذه المرة الثانية التي يقوم فيها سانجاي ليلا بهانسالي بالتلحين لفيلم، الأول كان فيلم Guzaarish عام 2010.[13][15] القصائد الغنائية كتبت من قبل سيدهارث – جاريما.[15] صدر الألبوم الموسيقى في 2 أكتوبر 2013 بعد التأخير بسبب المشاكل الصحية لرانفير سينغ. قائمة الأغاني # عنوان المغنين المدة 1. “Ram Chahe Leela” بومي تريفيدي 4:04 2. “Lahu Munh Lag Gaya” شايل هادا 5:00 3. “Ang Laga De” أديتي باول، شايل هادا 5:27 4. “Poore Chand” شايل هادا 4:08 5. “Nagada Sang Dhol” شريا غوشال، عثمان مير 4:33 6. “Laal Ishq” أريجيت سينغ 6:27 7. “Ishqyaun Dhishqyaun” أديتيا نارايان 4:51 8. “Mor Bani Thanghat Kare” عثمان مير، أديتي باول














.jpg)


.jpg)