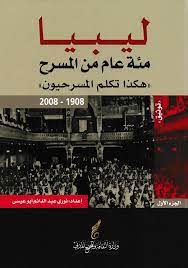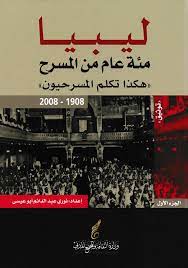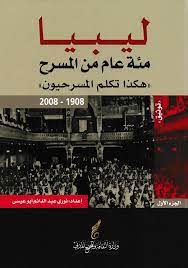



ليبيا مائة عام من المسرح”1908م- 2008م”أوهكذا تكلم المسرحيون -2-63 – نوري عبدالدائم
**************************************
إرث منصور ابوشناف
بقلم / أحمد ابراهيم حسن
نص مسرحية ” الإرث ” فاخر بمحتواه لا بالشكل الذي ظهر به كمطبوعة ملحقة بمجلتنا المتعثرة ” المسرح والخيالة ”
إذ ضم العدد العشرون وفي الوسط تماما المطبوعة بالحجم الصغير وبغلاف من الورق العادي وضع عليه صورة للوحة ”
ديلاكروا ” الشهيرة ” الحرية تقود الشعب ” وعدد صفحات المطبوعة (31) صفحة دون أي تقديم سوى تلك العبارة التي
اختارها الكاتب منصور أبوشناف من الالياذة – هوميروس :
( وقبل أن تتم فينوس سحرها كان الفتى البائس قد ألقى التفاحة في يديها الجميلتين بالرغم من الصيحات التي
كانت تأتي من البحر : لا يا باريس – لا يا باريس – أعطها لمينرفا ..) وجر على نفسه غضب هيراو منيرفا .. وكتب
التعاسة عليه وعلى قومه )
ومن هذا الاختباء وراء هذا التصدير وراء تلك اللوحة .. ووسط مجلة المسرح والخيالة كأنه الاندساس ، فمن هذا
الاندساس أو الاختباء يبتدئ النص .. ولكن لنتعرف بإيجاز عن صاحب هذا المنجز ، : هو منصور أبوشناف من مواليد
بني وليد 1954 ف ، كانت بدايته بالمسرح المدرسي مضراته عام 1965 ف ، يكتب للمسرح والمرئية والنقد الفني كتب
بوشناف عشرين نصا مسرحياً أهمها :- توقف – جالو – حكايات ليبية – كاسكا – كلام نساوين – السعداء – الإرث – عروس
بالمواصفات – الحجالات – خماسية الانسان والشيطان .. الخ ، بدأ الكاتب نشر مقالاته في الصحف والدوريات المحلية
، عام 1973 ، تحصل على برونزية مهرجان الجزيرة للأشرطة الوثائقية ، والفضية بمهرجان القاهرة للإذاعة
والتلفزيون .
ملخص المسرحية
يخرج خالد من سجنه بعدما قضى فيه عشر سنوات ليجد زوجته وقد بنت له بيتا كبيرا ، اغتصب جده – أيام الاتراك –
أرض جد خالد ، كما يجد زوجته التي لم يدخل عليها قد فقدت بكارتها فيناديه صوت جده الذي يسكنه ، يناديه
للاقتصاص وغسل العار بالدم .. واخراج كل المدسوس والمتخفي في صندوقه الذي ورثه عنه ، يحثه على الثأر من قتلته
.. وبعد صراع نفسي حاد يقتل خالد زوجته زينب التي خانته مع شاب كان يتردد عليها في غيابه وكذلك يقتل ابن
عمها ( محمود ) ويضع صندوق جده العتيق الذي يحوي كل أوراق ملكية الأرض ، والأرض والقتال وكل أرثه من الخيانات
والمؤامرات – فوق جثة زينب ثم يحرق البيت بكل محتوياته وهو يجلس ساهما إلى جانب حبيبته محترقا هو أيضا بنار
ثأره .
عرض للنص
خرج منصور بوشناف من المحك بتجربة غنية … خرج شرها لعوالمه الأدبية والفنية .. وقد انعكست هذه التجربة على
نصه هذا .. إذ نجده يصب من ذاته مهربا نفسه على لسان ( خالد ) بطل المسرحية ، عن موقفه من السجن ، الفن ،
الحياة ، المؤامرة ، الخيانة ، الصحراء ، الأرث .، فهذه الالتقاطة إذاً والتي بنى عليها نصه تهيأت وتجمعت خلال
أو بعد فترة السجن ، وأن الحبكة المسرحية ، وعمق الدلالات وتعددها في النص ( الصحراء ، العاصفة ، الشجرة ،
الصندوق .. الخ ..) ، تؤكد اختمار الفكرة في ذهن مبدعنا ، هذا الاختماد أدى إلى صور شعرية بالمعنى المعبر عنه
في جماليات مسرح العبث أو اللامعقول .
مكثفة ومبتكرة وأصيلة … وانبثاقها عن هذا الشكل الرصين المتماسك .. هذا التنفيذ والتحقيق الذي يشير إلى
تمكن الكاتب وقدرته على صياغة عمله وإمساكه بتلابيب موضوعة ويغوص هذا النص إلى عمق المشاعر الانسانية ، بيسر
وببساطة ويسجل لحظات إنسانية غاية في الشفافية وغاية في الرعب والقسوة .. وتذكرك النهاية التراجيدية الفاجعة
بالنهايات الشكسبيرية في مآسية العظيمة ( ماكبت ، هاملث ، لير ، عطيل ) فشخصية خالد بطل المسرحية تقع في
تردد هاملت بين الفعل واللافعل ، القدرة وعدم القدرة ، وتظهر ملامح هاملت مرة أخرى واضحة في شخصية الرسام
الشاب المصاب ( بعقدة أو ديب ) والتي يؤكد الكثير من الدارسين والمحللين لإبداع وليام شكسبير على ان هاملت
كان شخصية مترددة تعاني من عقدة أو ديب وهي مفتاح الولوج لتحليل هذه الشخصية التي أبدعها شكسبير … كما نجد
في مشهد الخنجر ( حالة تلك الرغبة الشكسبيرية في القتل وإلى محركات وعواقب هذا الفعل اللانساني بمأساته
العظيمة ( ماكبث ) فكما قتل ” ماكبث ” ابن عمه .. يقتل خالد ابن عم زوجته أيضا .
قسم الكاتب نصه إلى إربع لوحات متتالية .
اللوحة الأولى
تبدأ الأحداث بخروج خالد من السجن بعد ان قضى فيه عشر سنوات من القلق والانتظار .. لقد سيق إلى السجن قبل
العرس بأيام … زوجته زينب انتظرت كذلك عودة زوجها ليمنحها فخارا لأمومة ( بأي شئ أجمل من أن تكون المرأة
أما …؟ ) هما الآن يستعدان لبدء حياتهما جديد .. تشجعه على نسيان السجن الذي يصفه الزوج : بالجحيم وهوة
العدم .
ان زينب من فرحتها بعودة زوجها صارت ترقص على أنغام قصيدة ( أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باق ) .. يتساءل
الزوج كيف استطاعت أن تكمل انجاز البيت وشراء الاثاث رغم مقاطعة الأهل لها ، لأنها أصرت على السكن وحدها
ولاصرارها على تكوين بيتهما المستقبلي فتخبره أن ( محمود ) ابن عمها قد ساعدها في ذلك .. فيغضب ويستنكر ذلك
لأنه لا يحبه كثيراً لعجرفته وتكبره .. وتطلب منه أن لا يفسد عليها هذه اللحظات الجميلة بالحديث عن البناء
وعذاباته .. يشربان الشاى وهما يتأملان الصحراء التي يقول عنها الزوج : بانوراما بيتنا الجميل ، فأحيانا تكون
جميلة وهادئة وأحيانا تكون مزعجة وأن بينه وبينها حربا عمرها أكثر من ألف عام .. هي رغم زوابعها رتيبة ومملة
كيوم السجن ) ويتساءل كيف بإمكانه أن يحب وهذه الصحراء خلف ظهره .. فتقول له زينب ” إن الحب لا يعرف أمكنة
…إنه ينمو في كل مكان وتحت كل الظروف .. )
ويضع الكاتب إشارة للكوتشيرتو الأربعين لموزارت كخلفية لهذه الصورة الشاعرية ، ينظر لزوجته بولّه على نغمات (
موزارت ) ويتكلم بأسى عن شجرته الوحيدة تقترب منه زينب وتحادثه بأمل قائلة : ( لن تظل وحيدة . سنغرس مصدات
رياح لاحد لها .. لن تكون وحيدة .. هاقد عدت ، صار بإمكانك أن تأخذ ثأرك من الصحراء .. سنأخذه معا .. )
وتنتهي اللوحة بقصيدة .. أصبح الصبح ، من جديد .
اللوحة الثانية
نفس المكان .. الصحراء تبدو في الخلفية مضاءة بقوة إنه القيظ الشديد .. و ” خالد ” في أشد حالات توتره وغيرته
من ” محمود ” ابن عم زوجته محمود الذي استولى جده أيام الاتراك على أرض جد خالد . وحين يدخل محمود مهنئا
بالإفراج عن خالد .. لا يحسن استقباله فيضطر محمود للانسحاب محرجا ويزداد توتر خالد حين لا يعثر على صندوق أبيه
ورثه عن جده ..فتخبره زينب أن الصندوق عندها إذا استلمته من أمه بعد دخوله السجن ، وتوتفع وتيرة الخصام
بينهما .. فتخبره خائفة أنه يغار من محمود لأنه لا يثق بها ولا يثق بنفسه ، بتعود به مسترجعة ذكريات الدراسة
الجامعية وذكريات حبهما .. وتتهمه بأنه ألغى في داخلها مشروع .. مشروع السيدة الأنيقة الفنانة التي لاتطيق
رياح القبلي لقد أهدته فيما مضى لوحة ” ديلاكروا – الحرية المفقودة …
ونلاحظ هنا توظيف المبدع للموسيقى والتشكيل الانساني العالمي والافادة منه في خدمة نصه ، وذلك لأن النص يتقاطع
أو يتناص مع هذه الأعمال تأويليا .
لقد كان خالد مجنون بتلك اللوحة .. كان يعيش قصة حب مع تلك المرأة المتصدرة الجموع في اللوحة ، تلك التي
تتفجر قوة دون أن تغيب أنوثتها .. وحين يصبح وحيداً يخرج له طيف جده ، الذي يذكرنا بطيف الملك المقتول في ”
هاملت ” شكسبير ، أيضا إضافة لما سبق ذكره في مقدمة التحليل .. يصفه جده بأنه ملعون مطارد وأن لعناته ستظل
تلاحقه ، يصعق خالد لسماع وصف جده له بأن مرضا مشينا بطش بعقله .. مرضا لا يتوقف عن الاساءة له وللعائلة وأن
ليس بإمكانه أن يكون جداً لعقل فاسد أفسدته الكتب .
وحين يرد خالد بأنها ” المعرفة ” يقول الجد : أية معرفة تجعلك شحاذاً على أبواب ابن قاتلي ؟ أية معرفة تجعلك
تتزوج هذه الفاسدة المارقة نفاية ” محمود ” ويحثه على طلاقها وعلى فتح الصندوق واخراج كل الحجج والوثائق التي
تخص الأرض . إذ لابد من استرجاعها من مغتصبها .. يُذهل خالد لسماع ما قيل له عن زوجته .. فتعمى الغيرة عينية من
جديد .. ويظل يهذى بالأرث والنار والعار .. وأن مايرثه الانسان يكون كيانه .. فيتهم زوجته بالخيانة .. ويفكر
بصوت مسموع أنه آن له أن يفصل كل شئ وأن يصدر حكما بالاعدام على هذا الرأس .. هذا العقل المشين فمن يبذروهما
يجنى أوهاما ..
اللوحة الثالثة :
نفس المكان .. الصحراء متوهجة .. زينب مهمومة .. يخرج خالد الخنجر من صندوق جده العتيق .. وهو في حالة نفسية
يُوثى لها ينظر للخنجر وهو يهذى ( كما شكسبير في مونولوجة الشهير ” أهذا الخنجر .. ؟ ) . ، ما أسعدني بشقى
الرحى ؟ ويقصد زوجته التي يشك بها والتي لن تخلف له إلا العار إن صحت شكوكه وجده الذي يورثه الثأر .. ترتعب
.. ويظهر ذلك عليها فإن عروسا بلابكارة ” يبدو لها الخنجر مرعبا .. تطلب منه الهدوء للتفاهم ..( أتعرف معنى
أن تكون المرأة وحيدة انها تصبح كيانا مهدداً .. تصبح فريسة لأوهامها وأوهام الآخرين ) تعترف له بأن رساما
صغيراً كان يزورها .. وذات مرة بكى كطفل ، ” طلقها أبي منذ سنوات .. تركته .. وتبعتها كانت أما حقيقة .. كانت
تستحق كل شئ .. والآن تزوجت جرحتني ” .. ( وكأنما هذا الشاب الذي يصغرها بست سنوات يعاني من عقدة أوديب لشدة
ارتباطه بأمه ) … ويظل يبكي فتضمه إليها بحنان وهي تنعته بولدها الحبيب وتقبل جبينه ( تحتاج أما لاتتركك
وان طارت عصافيرها . تحتاج حبيبة .. ( تضمه بقوة ) .. واحتاجك هذه الليلة أكثر .. ) ويمثل مشهد زينب والشاب
الرسام عودة للماضي … تعود الاضاءة وخالد مازال على كرسيه مستشيطا ( خيانة .. أين شرعية عمل مشين كهذا) ..
فترد عليه : إنه شرعية الإرث المرعب ” إن طوفانه يغرق كل شئ . وتتساءل كيف يبرر قتل من خالف إرث القبيلة الذي
لايزيد عمره عن ألفي عام ولا يبرر عمل إرث عمره ملايين السنين ؟؟ لا يغسله إلا الدم .. إن البغى مهما تعطرت يظل
يفوح منها العفن ) ، تطلب منه زينب ألا يصفها بهكذا أوصاف .. وأن بإمكانهما الافتراق بسلام .. وأن هذا البيت
بنته له وأنها انتظرت عودته عشر سنوات .. ولكنه يستنكر صارخا أنه ليس بيته وإنما هو وكر للخطيءة وأنه ليس
بإمكانه أن يغفر لها خطيءتها .. تخرج زينب غاضبة .. ويبقى وصندوقه وحيداً .. هذا الصندوق الصغير الذي يتسع
لكل هذه المساحات من الأرض والقتال من الخيانات والمؤامرات .. يتساءل ويتساءل أنحرقه ونستريح .. ننسى .. نموت
. فالبنسيان نمارس عملية قتل مرعبة .. ويخاطب روح جده التي تسكنه أتخيلك الآن أيها الروح الجليل وأنت تطوى
هذا الثقل الهائل عبر سنوات طويلة .. وتسجنه هنا في هذا القمقم الصغير .. لينطلق في اللحظة التي تختار وتدمر
كياننا .. يناولنا خنجره ليسود به لواسطتنا .. لست إلا عينيك التي ترى بهما ، ولست إلا إذنك التي تسمع بها ..
ولست الايدك التي تبطش بها لم أعد إلا أنت أيها الروح العظيم .. فاهدأ أرجوك .. اهدأ قليلاً لأفكر في – الآن –
ولتكن المجزرة .. اظلام .. وتوتفع العاصفة منذ رة بالكارثة .
اللوحة الرابعة :
تختفي اللوحة بما تحويه .. بكل تلك المعارف والقيم والمبادئ كدليل على فقدانها وضياعها .. ويقفل الباب المطل
على الصحراء .. وصوت العاصفة يسمع قوياً وتتركز الاضاءة على الصندوق العتيق .. ، بينما خالد ومحمود وجها الوجة
وكأنما هي ساعة المواجهة والمحاكمة وقد أزفت . يشعر محمود أن الجو متوتر فيذكر خالد أنه إنما جاء بناء على
طلبه … ولكن خالد يدرك أن محمود تعود الحضور للبيت في غيابه .. وتعود ان يجلس هنا مع زينب ليؤنس وحشتها ..
ويشعر محمود بما يرمى إليه حديث خالد حيث يسأله انها لطيفة .. أليس كذلك ؟. فيشعر محمود بالحرج ويقول له :
انها فنانة حقيقية . فيقول خالد : أنا ايضا فنان ) .. فنان بالمعنى الذي يعنيه جدي الذي كان مارسه في السجن
.. ( وهنا تظهر ذاتية الكاتب ) .. في السجن مارست العهر الروحي .. كنت كى احافظ على بقائي وسط جوكرية امنح
روحي للجميع كانوا يصفونني بالمجامل .. ولكنني كنت عاهراً عندما أوافق على مالا أريد .
لا اجامل .. بل اتعهر .. لابد انك من أجل الصعود الوظيفي حولت روحك إلى فنان ترضى كل الأذواق ..، يصفه محمود
بأنه مرعب .. ويدافع خالد .. ( لست أنا المرعب .. ان الخيانة مرعبة داخلي حبسته سنوات طوال وكان يصرخ فيّ ..
انك عقل فاسد .. وكنت احاول حرقه عندما يقف أمامي ولكن الرهبة كانت تمنعني هل تعرف .. كيف يموت نبيل ؟ كيف
يموت فارس أذل وأهين يتزوير ومؤامرة خسيسة ؟ أقف أنا وأنت الآن .. وجها لوجه لابل جدي وجدك وجها لوجه ) ..
يحاول محمود الانصراف ولكن خالد يصر ان يريه صندوق جده بكل محتوياته .. يمسك بالخنجر .. يخرجه من غمده ..
قائلاً له : انه جميل أليس كذلك ؟ ! يحس محمود بالخوف فيبتعد قليلاً وهو يعترف انه رجل مسالم لا يحب السلاح . فيرد
خالد عليه بسخرية ( مثل جدك .. دبلوماسي محنك ) وما ان يخرج محمود حتى تدخل زينب .. تفتح الباب المطل على
الصحراء ، ومن الجلي انها اشارة للخلاص .. وتكون العاصفة قد هدأت ولكن تلك الشجرة الصغيرة التي كنا نراها في
عمق المشهد قد اختفت وتتساءل عنها زينب فيقول لها خالد ، ( لقد اقتلعتها العاصفة كنت اعرف انها لن تستطيع
المقاومة .. وهو يقصدها بهذه الكلمات العميقة .. لقد قرر خالد ان يحمل الصندوق ويمضي رغم الانواء .. تعترف له
زينب بحبها ، وتعلقها الشديد به وانها لا تستطيع الحياة بدونه … ولكنه لا يستطيع ان يصدق براءة هذا الوجه ..
كما انه لا يستطيع ان يغفر لها ( هم لا يغفرون .. إرث كامل لا يغفر .. ) فتقول له ، إن المسألة تخصهما ولا
يعرفها أحد ، فيقول لها ، ( هم نحن .. انهم يسرون فينا .. يسرى فينا .. كل سنوات وخبايا هذا الصندوق فينا ..
ولن نستطيع ان نطردها منا .. لو انه يترفق بنا .. بي .. لو يهجع لو يتركني افكر قليلاً .. لو أني استطيع ان
ارحل أو أن انسى .. أو أن استيقظ من هذا الكابوس .. ( ينظر لمكان الشجرة في الخارج ) .. لو انها قاومت قليلاً
.. لو لم تقتلعها العاصفة .. لو أن العاصفة تأخرت قليلاً .. تفهم زينب مغزي كلمات خالد فترد وكأنما تخاطب
نفسها ، ( لو اني قاومت .. ولكنها غابة هذا الملعون جسدي .. عدوى الأول .. وتطلب منه ان يذبحها .. ان ينقذها
من جسدها .. من لعنتها . يقبلها .. ويضع حد خنجره على رقبتها بينما هي تناجيه وتعبر عن حبها له .. عن دفئة ،
ثم تنتقض دبيحة يدخل محمود من جديد .. وكأنما جاء لحتفه .. ينهض خالد والخنجر يقطر دما ومازال بيده .. يبرر
محمود عودته بأنه احس ان عليه ان يأتي .. يخبره خالد انه كان بانتظاره وببساطة تامة يغرس الخنجر في قلبه ..
ساعتك حانت ايها المخلوق الثقيل .. يسقط محمود على الأرض ورغم آلام الموت .. تبدو عليه علامات الذهول خالد يحمل
صندوقه يضعه فوق جثة زينب ثم يخرج ليحضر برميل بنزين يرشه على الجثتين وبأركان البيت حيث يطلق النار ويجلس
قرب جثة زينب ساهما محترقا بنار إرثه .