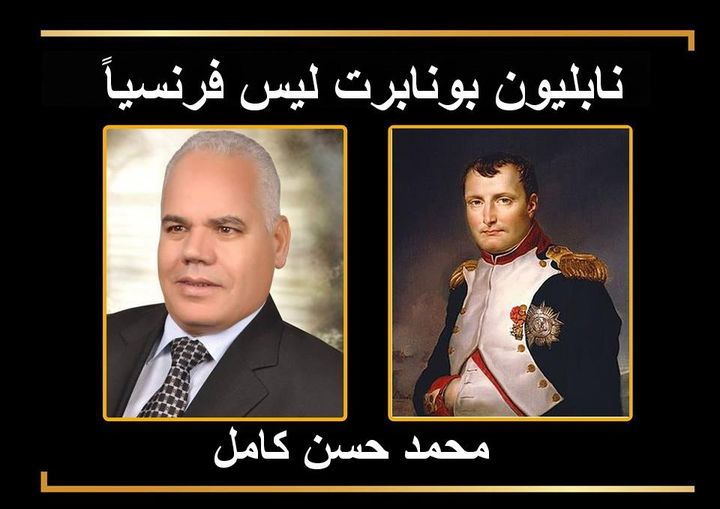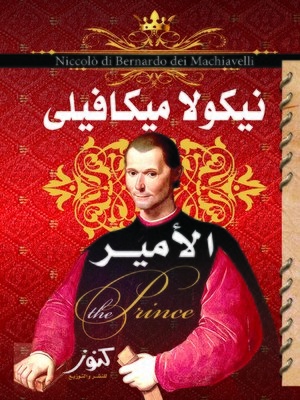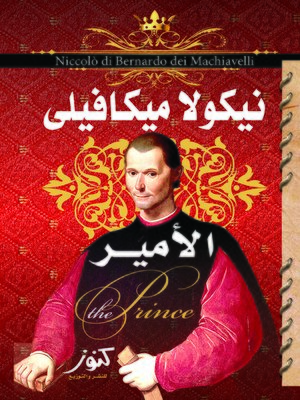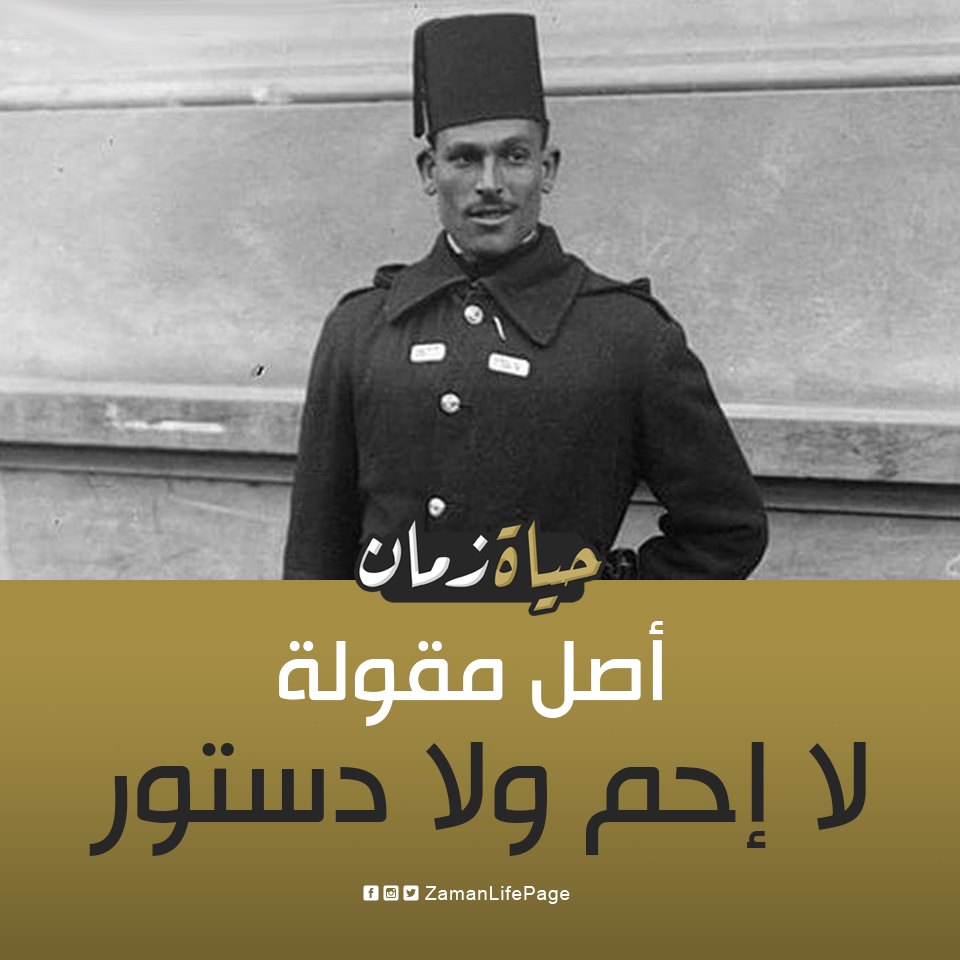د.عائشة الخضر لونا عامر مع المفكر محمد حسن كامل
أيقونة شارة
المفكر محمد حسن كامل
نابليون بونابرت ليس فرنسياً…..!!
صدق أو لا تصدق
هي الحقيقة التي لا مراء فيها
امبراطور فرنسا ليس فرنسياً
عنوان مستفز
إليكم الأنباء بالتفصيل من أمام قبر نابليون بساحة الأنفاليد بباريس.
وقفت أمام قبر هذا الرجل الذي صال وجال
والان لا حيلة له ولا حال
من هو الرجل الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه
وُلد نابليون في جزيرة كورسيكا في 15 أغسطس سنة 1769 لأبوين ينتميان لطبقة أرستقراطية تعود بجذورها إلى إحدى عائلات إيطاليا القديمة النبيلة. ألحقه والده “كارلو بونابرت”، المعروف عند الفرنسيين باسم “شارل بونابرت” بمدرسة بريان العسكرية. ثم التحق بعد ذلك بمدرسة سان سير العسكرية الشهيرة، وفي المدرستين أظهر تفوقًا باهرًا على رفاقه، ليس فقط في العلوم العسكرية وإنما أيضًا في الآداب والتاريخ والجغرافيا. وخلال دراسته اطلع على روائع كتّاب القرن الثامن عشر في فرنسا وجلّهم، حيث كانوا من أصحاب ودعاة المبادئ الحرة في عصر التنوير الأوروبي , فقد عرف عن كثب مؤلفات فولتير ومونتسكيو وروسو، الذي كان أكثرهم أثرًا في تفكير الضابط الشاب.
وتدور رحى الأيام التي سجلت الصراع بين إنجلترا وفرنسا وكانت بلاد الشرق مسرحاً لتلك الصراعات , وبالطبع فازت مصر بنصيب الأسد من هذا الصراع .
سمحت جذور أسرة بونابرت النبيلة، إضافةً إلى يسار أفرادها ومعرفتهم الشخصية بذوي المناصب السياسية العليا، سمحت لنابليون أن يخوض غمار ميدان العلم والثقافة بشكل لم يكن متاحًا لأي شخص كورسيكي عادي في ذلك الزمن.ففي شهر يناير من عام 1779، أُلحق نابليون بمدرسة للاهوت واقعة في مدينة “أوتون” حيث تعلّم اللغة الفرنسية، وفي شهر مايو من نفس السنة، ألحقه والده بمدرسة بريان العسكرية لإعداد البحّارة.تكلّم نابليون الفرنسية بلهجة كورسية واضحة، واستمر يلفظ الكلمات الفرنسية بهذه الطريقة طيلة حياته، ولم ينطق باللفظ الفرنسي الصحيح على الإطلاق.تعرّض نابليون للمضايقة والاستهزاء من قبل زملائه الفرنسيين في المدرسة، بسبب لهجته التي رأوها غريبة، ولهذا السبب تفادى الاختلاط معهم وإنشاء صداقات متينة، وكرّس كامل وقته للدراسة. قال أحد أساتذة المدرسة في نابليون أنه «دائمًا ما كان متفوقًا على زملائه في الرياضيات، وملمّ بالتاريخ والجغرافيا، إن هذا الفتى لسوف يصبح بحارًا ممتازًا».
الحملة على مصر :
انتُخب نابليون في شهر مايو من سنة 1798 عضوًا في الأكاديمية الفرنسية للعلوم، وانضم إلى حملته المصرية ما مجموعه 167 عالمًا من علماء الرياضيات، البيئة، الكيمياء، والجيولوجيا , وقد حقق هؤلاء عدد من الاكتشافات في مصر لعل أبرزها هو اكتشاف حجر الرشيد، ونُشرت اكتشافاتهم في كتاب حمل عنوان “وصف مصر” (بالفرنسية: Description de l Égypte) وذلك في سنة 1809.
الذي أحتفظ بنسخة أصلية منه في مكتبتي حتى الأن .
وفي طريقه إلى مصر، عرج نابليون على جزيرة مالطا وأستولى عليها بتاريخ 9 يونيو سنة 1798، وكانت هذه الجزيرة خاضعة لفرسان القديس يوحنا ذوي الأصول الفرنسية والبالغ عددهم 200 فارس، منذ عهد الحروب الصليبية .
إستطاع بونابرت ورجاله الإفلات من سفن البحرية الملكية البريطانية التي تعقبتهم منذ مغادرة فرنسا، ونزلوا أرض مصر في مدينة الإسكندرية في 1 يوليو من عام 1798.
هل نابليون اعتنق الإسلام ؟
وجّه نابليون نداءً إلى الشعب المصري، وأصدرت الحملة نداءً إلى الشعب بالإستكانه والتعاون زاعماً أنه قد اعتنق الإسلام وأصبح صديقًا وحاميًا للإسلام. إستولى نابليون على أغنى إقليم في الدولة العثمانية، وطبقًا للدعاية الحربية أدعى أنه “صديقٌ للسلطان العثماني” وادعى أيضًا أنه قدم إلى مصر ” للاقتصاص من المماليك ” لا غير، باعتبارهم أعداء السلطان، وأعداء الشعب المصري. وهذه رسالة نابليون بونابرت الذي دعاه المؤرخين المسلمين ” اللواء علي نابليون بونابرت ”
لقد جاء نابليون إلى مصر بالمدفع والمطبعة فخرج المدفع وبقيت المطبعة , وبناء المجمع العلمي على غرار المجمع العلمي الفرنسي .
طبعت مطابع نابليون هذا المنشور باللغة العربية :
إلى شعب مصر:
“بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه…
أيها المشايخ والأئمة…
قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم أيضًا مسلمون مخلصون وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في روما الكبرى وخرّبوا فيها كرسي البابا الذي كان دائمًا يحّث النصارى على محاربة الإسلام، ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يزعمون أن الله يطلب منهم مقاتلة المسلمين، ومع ذلك فإن الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني..أدام الله ملكه…
أدام الله إجلال السلطان العثماني
أدام الله إجلال العسكر الفرنساوي
لعن الله المماليك
وأصلح حال الأمة المصرية.”
هكذا أدعى نابليون إنه اعتنق الإسلام لتحقيق أغراضه العسكرية .
فشلت الحملة الفرنسية على مصر عسكرياً لكنها أحدثت صدمة حضارية ذات وجهين
الوجه الأول للفرنسيين أنفسهم بصدمة حضارية من الحضارة المصرية القديمة والتي جعلت الفرنسيين يسجلون كل شئ عن مصر في كتاب وصف مصر .
صدمة حضارية جعلت العالم الفرنسي
(( شامبليون يعتكف على دراسة وفك رموز حجر رشيد ))
من اللغة الهيروغلفية إلى الفرنسية ودراسة تاريخ مصر الفرعوني .
أما الوجه الثاني للصدمة الحضارية كان للمصريين أنفسهم الذين وجدوا أنفسهم أمام حضارة أوروبية حديثة متطورة .
هنا حدثت الزيجة الثقافية بين مصر وفرنسا
التلقيح الثقافي بين حضارة فرعونية عريقة وفرنسية حديثة , هذا التلقيح الثقافي جعل محمد على باشا بعد توليه الحكم في مصر أن يوجه البعثات العلمية إلى فرنسا لنقل التحديث والحداثة , نقلت الإرساليات العلمية التحديث في كل شئ حديث ولكنها لم تنقل فلسفة الحداثة التي تجعلنا من المبتكرين للعلوم ومن المنتجين لها ,كان من أعلام الإرساليات المصرية الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي ترجم الدستور الفرنسي إلى العربية , وأمين بك الكرجي لتصنيع الاسلحة والسيخ احمد العطار للميكانيكا وغيرهم
و لولا أني أشفق عليك ايها القارئ العزيز ما توقفت سفينتي التي تمخر العباب في بحار الذاكرة لأقدم شهادة على عصر المدفع والمطبعة , أو تلك الزيجة الثقافية بين مصر وفرنسا على صوت الموسيقى أمام قبر نابليون بونابرت .
نعم لقد جاء نابليون بونابرت إلى مصر بالمدفع والمطبعة , فخرج المدفع وبقيت المطبعة .ما أروع تلك الرحلة بين شهيق الماضي وزفير الحاضر .
ومازلنا بين رئة الذكريات ماذا تحمل لنا من أحداث ؟
دكتور / محمد حسن كامل
رئيس اتحاد الكتاب والمثقفين العرب