
إدراك الموسيقى وآلاتها
سنتحدث هنا عن الإدراك الموسيقي
وتطور الآلة الموسيقية
وصناعة الآلة والوترية.
الإدراك الموسيقي.
هل تعرف ما يجري في الدماغ حين نتذكر نغم ما؟ بما أن الدماغ يفضل التعميم على التحديد، فهو يتذكر الأنغام ليس كنوتة محدده ،بل كأصوات تعلو صعودا ثم تنخفض.
يتمتع الإدراك الموسيقي بآلية معقده، سنحاول التعرف عليها.
للموسيقى قدرة على جعل الراشد يبكي كما تهلل للطفل كي ينام. وما زال الغموض يكتنف هذه القدرة على تحريك الفؤاد والأحاسيس.
فهي تعتمد على فعل الصوت، وكذلك على العمل الضمني لنظام الاستماع الذي يلتقط الأصوات، كما وعلى الدماغ الذي يحللها.
أصوات الموسيقى هي ذبذبات دائرية في الهواء. أما مستوى الصوت فيتحدد بعدد الذبذبات في الثانية، فكلما ازداد العدد كلما ارتفع مستوى الصوت.
كما أن تأرجح الذبذبات يحدد كثافة الصوت الموسيقي. فكلما عظم شأنها ارتفع الصوت وعلا.
وأخيرا لصوت الآلات الموسيقية لونها المميز والمحدد الذي يسمى النغم. والحقيقة أن صوت النغم الرئيسي عادة ما يترافق مع أصوات مشابهة أخرى يصفونها بالتناغم.
يعتمد صوت الآلات أو نغماتها على حجم هذا التناغم وكثافته وانسيابه مع الوقت. حين تعزف مجموعة آلات موسيقية معا، كما يحصل في الأوركسترا، تتلقى الآذان مجموعة من الذبذبات المختلفة التي يتمكن الدماغ من إدراكها، حتى انه قادر على تمييز كل آلة فيها، كما وإعادة صياغة النغم، ليجمع معا كل الأصوات المنبثقة عنها.
يتم ذلك بالتجاوب مع وزن النغم، على اعتبار أن ردة فعل طبلة الأذن تختلف حيال الذبذبات المتعددة التي تدركها. فهي تهتز ببطء حين تكون النغمات منخفضة، لتتسارع حين يرتفع مستواها.
يتم تحويل هذه الذبذبات، من خلال نظام السمع، إلى جهاز لولبي هو قوقعة الأذن.
تحدد الخلايا الواقعة عند اسفل القوقعة النغمات العالية، في حين تحدد تلك الواقعة في أعلاها النغمات المنخفضة. هذا ما يساعد الدماغ على تمييزها من بعضها البعض. فحين تعزف الأنغام مع بعضهما، أحدها مرتفع والآخر منخفض، يمكن للمستمع أن يدركها منفصلة.
يأخذ الدماغ على عاتقه مهمة تحديد المصادر، كما والتباعد الزمني بين إيقاع الأنغام الصادرة عن مختلف الآلات.
إلى جانب حقيقة أن لكل آلة موسيقية نوعية إيقاعها المميز، يمكن للعازف أن يفصل نفسه عن المجموع، بتأخير مشاركته في المعزوفة حسب رغبته، ما يساعده على إبراز المقطوعة الموسيقية، التي يعزفها.
ليتمكن دماغ المستمع من تمييز العازف المنفرد عن باقي الموسيقيين، يكفي للعازف أن يتأخر بنسبة واحد من ثلاثين ألفا من الثانية.
يمكن لإيقاع متوال للذبذبات، كالذي يصدر عن الفيبراتو مثلا، أن يساعد العازف أو المطرب لتمييز نفسه عن باقي الفرقة.
على أي حال حين لا يتعرف الدماغ على أي من هذه المؤشرات، يقوم بجمع مختلف مصادر الصوت، فيحولها إلى صوت واحد.
يترك صوت الموسيقى السحري أثرا فينا نتيجة تناسق الأصوات في النغم.
موسيقى العالم الغربي بين غيرها، تحدد من خلال نظام علاقات معقده بين أنغام الموسيقى.
يطبق هذا النظام أيضا على الموسيقى الشعبية والموسيقى الكلاسيكية.
يمكن لأي شخص تعرض بما يكفي لذلك النظام الموسيقي، أن يجد تناسقا أكبر بعض الإيقاعات بالمقارنة مع غيرها.
يعرف هذا التناسق بين الأنغام بالتناغم أيضا ويعتمد ببساطة على أسس حسابية خصوصا في الموسيقى الغربية.
فالأكتاف مثلا يحدد بنسبة اثنين إلى واحد. مما يعني أن تواتر النغم الأعلى يتألق بنسبة ضعف النغم المنخفض.
تترك هذه الصلة الحسابية البسيطة، إحساسا بالتناسق المتكامل.
الخمس، المرتبط بنسبة تتراوح بين الثلاثة والاثنين، وصلة الربع، بنسبة الأربعة إلى الثلاثة، تترك إحساسا بالتناسق أيضا.
من الناحية الأخرى، تترك الأنغام المترابطة بصلة اكثر تعقيدا، إحساسا بعدم التناسق.
حين يتم عزف هذه الأنغام، نسمع ضجيجا متسرعا يستفز نظامنا السمعي دون توقف، فيخلق إحساسا مزعجا.
رغم ذلك، فقد تم استخدام عدم التناسق في التأليف الموسيقي.
لأنه يساعد على لفت انتباه المستمع، باستفزاز حالتين من التوتر، والاسترخاء معا.
من المعلوم أن الإحساس بجمالية الموسيقى يعتمد إجمالا على الثقافة العامة للمستمع، فجميعنا يبدأ باستيعاب قواعد اللغة الموسيقية لثقافتنا باكرا منذ بداية حياتنا في الأجنة.
الاستماع الدائم للموسيقى ثم تأليفا بالاعتماد على هذه القواعد، يكفي أدمغتنا لتعلم هذه الموسيقى.
تؤكد إحدى النظريات، أن المثقفين، يتوقعون بعض الأنغام المحددة عند سماعهم لمقطوعة موسيقية، وحالما يتعرف على الملامح الموسيقية، تبدو المقطوعة متناسقة بالنسبة له.
أما إن غابت تلك الملامح بالمقابل تصيبه المقطوعة بالحيرة.
لهذا نرى أن بعض المقطوعات المعاصرة، لا توحي للأذن الغربية دائما بالتناغم.
يعتبر العقل البشري أستاذ قدير في الموسيقى. لان أسلوبه في تصنيف الأسس الموسيقية المعقدة، يثير الدهشة فعلا.
منذ أن بدأ العلم بالكشف عن آلية عمل الدماغ، بدأ التعرف على إدراكنا الموسيقي يتطور بسرعة كما تطورت الآلات الموسيقية أيضا. كما هو حال الناي على سبيل المثال.
تطور الآلة الموسيقية
طالما ترافقت الأشكال الموسيقية مع مسيرة التاريخ. وتعرضت الآلات الموسيقية للتعديل والتحسين الدائم تلبية للمتطلبات المتجددة للملحنين.
فالناي مثلا شهدت تحولا جذريا على مدار السنين. إلا أن مبدأها الرئيسي لم يتغير بعد. فمن الثابت مثلا، أن على شفتي العازف إخراج تيار هوائي رقيق يصطدم بفوهة الآلة الموسيقية.
ليبدأ التيار الهوائي بالذبذبة، فتحول طاقتها إلى العماد الهوائي لقصبة الناي القمعي، ما يؤدي إلى أمواج صوتيه تتناسب مع مناطق من ضغط الهواء وتمدده. تمر الموجات عبر القصبة، لتنعكس في نهايتها نسمات كتلك التي تمر خلال الربيع.
يحدد أنغام الناي من خلال طول الممر الهوائي في القصبة. فكلما طال الممر زاد طول الموجات، لينخفض الصوت الناجم عنها. والعكس بالعكس، فكلما قصر الممر الهوائي تقصر الموجات، ليرتفع الصوت .
لإطالة الممر الهوائي أو تقصيره يكتفي العازف بإغلاق الثقوب أو فتحها. والواقع أن صوت الموجات يتنقل بفعالية فقط بين موضع الفم وأول ثقب مفتوح فيها. تمكن هذه الظاهرة عازف الناي من الحصول على موجات بمقاييس مختلفة، ونغمات بإيقاعات متنوعة.
كانت الناي في العصر الحجري تصنع من قصبة عظم محفورة. كما استخدمت أيضا أنواع أخرى من القصب لصناعة الناي، وكانت الناي البدائية تعاني من نقص رئيسي إذ أن تجويفها، أي المساحة الداخلية للقصبة، تعتمد مسبقا على نوع المادة المصنوعة منها.
لهذا كان من المستحيل صناعة قطعتي ناي متطابقتين جدا.
كانوا في العصور الوسطى، ولحل هذه المعضلة، يصنعون الناي من خشب الفاكهة مستخدمين أدوات موحدة. منذ ذلك الحين والحفر يتم بتحديد ثابت. ما جعل مسالة تعديل الآلة ممكنا، كما سمح بترك مسافة معقولة بين الثقوب.
كانت الناي في عصر النهضة، تصنع من تجويف طويل فيه ستة ثقوب قادر على إصدار أنغام من ثمانيتين ونصف. وكان العزف عليها يتطلب كفاءة عالية في التحكم بالأصابع لإصدار جميع الأصوات.
أضف إلى ذلك أن تحديد بعض النغمات لم يكن واضح تماما، وكان على العازف القدير أن يعالج الأمر بتعديل موقع شفتيه.
اكتشف عام ألف وسبعمائة أن الحفر القمعي يؤدي إلى نتائج افضل. فتم تقسيم الناي إلى عدة أجزاء لحفر هذا الشكل الجديد بسهولة ودقة أكبر.
بعد هذه التحولات، حصلت الناي على أنغام أدق، وأصوات أغنى.
وزعت الثقوب ليتم التحكم بها بشكل اسهل، ما يمكن بالمقابل من الحصول على براعة اعظم في الأداء.
شهد القرن التاسع عشر، إضافة عدد من الثقوب عليها، لتصبح اثني عشر أو أربعة عشر ثقبا. بحيث يصدر عن كل ثقب نغمه، فيصبح بالإمكان عزفها بتركيز متوازن.
كما تم إدخال نظام المفاتيح أيضا لتسهيل توقف الثقوب المتعددة.
وجرى تبديل الخشب بالمعدن، مثل الفضة. الذي يصدر صوتا اكثر ضخامة.
مكن هذا التطور الحاصل من جعل الناي آلة لعزف افضل، حتى أنها تنافس آلات موسيقية أخرى في الأوركسترا، كما هو حال الكمان.
وما زالت الناي تنمو وتتطور حتى يومنا هذا.
يمكن إيجاد ثقب تجريبي مثلا يتم تشغيله بالإبهام، يمكن العازف من الحصول على ربع النغم الموجود في الموسيقى المعاصرة.
يمكن للعازف بفضل هذا التجديد أن يحصل على عدة نغمات في وقت واحد.
معالجة الأصوات والموسيقى عبر الكمبيوتر في هذه الأيام، تدفع الناي إلى ما هو ابعد من ذلك. يقوم الباحثون أولا بتسجيل صوت الناي في غرفة جدرانها معزولة عن الصدى ومغطاة تماما بمواد ممتصة للصوت تمنع الذبذبات أو ارتداد موجات الصوت لتمكن من تسجيل صوت نقي لهذه آلة.
يتم نقل التسجيل إلى كمبيوتر يحسب ثلاث مائة مرة في الثانية، ويتولى قياس كل الأصوات، بما في ذلك إيقاع النغم وكثافته. كما يقيس الكمبيوتر مستويات التناسق المتعددة، التي تصدر عن نغم تلك الآلة. ويتم تنظيم هذه المعلومات من خلال برنامج الكمبيوتر، القادر على توسيع كفاءات الآلة وإمكاناتها.
تمكن زيادة سرعة العزف لما هو أبعد من إمكانات أي عازف قدير من تحديث ناي متقنة تفوق كل ما هو معتاد.
يمكن للكمبيوتر أن يعدل صوت النغم من خلال تعديل ما في بعض التناسق. ويستطيع سحب بعض الأصوات، كما والتخلص من صوت أنفاس العازف التي عادت ما ترافقه.
توجد إمكانية للتهجين بين صوت الناي ونغم آلة موسيقية أخرى، كما هو حال الفايبرفون، وذلك لإصدار صوت الفايبر ناي، بالتنسيق بين تردد الإيقاع والنغم الهوائي الصادر عن الناي.
يعمل العلماء والموسيقيون معا لتطوير الآلات الموسيقية.
ويساعد جهدهما المشترك، في توسيع إمكانات التأليف الموسيقي.
تدعو دراسة القدرات الموسيقية للأطفال، إلى البدء بالتلقين الموسيقي في أعمار مبكرة جدا.
صناعة الآلة الوترية
لا غرابة في أن يتمكن صانعو الآلات الموسيقية، بالاعتماد على تجربتهم وأحاسيسهم، من تصميم آلات وترية بالغة الدقة والكمال.
تعود صناعة الكمان أو فن صناعة الآلات الوترية إلى قرون مضت، وما زالت حتى اليوم تمارس بالإخلاص نفسه.
يتألف الكمان من نصب أربعة أوتار فوق علبة صوتيه هي الصندوق الذي يتألف من طبقتين: العليا، وتسمى بلوحة الصوت، والقاعدة. تشكل الأضلاع الجزء الوسيط الذي يجمع بين الطبقتين. كما و قطعة خشب مصنوعة بحرفه، يسمونها الجسر، وهي تضمن الاتصال بين الأوتار ولوحة الصوت.
حين يتم العزف على الكمان، تنقل الذبذبات الصادرة عن احتكاك الأوتار بقوس الكمان، عبر الجسر إلى لوحة الصوت، كما والى حجم الهواء الذي في صندوق الصوت. يصدر صوت الكمان عن ذبذبات لوحة الصوت التي تستفز الجو الهوائي فتؤدي إلى موجات صوتية قويه. بدورها تنقل ذبذبات الهواء في صندوق الصوت أيضا إلى الجو الهوائي عبر تجويفين يعرفان بثقوب الصوت. وتساعد هذه الموجات الصوتية الأخرى على إكمال نغمات الكمان.
يعتني صانعو الكمان جدا باختيار المواد التي يحتاجونها.
وهم يعتمدون على مجموعة من المفاهيم التي تساعدهم باختيارها. عادة ما تستخدم أخشاب الصنوبر لصناعة لوحة الصوت. يجب أن تكون قطعة الخشب المختارة غير قابلة للتصدع. كما يجب أن يكون نمو الخشب عادي بالكامل وعلى المساحة أيضا، أن تزيد عما هو مطلوب بمليمترين على الأقل.
ينمو هذا النوع من الخشب على مرتفعات تتراوح بين ألف ومائتين وألف وخمسمائة مترا ضمن أحوال جوية مستقره.
يستعمل صانعي الكمان لقاعدة صندوق الصوت ألواح متموجة من خشب القيقب، التي تعكس ألوانا داكنة وفاتحة على التوالي. ويتم استخدام هذا الخشب لمزاياه الجمالية بشكل رئيسي. تتعرض الأخشاب قبل استعمالها إلى مراحل من التجفيف تتراوح بين عشرة وعشرين عاما.
يبدأ صانع الكمان بطبع شكل القاعدة ولوحة الصوت عن قالب نموذجي. ثم يقوم بقطعها، ويعالج شكلها بمنشار خاص. ليلصق بعدها قطعة من الخشب تحت لوحة الصوت يسميها خشب القاعدة.
توضع هذه القطعة بشكل مواز للأوتار، بحيث تدعم الأوتار المنخفضة.
تضغط الأوتار العليا أثناء العزف على اسطوانة خشبية تسمى عامود الصوت وهو متحرك، يؤثر تعديل موقعه على نغمات الآلة الموسيقية. عندما ينجز جسم الكمان، يبدأ العمل على صناعة العنق.
يغطى العنق بخشب الأبنوس وهو خشب بالغ الصلابة، يمكنه احتمال ضربات أصابع العازف.
يجمع سبعين بالمائة من الكمان باستخدام صانعه لصمغ طبيعي يستخرج من الحسك المغلي، أو من جلد الأرانب. يتميز الصمغ الطبيعي في أنه من السهل حله لتصليح الكمان.
تكمن الخطوة الأخيرة بطلاء الآلة الموسيقية، الذي يمنح الكمان لونه المميز، ويحميه من الرطوبة والغبار. يستخدم هنا طلاء البرنيش المصنوع من صمغ يستخرج من الأشجار الشرقية ويمزج بمواد أخرى تستعمل على مراحل.
لم يعد يبقى سوى تركيب الأوتار، التي تعتمد اليوم على مواد صناعية هي البرليت، التي تلتف حولها خيوط معدنية وفق معايير متعددة. تربط الأوتار المنخفضة بالفضة، والوسطية بالألمينيوم، أما الوتر الأعلى فبالحديد.
تطورت صناعة الكمان بجهود فرديه تعتمد على التجربة والإلهام.
وقد حاول الباحثون التأكد مما إذا كان بالإمكان أن تعتمد على أسس علميه. فأجريت أبحاث فوق الصوتية في المختبرات لاختبار القدرات الصوتية للخشب. فعملت أولا على تمرير إشارة فوق الصوتية عبر مكعب أو قطعة خشب أسطوانية. ثم قاست سرعة انتشار الإشارة ما فوق الصوتية. لتقدير الوقت الذي استهلك لمرورها عبر قطعة الخشب الصغيرة.
استعمل الميكروسكوب في اختبار آخر لدراسة التركيبة الداخلية للخشب عبر الأشكال والتناسق بين الأنسجة التي يتشكل منها.
أكدت الأبحاث بأن الذبذبات تنتقل بسرعة أكبر وتوتر أعلى عند تضيق دوائر النمو.
يعتبر ذلك نموذجيا بالنسبة لكمان يصدر أنغاما بارعة عالية.
وقد كشفت الأبحاث الاختبارية أن التركيبة المتوازية والبسيطة، تجعل من خشب الصنوبر وسيلة سهلة لنقل الذبذبات.
من ناحية أخرى يقدم خشب القيقب المتموج، الذي يستخدم لصنع القاعدة بنية اكثر تعقيدا تساعد على كبت الأصوات.
في نهاية التحليل تأكد للخبراء انه ما كان لصانعي الكمان ان يقومون باختيار افضل. ربما كانت تنقصهم التقنيات العلمية المتقدمة التي تمكن صانعي الكمان وبالاعتماد على الإلهام والتجارب من صناعة آلة موسيقية ليس لها مثيل بعد.
تعكس الموسيقى أسلوب عمل الدماغ، وقد تم اكتشاف المد والجزر الموسيقي في الطبيعة أيضا. من انسياب نهر النيل، مرورا بنبضات قلب الإنسان، وانتهاء بارتعاش محور الأرض.
فهل تعكس الموسيقى أيضا تناسق الكواكب وانسجامها في الفضاء ؟
——————–انتهت.
إعداد: د. نبيل خليل



























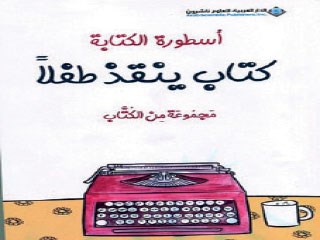 غلاف الكتاب (من المصدر)شارك في إنجازه 32 كاتباً وكاتبة
غلاف الكتاب (من المصدر)شارك في إنجازه 32 كاتباً وكاتبة
