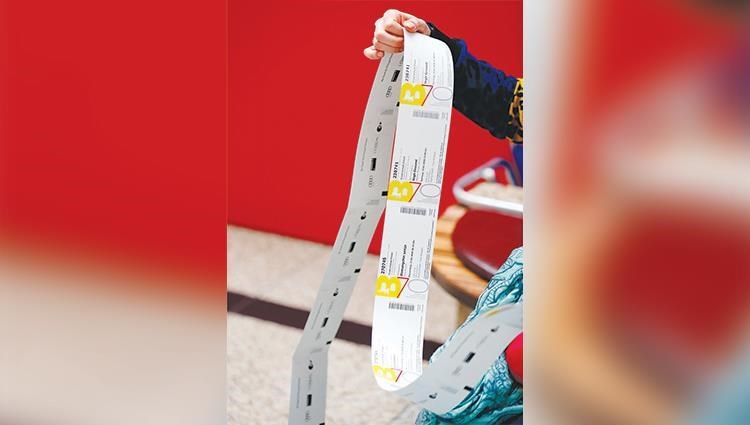حوار المستشرقة الأمريكية د. سوزان ستيتكيفيتش مع جريدة “عالم الثقافة”
حاورها: ناصر أبو عون
- بحوثي تستوعب الشعري العربي الكلاسيكي من منظور الدراسات الإنسانية
- مشروعي العلمي في القصيدة العربية القديمة محاولة لاكتشاف نظريات أدبية
- كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية والإسلامية طوق نجاة لي ولبحوثي
د. سوزان بينكني ستيتكيفيتش، أستاذة كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية والإسلامية، في جامعة جورج تاون بواشنطن، زارت سلطنة عمان ضمن فعاليات مؤتمر: (المناهج النقدية الحديثة. النص الشعري: قراءات تطبيقية) الذي نظّمته جامعة السلطان قابوس بالاشتراك مع النادي الثقافي والجمعية العمانية للكتاب والأدباء. وتمثّلت الإستضافة في جلسة نقاشيّة افتتحتها بالحديث عن دور كراسي السلطان قابوس في عمليّة التواصل الثقافي، وخدمة اللغة العربيّة، وآدابها، في الأماكن المتواجدة فيها بالجامعات العالميّة، ورأت أنّ هذه الكراسي تقدّم خدمات كبيرة للأدب العربي، وقد تلمّست هذا من خلال إقبال الدارسين عليها من مختلف دول العالم. وشملت النقاشات التي شارك فيها الشاعر شوقي عبد الأمير، والدكتور صالح الفهدي، والإعلاميّة لميس الكعبي وآخرون آراء ناقشتها الدكتورة (سوزان بينكني ستيتكيفيتش) في كتبها التي أهمها: «الشِّعر والشِّعريّة في العصر العبّاسيّ»، وهو أطروحة الدكتوراه للباحثة، التي نالت درجتها من قسم لغات الشرق الأدنى وحضارته في جامعة شيكاغو، (مارس، 1981)، بإشراف بيير كاكيا (جامعة كولومبيا). وتطرّقت د. سوزان ستيتكيفيتش في حديثها معنا إلى العديد من قضايا الشعر العربي القديم والاستشراق، ودور المستشرقين في خدمة الأدب العربي، وتحدّثت عن النظريات والمناهج النقدية، وتداخل الفنون، وجهودها في إثبات مكانة الشعر العربي القديم بين الأشعار العالمية الكبرى، مؤكّدة على دعوتها إلى إعادة تقييم القصيدة العربية القديمة بطريقة مقنعة لكل من القارئ العربي والغربي، وما طرحته في مؤلفاتها من إن “وعي أبي تمّام هو الذي مكّنه من الإحاطة بعناصر شِعريّة وأفكار جديدة، فاتت النقّاد العرب في العصور الوسطى، مثل الآمدي، بمفهومهم السكونيّ والمحدود عن الشِّعر العربيّ وهذا، بالتالي، سَمَح بإعادة استيعاب التقليد العربيّ – الإسلاميّ في تقليد شرقيّ قديم، بحيث يمكن للمفهوم العباسيّ عن الخلافة والأُمّة، على سبيل المثال، من المنظور الشِّعريّ على الأقلّ، أن يتجاوز القياس على الشيخ والقبيلة في الجاهليّة إلى القياس على مبادئ المَلَكِيّة الكهنوتيّة في بلاد ما بين النهرين القديمة.” ….. وقد التقيناها ودار معها الحوار التالي:
** بعد انتقالك من (شيكاغو) إلى جامعة (جورج تاون) في واشنطن ورئاستك لكرسي السلطان قابوس للدراسات العربية والإسلامية هناك،، هل تبدّلت أحوالك الأكاديمية؟
** في الحقيقة لقد كنت أتعرض لمعاناة شاقة في شيكاغو وجاء كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية في واشنطن بمثابة طوق نجاة لي ولبحوثي بل أقول أكثر من هذا فقد انتقلتُ معه من حالة (الإهمال والتناسي المهين) إلى حالة أكثر يفوعةً ونشاطًا وحيوية وإنقاذًا من حالة الجمود التي كنت أعيشها في شيكاغو.. فكرسي السلطان قابوس كان بمثابة صفحة جديدة وحياة أجد مملؤة بالأمل يداخلك هذا الإحساس عندما تكتشف أنّ هناك أناس يقدرون جهودك العلمية بل يدعمون بحوثك ماليا ومعنويا.. فشكرا من القلب والعقل للسلطان قابوس وسلطنة عُمان التي لا تفتأ تدعم مشاريع التقارب الثقافي والإنساني حول العالم متمثلة في كراسي السلطان قابوس الممتدة في جامعات العالم العريقة وتتوزّع على جوانب عديدة من الكرة الأرضية وقارات العالم المختلفة.
** كتابك (القصيدة والسلطة في القصيدة العربية الكلاسيكية) اعتبره النقاد خطوة رائدة في مجال استكشاف الجوانب الشعائرية والطقوسية والاحتفالية للقصيدة العربية القديمة وفي تطبيق النماذج والمناهج الانتروبولوجية والتأريخانية الجديدة على الأدب العربي الكلاسيكي. فما أهم الأسرار التي يكشف الكتاب عنها؟
** الهدف الأساسي من كتابي هذا، كما أشرت في مقدمة الكتاب، هو استيعاب التقليد الشعري العربي الكلاسيكي ضمن الدراسة المعاصرة للثقافة العربية الإسلامية من منظور الدراسات الإنسانية. وتعد قصيدة المدح الأطروحة الأساسية والموجهة إلى الممدوح أو الحاكم، اتمّ إبداعها وتضمينها أساطير وأيديولوجيات معينة عن شرعية الحكم العربي الإسلامي، وقد استطعت من خلال بحوثي بيان أن هذه القصيدة شديدة الصلة بصورة جوهرية ومتكاملة بالجوانب السياسية والمراسمية لحياة البلاط، وإنها بعيدا عن كونها مجرد قصيدة وصيغة تعليمية أو متملقة بطريقة مذلة، كما زعم بعض النقاد، بل تلعب دوراً فعالاً في طقوس التبادل والمفاوضات ذات الطبيعة الحرجة وصنع الأساطير في البلاط العربي الإسلامي. وفي سبيل ذلك استخدمتُ أفكاراً معاصرة في العلوم الإنسانية والاجتماعية كي تستكشف تقليد إنشاء قصائد المدح وإنشادها بين يدي الحكام العرب المسلمين في إطار كل من الملكية المقدسة في الشرق الأدنى القديم، والتوسل والتفاوض والجنوسة والسلطة السياسية والطقوس واحتفالات الولاء والتقليد والمنافسة على شارة الشرعية الدينية / السياسية.
** في دراساتك الأدبية والاستشراقية لابد هناك من نقطة انطلاق.. من أين كانت بداياتك مع أدبنا العربي القديم؟
** نقطة الانطلاق لمشروعي تمثلت في محاولة اكتشاف بعض النظريات الأدبية وبالضرورة ابتداع أدوات تحليلية جديدة استطعت من خلالها إعادة وزن أو تقييم القصيدة العربية القديمة بطريقة مقنعة لكل من القارئ العربي والغربي. متوسلةً بالمنهج الطقوسي وطقوس العبور وطقوس تبادل الهدايا، والتاريخية الجديدة، ونظرية الأداء، كما سأقدّم أيضا أعمال بعض تلاميذي٬ في أمريكا والعالم العربي واليابان، في تطبيق وتطوير هذه المناهج مع الاستفادة من أدبيات نظرية ما بعد الاستعمارية ونظرية تداخل الفنون ونظرية الشعر على الشعر٬ وذلك لعرض القصيدة العربية القديمة على المسرح الشعري العالمي.
كتابك (الشِّعر والشِّعريّة في العصر العبّاسيّ) هو في أصله أطروحتك للدكتوراه التي نلتِ عنها درجتكش العلمية من قسم لغات الشرق الأدنى وحضارته في جامعة شيكاغو، (مارس، 1981)، بإشراف بيير كاكيا (جامعة كولومبيا). وعلى الرغم من بعض المآخذ النقدية والملحوظات التي يمكن أن نجادلكِ فيها فإن أطروحتك تكشف عن تلك الحريّة الفكريّة والثقافة المقارنة، التي تُعوز المدرسة التقليديّة في قراءة شِعرنا العربيّ، قديمًا وحديثًا؟!!
في الحقيقة هذا الكتاب يكشف عن معترك التناقض الجوهريّ الذي وَقَع فيه نُقّاد العصر العبّاسيّ، بين (جعل الشِّعر القديم هو معيار الإبداع)، و(القول بأن محاكاة ذلك المعيار قد باتت مستحيلة)؛ لاختلاف البيئة زمانًا ومكانًا. والنتيجة هي نفي الإبداع عن غير القديم. وتلك نتيجة ثقافيّة في حقيقتها لا نقديّة، تمخّضت عن نزوع طاغٍ إلى تقديس القديم وازدراء الجديد، في الأدب وغير الأدب. إلاّ أنني أُفسِّر ذلك، بل أرى أن التحوّل من الثقافة الشفويّة إلى الثقافة الكتابيّة قد كَمَن وراء تلك الأزمة؛ لأن بناء القصيدة العربيّة – من أوزانٍ وقوافٍ وفنون بيانٍ وبديعٍ – ما كان إلاّ لأن “وظيفة الشِّعر في التقليد الشفويّ الجاهليّ هي حفظ المعلومات” وتلك الأدوات تساعد على الحِفظ، وحين أضحت الثقافة كتابيّة تعطّلت وظيفة تلك الأدوات، ومن ثمّ تعطّلت وظيفة الشِّعر القديمة.
** على الرغم من اتصال أعمالك بمدرسة شيكاغو الاستشراقية إلا أنك تحتلين مكانة متميزة فيها حيث قمت بتطوير أعمالك النقدية لتصل بالقارئ الغربي قبل العربي إلى فهم أعمق لطقوسيات القصيدة العربية القديمة ومدارها الأسطوري لاحظنا ذلك من خلال مطالعتنا لكتابك (أدب السياسة وسياسة الأدب).
في الحقيقة أنا أنتمي كما قلت إلى (مدرسة شيكاغو) التي أسسها المستشرق (الأوكراني الأصل) ياروسلاف ستيتكيفيتش (تلميذ السير هاملتون جب)، قبل نحو ثلاثين عاما. وهي مدرسة ذات توجه فارق في تاريخ الاتجاهات الاستشراقية التي رصدت أو ترصدت بموضوعات الأدب العربي القديم فقد أسهم باحثو (مدرسة شيكاغو في تصفية المثالب التي لفتت انتباههم في دراسات المستشرقين ذوي المرجعية الدينية القامعة القاصرين معرفيا. وكذلك الدراسين العرب الواقعين في أسر التبعية الذهنية لمناهج الغرب المفارقة لمعطيات الأدب العربي بمعنى الكلمة، كما هو الحال في الآداب الغربية، برغم الاختلاف القائم بين نوعيهما. وأيًا كانت صعوبة فهم الأدب العربي واستغلاقه المبدئي المعرفي على النظرة الغربية التي تضيق به فإن قصائده هي أعمال فنية في ذهنية الثقافة التي أنتجتها، في سياق وعي سوسيوتاريخي خاص. ومن ثم لا يمكن أن نخضع تقييمها، أو تفسيرها للمقاييس النقدية التابعة، أو للمناهج القائمة على الآداب الغربية أساسا حيث تصير تطبيقا ملتويا مفرغا وسطحيا تماما، مما يندرج تحت نمط غير أصيل من التحليل، ولا يضمن هذا التطبيق أكثر من كونه مجاريا أو لاهثا وراء أحداث (موضات) النقد في باريس أو نيويورك أو غيرهما.
** تقولين: إن للشعر العربي القديم وظيفتين!! أليس هناك وظائف أخرى تمّ اكتشافها حديثا؟
** لقد توصلت عبر دراستي للشعر العربي القديم أنّ هناك ثمة وظيفتين جديدتين نَجَمَت حينئذٍ للشِّعر؛ الأولى طقوسيّة، تأتي تعبيرًا عن الهويّة العربيّة، وتنبني على أساس البنية الطقوسيّة العميقة- النموذج الأصليّ للتضحية كما عُرف في الشرق الأدنى القديم. والثانية تفسيريّة، بحيث أصبح شِعر البديع العبّاسيّ “ما بعد شِعر أي أن الشِّعر صار وسيلة تفسيرٍ للشِّعر القديم من أجل مجتمع متحضّر في العصر العبّاسي لم يألفه. هذا إضافة إلى توظيف تلك الوسائل الفنّيّة، التي عُطّلت لاستغناء الذاكرة عنها، للتعبير عن المفاهيم التجريديّة الكلاميّة، ومن ثم جاء توظيف أبي تمّام للوعاء الشِّعريّ التقليديّ لتفسير أحداث عصره.
** ما الهدف الاستراتيجي والأكاديمي من وراء بحثك في الشعر العربي؟! وإفناء حياتك فيه؟!
** سعيت، ولا أزال، في دراساتي للشعر العربي القديم ونشاطاتي الأدبية والجامعية أن أثبت مكانة الشعر العربي القديم بين الأشعار العالمية الكبرى. ومما حال دون ذلك عراقيل متعددة، نقدية كانت أم جمالية٬ تاريخية كانت أم سياسية. وسأسعى طوال اشتغالي بالبحث العلمي وإذا امتد بي العمر أن أقدّم بعض الأفكار والملاحظات في هذا الموضوع، من حيث المعوقات السياسية والتاريخية، مثل ظاهرة الاستعمار الغربي مع كل ما أسفرت عنه من “صدام الحضارات”، و(الاتجاه إلى الماضي) من جهة، و(رفض الماضي ومعه الهوية التقليدية) من جهة أخرى، وتبنّي القيم الغربية بدايةً من الرومانتيكية وصولا إلى الحداثة، وما بعدها.