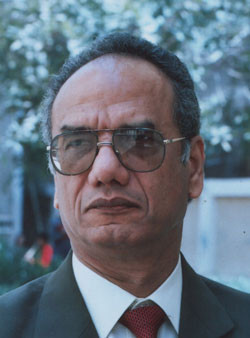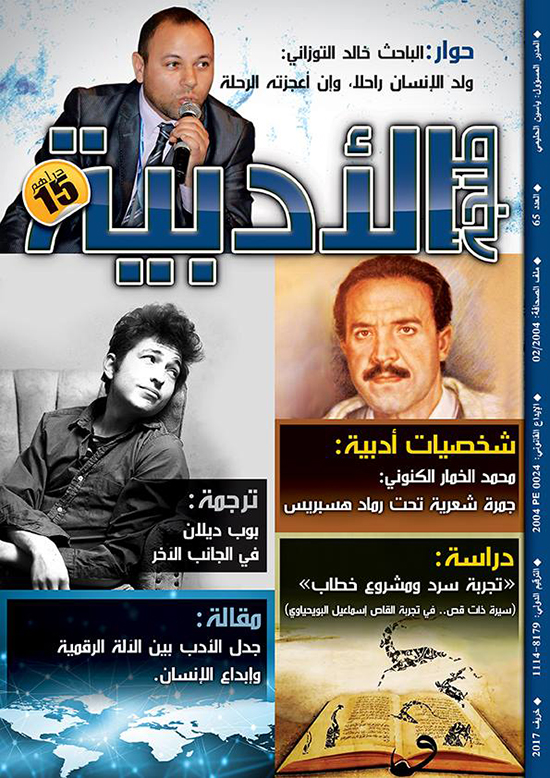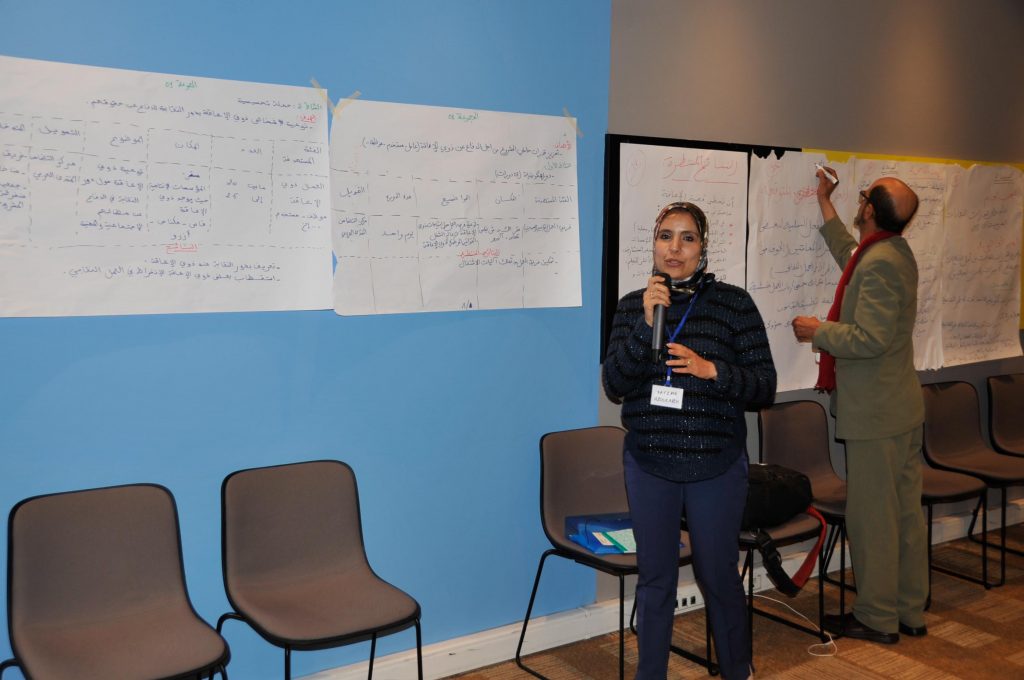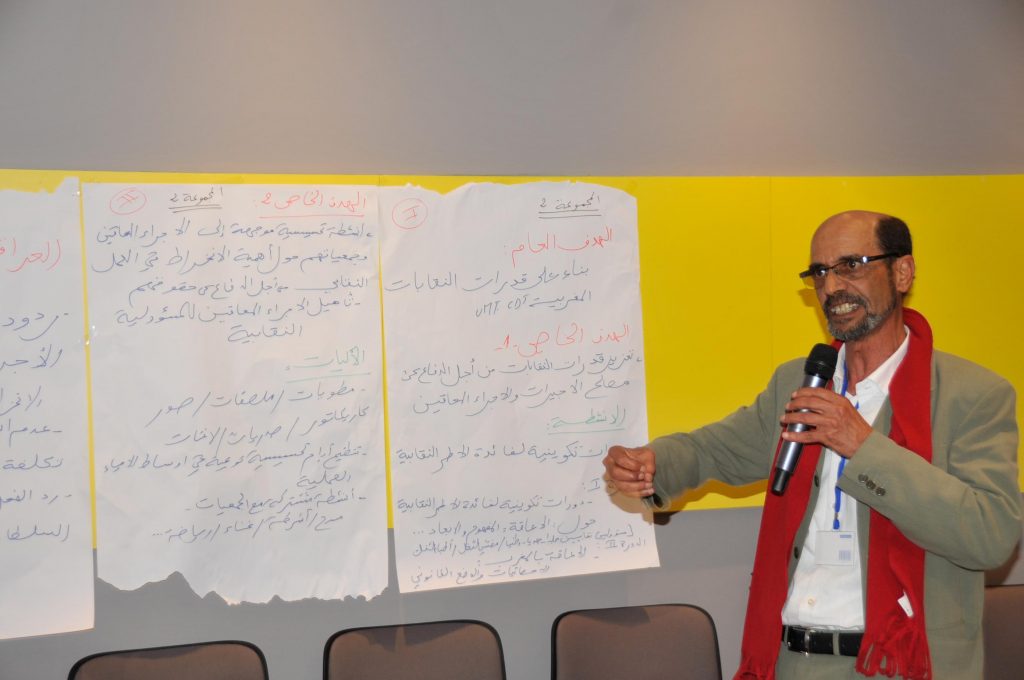علم العمران الخلدوني في رؤية جديدة!!
صدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي كتاب «علم العمران الخلدوني وأثر الرؤية الكونية التوحيدية في صياغته: دراسة تحليلية للإنسان والمعرفة عند ابن خلدون»، للباحث الجزائري صالح بن طاهر مشوش. وقد اعتمد الباحث منهجية التزمت اتخاذ معارف الوحي مرجعية عليا في التحليل والتفسير، والتحقق من النتائج المتحصل عليها، ومناقشة بعض التفسيرات الواردة في الدراسات التي اعتنت بابن خلدون، ومن ثم قام الباحث عبر صفحات كتابه بما يلي: تحليل النصوص من وجهة نظر أصولية، ووفق فلسفة العلوم الإسلامية. الاستعانة ببعض العلماء والمدارس التي لها علاقة بعلم العمران لإجراء المقارنات، تفعيل الرؤية الكونية التوحيدية، وتطبيق معايير الوحي في نقد آراء الباحثين وتقويمها.
ويذهب الدكتور صالح مشوش إلى إن الطبيعة المركبة التي يتميز بها موضوع علم العمران جعلت منه نسقاً معرفياً شاملاً يملك قابلية التموقع داخل نسق أصولية الفكر الإسلامي، وهي الخاصية التي وعاها ابن خلدون تماماً، لذا صرّح منذ البداية أن مسائل علم العمران تتقاسمها علوم أخرى من زوايا متقاربة، أو بما سماه «الجريان العرضي» الذي يمكن أن يفهم منه الجانب الوظيفي للقضايا، وليس مكانتها التي تحتلها في الهرم الفكري والمنطقي للمعرفة ذاتها، فتناوُل الفقهاء لقضية الكسب مثلاً، انصبَّ على استخراجهم الأحكام الشرعية، من وجوب وندب وحلال وحرام، الواقعة على حالات جزئية، بينما في علم العمران يصبح موقع قضية الكسب محوريًّا، لأنه يدخل في تشكيل أنماط الاجتماع من سلوك وتصور، وهي كلها مجالات يهتم بها علم العمران البشري. وتأكيداً على هذا الامتداد، ذكر ابن خلدون فئات من العلماء الذين يشاركونه من زوايا مختلفة في دراسة تلك المسائل على النحو التالي: الحكماء والعلماء في إثبات النبوة والتعاون بين البشر، والملك، والأصوليون في إثبات اللغات، وحاجة الناس إلى العبارة، أما الفقهاء، فكان اشتراكهم في علم العمران في تحليل الأحكام الشرعية بالنظر إلى المقاصد. وفي رأي ابن خلدون كل هذه المباحث تدور في فلك واحد وهو «المحافظة على العمران».
ومن الأبواب المهمة التي تطرق لها مشوش وظائف العمران وهي الوظيفة الأصولية، أن المهمة العلمية التي حددها ابن خلدون لعلم العمران تتمثل في إنقاذ علم التاريخ من الثغرات المنهجية الناجمة عن الجهل، وعدم استيعاب المؤرخين طبيعة الخبر التاريخي في حقيقته وملابساته، إضافة إلى انتشار ممارسات أخرى مقصودة اتخذها المؤرخون وسيلة لتحقيق أغراضهم الشخصية بنقل أخبار معينة وتمريرها من دون تمحيص ونقد.
الوظيفة العقدية، وهي الوظيفة التي تسقط كل التأويلات المادية والعلمانية التي كثيراً ما روجت لها المدارس الاستشراقية وأتباعها من الباحثين العرب الذين ألصقوا بها ألواناً من الفكر المادي، كالمادية الجدلية والنفعية والوضعية وغيرها من الفلسفات التي يقارن بها ابن خلدون بآباء هذه الاتجاهات الغربية، وهي التي لا تعبّر إلا عن أصحابها وثقافتهم العلمية والحضارية.
وثمة عبارات كثيرة تزدحم بها نصوص المقدمة تحمل قيماً وتصورات عقائدية مركبة في جذور المعرفة عند ابن خلدون، تمثل النور الخفي الذي صاحب ابن خلدون في بحثه وتفكيره وكل ما قدمه من تفسيرات حول الإنسان والعمران. كما أنها شكلت الغاية من البيان حيث لم يقصر ابن خلدون في ربط الإنسان والعمران والمعرفة بالوحدانية، وإثبات هذه العلاقة وبيان وظيفتها في العمران البشري والمعرفة الإنسانية، وتعد من بين أهم إنجازات ابن خلدون، وإن كانت هذه النظرة لا تخصه وحده، بل عرفها جل علماء المسلمين الذين يؤمنون إيماناً راسخاً بأن العلم ما هو إلا وسيلة للتقرب إلى الله، بمعرفة أسرار خلائقه، وآياته التي تتجلى في كل مخلوقاته.
وهناك الوظيفة العمرانية النابعة من أن المعرف والنتائج العلمية التي يقدمها علم العمران ليست مجردة، كالتي يسيطر عليها النسق الفلسفي اليوناني الذي انتقده ابن خلدون في مناسبات عديدة في المقدمة. إن علم العمران الخلدوني علم عملي، يتوجه إلى الواقع الذي يعيشه المسلم ليغيره وفق مبادئ الوحي اليقينية الثابتة.
وللتأكيد على هذا المقصد، جعل ابن خلدون يوسع من نطاق نظرية الحسبة، حين شمل نقده أصنافاً كثيرة من الناس في المجتمع الإسلامي، مثل الحكام والعلماء والفقهاء. وظهور هذه النظرية في كتابات ابن خلدون يعد دليلاً واضحاً وقوياً على الوظيفة العملية التي يقوم بها علم العمران.
وذهب مشوش إلى أن علم العمران لم يكن في معزل عن امتداد مبحث الاستخلاف، بل في إطاره حاول ابن خلدون أن يتحرك بمرجعية هذا المفهوم في المجال الحيوي والعملي، الذي يمثل أحوال الناس الفعلية، أفراداً وجماعات، ولهذا كانت أهمية مفهوم الاستخلاف عند ابن خلدون لا تقل عن مفهوم «العمران» الذي سمي به علمه الجديد. إن حضور عقيدة الاستخلاف في علم العمران، وهو الذي مكَّنَ لابن خلدون من تأسيس ذلك المنطق المتعالي المتميز الذي استطاع بواسطته الوصول إلى نتائج أقل ما يقال عنها إنها تعبر بدقة عن وضع المسلم، وظروف حياته السياسية، والاقتصادية، والعلمية في القرن الثامن الهجري.
ونتيجة للدور الذي يلعبه مفهوم الاستخلاف في الفكر الخلدوني، كان وروده في نصوص «المقدمة» واضحاً، إذ كلما أراد ابن خلدون أن يبين دلالاته، رجع إلى نصوص الوحي، وهي الخطوة الأساسية التي جعلت من علم العمران ككل يبتعد عن الفكر الفلسفي المجرد، الذي يحمل في طياته الغموض، والتعقيد. وقد ظهر مفهوم الاستخلاف في المقدمة بدلالة الإرادة الإلهية في خلق الإنسان في أربع مناسبات، بينما جاءت كلمة «الاعتمار» القريبة في الدلالة من الاستخلاف، في أحد عشر موقعاً، أما مفهوم «الإصلاح» الذي ارتبط بموضوعات مختلفة، منها ما يختص بالنفس والدين والرعية والخلق والبشر ومزاج الدولة والعمال، فكان ظهوره في المقدمة إحدى عشرة مرة كذلك.
وقد سعى الباحث وفق منهجيات متشابكة ومتداخلة، إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- معرفة فلسفة المنهج وآلياته التي سلكها ابن خلدون، والتي كانت سبباً في حسن توظيف مصادر الوحي في تفسير ظواهر العمران المختلفة والمتغيرة.
2- إحياء مفاهيم علم العمران في دراسة الإنسان والمجتمع، وتـفعيـلها في إطار نـظريـة معرفـيـة إسلاميـة تعمل على فهم الواقع العمراني المتغير وفق خصوصيات الأمة الإسلامية.
3- تأكيد على أهمية الرؤية الكونية التوحيدية والبعد في الفكر العلمي الخلدوني، وضرورة مراعاة معاييرها في دراسة ظواهر العمران البشري واستخراج قوانينه، وترشيد عمليات التغيير والإصلاح اللازمة لتحسين أوضاع الأمة الإسلامية على المستويين الفردي والجماعي.
4- عرض بعض جوانب من فكر ابن خلدون الإصلاحي والحيوي والذي تبدو الحاجة إليه ماسة وضرورية لعلاج مشكلات عملية تواجه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر.
بقلم/ خالد عزب
المصدر / جريدة الحياة اللندنية
٩ فبراير ٢٠١٣