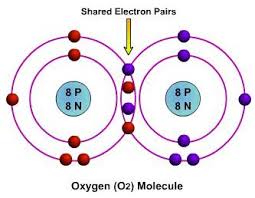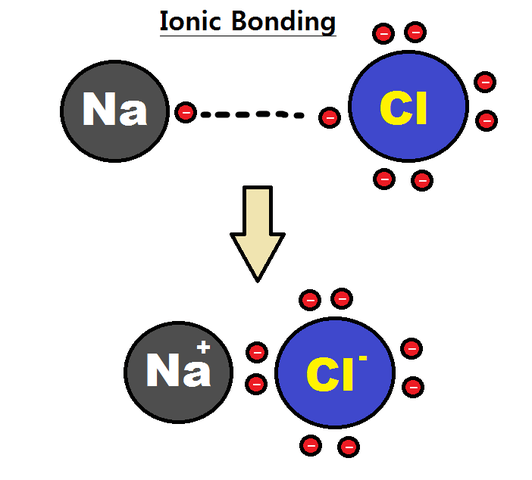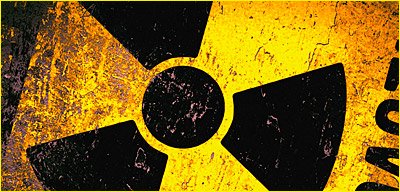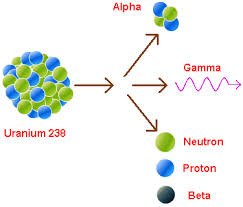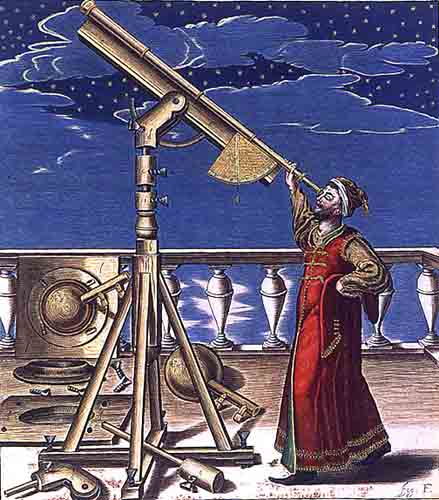النقد العلمي عملية مضبوطة لافساح المجال لرؤية أعمق لعمل ما. وهو يشتمل على التحليل والتمحيص وفرز المعطيات قبل إعادة تركيبها وإدماجها في هياكل أقرب للادراك العام، عمل من هذا القبيل يكون له دوران: إعطاء حياة جديدة للعمل بمعنى تقريبه من المتلقي بشرحه وتوضيحه وتحليله وبمعنى الدعوة إلى تناوله وإعادة تناوله بالقراءة أو بالمشاهدة. والثاني، البحث عن نقط التوافق والاختلاف في مجموعة من الأعمال ودمجها في عمارة نظرية تؤسس لتيار أو مدرسة أو اتجاه فكري ما. والنقد عملية تقييمية وليس عملية تقويمية. فدور الناقد الأول هو تحديد مكامن الضعف والقوة في عمل ما، وليس من حقه أن يدعو إلى إعادة الانتاج وإلى البحث عن صيغ أخرى غير التي ظهر فيها العمل لأن ذلك من حق صاحبه فقط.
ويبقى
نقد المسرح من أصعب الممارسات النقدية باعتباره نقدا مركبا تتداخل فيه
عناصر اللساني والسميائي والصوتي تداخلا تاما وشاملا. وهذه العناصر تندمج
في مجموعتين: الأولى هي النص وتضم اللساني والثانية هي الفرجة وتضم
السيميائي والصوتي. ولكي نقوم بنقد مسرحي علمي يجب أن نلم بمجموعة من
العمليات نسوقها في الورقة التالية بشكل مختزل.
1- مقاربة اللساني:
المسرح
لغة، واللغة في دلالتها الحديثة تجاوزت “الكلام” لتشمل مجموعة من آليات
التواصل. ولغة المسرح- كما أشرنا- لغة مركبة من ثلاثة عناصر.ونقف هنا عند
العنصر الأول وهو العنصر اللساني. فالمسرحية تبني –اللهم في بعض التجارب
الحديثة- على نص معين. ويجب على الناقد المسرحي أن يعرف ماهية النص للحكم
عليه من خلال تركيبه اللغوي والمنطقي وليحدد شكله من بين الأشكال التالية:
أ-النص
المعد أصلا للعب نص مسرحي مائة بالمائة، إذ تعتبر كتابته تسلسلا مرتبطا
بالزمن ومنطق الأحداث ويكون هو الأصل في انطلاق بناء العرض المسرحي.
ب-النص
المسرحي المعد أصلا للقراءة يقدم مسرحية حملها صاحبها بتركيبات لا تقدم
على الركح بيسر، مما يضطر المخرج إلى إعادة أجزاء من تركيبات النص المسرحي
ليتحمل مسؤوليتها نيابة عن المؤلف.
ج-النص
المقتبس عن رواية: نصبح هنا أمام تأليف أول وتأليف ثان. هذا النوع من
النصوص يصبح كسيناريو يكتب انطلاقا من قصة مؤلفة تأليفا كاملا مسبقا.
د- النص المركب من مجموعة من النصوص سواء مسرحية أو روائية.
هـ- النص المركب من قصائد أو دواوين شعرية.
و- النص المكتوب الذي يضاف إليه ارتجال الممثلين.
ز- النص المرتجل انطلاقا من فكرة مسبقة متفق عليها.
فتحليل هذه الأنواع من
النصوص لا يمكن أن يكون متشابها في كل الحالات. ولذلك وجب على الناقد
معرفة نوع النص الذي يقوم عليه العرض المسرحي، ومن ثم اختيار المنهج الذي
سيقوم عليه النقد. ونشير إلى أن نقد النص لا يمكن أن يبتعد كثيرا عن
المقاربة الأدبية باختلاف توجهاتها (نقد كلاسيكي سوسيولوجي، سيكولوجي،
لساني) ويبقى معيار طول وقصر القراءة في النص المميز بين النقد الأدبي
والنقد المسرحي.
2- مقاربة السيميائي.
إذا
كان النص هو أساس العمل المسرحي، فهناك عروض مسرحية يغيب فيها النص بمعناه
الحواري. ومن هنا وجب مقاربة العرض المسرحي من خلال ما تراه العين.
أ-
الديكور: على الناقد أن يقف عند وجوده أو غيابه. وأن يبرز عند حالة وجود
الديكور ما إذا كان ضروريا للعرض أو زائدا. وإذا كان ضروريا هل كان نافعا
وفعالا ووظيفيا. وفي حالة وجود ديكورات متزامنة يجب أن نسأل حول تقاربها
وتداخلها أو تباعدها، وحول تأثير بعضها في بعض.
ب-
حركة الممثلين: هل هي تزامنية مع الحوار أم تسبقه أم تتبعه؟ هل تتم الحركة
على كل الفضاء الركحي الذي يشغله الديكور أم تتجاوزه أم لا تشغله كاملا؟
ج-لعب الممثلين:
مدى
تفاعلهم مع الخطاب الذي يصدرونه، ومدى تفاعلهم مع الشخصيات التي يؤدونه ا
ومدى نسبة تقمصهم لهذه الشخصيات. مدى التعبيرية الجسدية التي يظهرونها.
د-
تفاعل الممثلين: يجب على الناقد هنا أن يقف عند ضبط لحظات الكلام والصمت،
ووقت الحركة والوقوف وأن ينظر إلى مدى تجاوب الممثلين فيما بينهم وإلى مدى
غبرازهم للتعبير الطبيعي أثناء تخاطبهم.
هـ-
الانارة: حسب نوعية المسرحية يمكن للانارة أن تلعب دورا عاديا أو دورا
مهما، فهي تشكيل –خصصوصا في المسرحي التجريبي جزءا من السينوغرافيا، ويجب
أن ينتبه الناقد في كل الحالات إلى تركيبها، ألوانها قوتها وعفها، ويجب
عليه أن ينتبه بشكل أدق إلى ثنائية النور والظل ومدى تأثيرها على المشهد
المعروض سلبيا أو إيجابيا.
و-
المؤثرات المشهدية، هناك مسرحيات تستعمل مؤثرات مشهدية من قبيل الدخان
وتمويج الانارة، واستعمال أثواب عريضة، واستعمال الات لتمثيل مشاهد خارقة (Deus exmachina) وغيرها. وعلى الناقد أن يحاول تفسير العلاقة بين هذه المؤثرات والمضمون العميق للعمل ومدى توافقها معه.
3- مقاربة الصوتي:
تلعب
الأصوات دورا مهما في العمل المسرحي من حيث أنها تساعد على اضفاء
التعبيرية اللازمة لمضمون الخطاب المسرحي. ومن خلال ممارسة النقد يجب على
الناقد الانتباه لما يلي:
أ-
الالقاء ومدى قصاحته من حيث مخارج الحروف وضبط النطق بالكلمات ومدى ضبط
المقاطع الجملية مع المضمون المعبر عنه. ويجب الانتباه إلى رفع انبر وخفضه
وهل يساهم في التعبير عن الحالات النفسية المختلفة.
ب- صوت كل ممثل على حدة ومدى جوهريته، قوته أو ضعفه وتماثله مع الشخصية المقدمة.
ج-الاداءات الجماعية، هل هي متناسقة أم يتخللها بعض النشاز، والنظر في علاقتها مع مضمون العمل المسرحي وهل وجودها ضروري أم لا؟
د-الموسيقى وارتباطها بالعرض وتطوره، وهل تساهم في تشكيل الفرجة أم تعتبر اضافية فقط؟
إذن
لكي يقوم النقد المسرحي بواجبه، على الناقد أن يلم بكل هذه المعطيات، ولا
يحق له أن يغفل احدها فتفشل عملية النقد أو تكون ناقصة. وإذا كان من الواجب
على الناقد الالمام بكل هذه المعطيات لمقاربة عمل مسرحي ما سواء كان ملهاة
أو مأساة أو شكلا تجريبيا، فإن الحيز الذي يمكن أن يخصصه منبر غير متخصص
من صحف وملاحق ومجلات لا يمكنه أن يضم عملا نقديا متكاملا.ولذلك فما يمكن
أن يقدم على هذه المنابر لا يمكن أن يكون سوى مقاربات نقدية.
وللقيام بعملية النقد على أحسن وجه يجب أن تنوفر للناقد مجموعة من الأدوات الوظيفية فيجب أن يتوفر على النص المكتوب للعمل المسرحي، وإذا أمكن على النص المكتوب للاخراج، ويجب أيضا أن يشاهد العرض أكثر من مرة حتى يمكنه ضبط كل آلياته.
نشرت فى 11 سبتمبر 2009