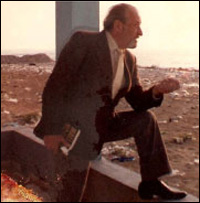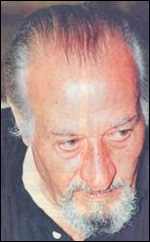المشكلة الفلسفية
د. قاسم المقداد
لو فقدت مفتاح بيتك وأنت تريد دخوله ، فهل هذه مشكلة؟ وهل فقدان المفتاح مشكلة؟ . للمشكلة حدان متلازمان: فقدان المفتاح وإرادة الدخول، وفقدان أحدهما يعني سقوط المشكلة.
المشكلة تعبر عن نفسها بجملتين مختلفتين ومتعارضتين، لكنهما متلازمتان. وهنا لا يوجد تناقض ، بل صراع بين نية الدخول إلى البيت وفقدان المفتاح.
هذا مثال بسيط لكنه نموذج لقضايانا الحياتية تقريباً ، والتي يلخصها الصراع بين الرغبة أو النية من جهة وحدث محتوم من جهة أخرى.وسبب قضايانا كلها وجود عائق معين .
المشكلة أعلاه تحتمل عدة حلول : (1) كسر الباب أو(2) الدخول عبر النافذة أو(3) الاتصال بمتخصص بالأقفال . أما البحث عن المفتاح والعثور عليه فحلٌّ للمشكلة يتميز عن سواه لأنه لا يحل المشكلة ولا يلغيها لأن العثور على المفتاح يلغي أحد حديّ المشكلة أي الصراع. في المقابل ثمة حلول لا تدمر المشكلة بل تحلها من خلال الاحتفاظ بها بوصفها مشكلة. هذه الحلول لا تنكر المشكلة بل تتجاوزها من خلال الإبقاء عليها. وبالتالي هناك حلول تلغي المشكلة وأخرى تتجاوزها. لكنها لا تتمتع بالقيمة نفسها بسبب انعدام قيمة نتائج بعضها. بمعنى آخر ، بعض الحلول قد تطرح بدورها قضايا ما كان لها أن توجد من دونها. لذلك لا تتساوى الحلول ، وينبغي اختيار الحل الأقل صعوبة.
نحن إزاء مشكلة وحل لا معنى لهما إلا من خلال علاقتهما بالمعيش . وهي مشكلة تختلف عن المشكلة الفلسفية، مع ما بينهما من تشابه .هناك ثمة اختلاف بين القضايا المعيشية كامنة فينا ،نقع عليها وتطرح نفسها بنفسها ولا نستطيع تجنبها ، بينما نستطيع ذلك فيما يتعلق بالمشكلة الفلسفية التي لا تسعى إلى إشباع الرغبة في تحقيقها ، بل إلى اكتشاف الحقيقة ومعرفتها ،وإلا فلا معنى لها .
المشكلة الفلسفية ليست صراعاً بين رغبة وواقعة، بل صراع بين جملتين، وبين خطابين يفتقران إلى التجانس ، بمعنى أن المشكلة الفلسفية تُطرح بصيغة منطقيّة تعبر عن تناقض. والتناقض شكلاً، هو تعارض ملفوظين لا يصدُقان في الوقت نفسه. إذ لا بد أن يكون أحدهما صحيحاً والآخر خاطئاً حتماً ، والعكس صحيح. لكن هذا لا يعني أن التناقضات كلها قضايا فلسفية، لأن التناقض وحده غير كاف لكي تكون هناك مشكلة فلسفية، لضرورة أن تتوافر الصحة(الصدق) في حديّ التناقض . كل القضايا الفلسفية تناقضات ، لكن ليس كل التناقضات قضايا فلسفية. فالتناقضات التي يتجلى خطأ أحد حديها بوضوح تدخل في باب التناقضات ، لكننا لانعدها قضايا طالما لا شيء يعوق بحثنا عن الحقيقة في هذه الحالة.لكن كيف يمكن للتناقضات أن تكون حقيقية وتتناقض مع بعضها في الوقت نفسه ؟ فالمعروف أنه إذا كان أحد التناقضين حقيقياً ،فلا بد أن يكون الآخر خاطئاً.فقد حبا الله الناس كلهم بالعقل ، أي القدرة على تمييز الصح من الخطأ ، وفي الوقت نفسه ، جعلهم معرضين للوقوع في الخطأ.فهل نحن قادرون على معرفة الحقيقة أم نفتقر إليها؟
القضايا الفلسفية ليست من اختراع الفلاسفة. إنهم، بطرحهم لها إنما يوضحون التناقضات بين الأفكار التي نظنها صحيحة أو تدفعنا أسبابُنا إلى الظن بصحتها . إنهم يريدون من الآخرين الاعتراف بالخلل المنقي الذي تقوم عليه أفكارنا.
ــــــــــــــــــــــ
مشكلة فلسفية
من ويكيبيديا
المشكلة الفلسفية هي تلك التي تتعلق بالمبادئ (الأصول أو الأسس أو الكليات)، بعكس المشاكل التي تتصل بالجزئيات كالعلمية (أو الدينية، الفنية، الحياتية … الخ)، وتتميز المشكلة الفلسفية في كونها تنقح وتهذب ولا تنتهي إلى حل قاطع كما نرى في المشكلات العلمية وغيرها.
تنطوي المشكلة الفلسفية على بناء وتركيب، أي أنها ينبغي أن توضع في سياق من التصورات التي تختلف عن المشكلة ذاتها. فقد تثار الأسئلة حول أي شيء دون سياق توضع فيه، أما المشكلة فيجب أن تبنى وتركب في سياق، لأنها نتاج تركيب فكري، إنها تنبع عن ارتباط موضوع يعد – ولو مؤقتا – إطارا لإمكان الحل. وبهذا المعنى يمكن أن يقال إن وضع المشكلة يؤذن بحلها. ومن هنا كذلك يمكن أن يقال عن مشكلة ما أنها أسيء وضعها، أي أن وضعها على ذلك النحو لا يؤدي إلى حلها.
إن المشكلة الفلسفية سؤال لم يجد حلاً مقبولاً لدى الجميع، فهي سؤال حي لا يزال يوضع، إنها إذن مفعمة بالحياة. إن المشكلة هي “بؤرة التوتر” التي تؤرق الإنسان، وتحثه على إيجاد الحل، مع أنها ذاتها، أي المشكلة، ليس لها حل، و”البؤرة الأكثر توترا تتجلى في كوننا لا نفكر بعد. دائما ليس بعد، رغم أن حالة العالم تدعونا باستمرار إلى التفكير وتسمح به.” (مارتن هيدجر)
المشكلة: مدخل لغـوي
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: مشكلة
شَكَلَ الأمر يشكُل شَكلاً، أي: التبس الأمر، والعامة تقول شَكَل فلان المسألة أي علّقها بما يمنع نفوذها [1]. وعند التهانوي : “المشكل اسم فاعل من الإشكال وهو الداخل في أشكاله وأمثاله، وعند الأصوليين اسم للفظ يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد منه إلاّ بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال والمشكل ملا ينال المراد منه إلا بالتأمل بعد الطلب” [2]، كما أننا نجد عند الجرجاني، بالإضافة إلى المعنى المذكور عند التهانوي حول المشكل، نجد مفهوم المسائل، وهي عنده : “المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك معرفتها” [3].
أما المشكلة (بالإنجليزية: Problem) كما نجدها في المعاجم الفلسفية فهي : “المعضلة النظرية أو العملية التي لا يتوصل فيها إلى حل يقيني.” [4]، والمعضلة (بالإنجليزية: Dilemma) تعني حالة لا نستطيع فيها تقديم شيء، وهي تفيد معنى التأرجح بين موقفين بحيث يصعب ترجيح أحدهما على الآخر. والمشكلة تختلف عن المسألة في كون الأولى نتيجة عملية تجريد من شأنها أن تجعل “المسالة” موضوع بحث ومناقشة، وتستدعي الفصل فيها. وقد أكد أرسطو هذه التفرقة في كتاب “الطوبيقا” (المقالة الأولى) حين وضع “المشكلة الجدلية” في مقابل “القول الديالكتيكي”، فقال إن المشكلة الجدلية: “هي مسألة موضوعة للبحث، تتعلق إما بالفعل أو بالترك، أو تتعلق فقط بمعرفة الحقيقة إما لذاتها أو من أجل تأييد قول آخر من نفس النوع، لا يوجد رأي معين حوله، أو حوله خلاف بين العلة والخاصة، أو بين كل واحد من هذين فيما بين بعضهم وبعض” [5]، ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي بأن المنطق التقليدي (الأرسطي) لم يعالج موضوع “المشكلة” إلا نادرا، وذلك يرجع إلى كون المشكلة بوصفها من موضوعات ” الطوبيقا “ (الجدل) تنتسب إلى منطق الاحتمال لا إلى منطق اليقين، فهي تدخل في موضوع إفحام الخصم، وبالتالي فهي أقرب إلى الخطابة منها إلى المنطق.[5]
تختلف المشكلة كذلك عن الإشكالية (بالإنجليزية: Problematic) ، حيث أن الإشكالية تعني الاحتمال والحكم الاحتمالي يدرس في موضوع أحكام الموجهات (بالإنجليزية: Judgements of modality) وهي أحكام تتميز بأنها تكون مصحوبة بالشعور بمجرد إمكان الحكم، بينما الحكم التقريري يكون مصحوبا بالشعور بواقعة الحكم. والإشكال عند إيمانويل كانت مرادف للإمكان، وهي مقولة من مقولات الجهة، ويقابله الوجود والضرورة، والأحكام الإشكالية عنده هي الأحكام التي يكون الإيجاب أو السلب فيها ممكناً لا غير، وتصديق العقل بها يكون مبنياً على التحكم، أي مقرراً دون دليل. وهي مقابلة للأحكام الخبرية [6].
ويذكر أندريه لالاند في موسوعته الفلسفية بأن الإشكالية (بالفرنسية: problematique) (ويترجمها مترجم الكتاب بـ : مسألية) هي : “سمة حكم أو قضية قد تكون صحيحة (ربما تكون حقيقية) لكن الذي يتحدث لا يؤكدها صراحة”.[7]
ماهية المشكلـة الفلسفية
تتعلق المشكلة بصورة عامة بالصعوبات المرتبطة بموضوع ما، فإن كانت الصعوبات تتصل بالجزئيات ؛ كانت مشكلة علمية (أو دينية، فنية، حياتية … الخ)، أما إذا كانت الصعوبات تتصل بالمبادئ، الأصول، الأسس، الكليات … الخ فإن ذلك يعني أنها مشكلة فلسفية على وجه التحديد. ومن هنا يمكن القول بأن ” أَمَـارَة “ المشكلة الفلسفية هي أن تتعلق بالمبادئ الكلية. ولذلك فإن أوّل ” مشكلة فلسفية “ ظهرت في تاريخ الفلسفة هي مشكلة ” أصل الوجود “ والتي طرحها طاليس (حوالي 630 – 570 ق.م) حين تسائل عن أصل الكون.
سمات المشكلة الفلسفية وخصائصها
إن أول سمة تميز المشكلة الفلسفية عن غيرها من المشكلات هي أنها تتعلق بالمبادئ أو الأصول الكلية. فالسؤال عن الكل، المبدأ، الأصل، والأساس هو الذي يضع الحد الفاصل بين كون هذا السؤال يعبر عن مشكلة فلسفية أم مشكلة علمية.
تتميز المشكلة الفلسفية كذلك بأنها على درجة عالية من التجريد والبحث النظري. ولذلك ترتبط بمن يثيرها، ولذلك فالمشكلة الفلسفية نسبية، أي تتحدد بالنسبة لمن يطرح السؤال، وتعتمد على مدى قبول أو رفض الآخرين لهذا السؤال.
و يعد السؤال عن الماهية من سمات المشكلة الفلسفة أيضا، وهذه مسألة هامة في نظرية المعرفة على وجه الخصوص. وبشكل عام؛ ترتبط المشكلة الفلسفية بـالقول وليس بالأشياء ذاتها.
العلاقة بين المشكلة والسؤال
يرتبط مفهوم المشكلة بمفهوم السؤال أشد ارتباط، فوراء كل مشكلة سؤال، مع أنه ليس بالضرورة أن يكون وراء كل سؤال مشكلة بالمعنى الفلسفي، وأول من تعرض لمفهوم السؤال وجعل منه قضية فلسفية في كتاباته المنطقية هو أرسطو، ففي كتاب المسائل (باللاتينية: Topica) يقول :” والمسألة (المشكلة) إنما تخالف المقدمة (القضية (بالإنجليزية: proposition)) بالجهة.”[8]
على اعتبار أن الفرق بينهما هو فرق في تحوّل صيغة العبارة، فإذا وضعت العبارة على هذا النحو : ” أليس الحي جنساً للإنسان ؟ “.”[8] كانت مقدمة أو قضية. أما إذا قيل : ” هل قولنا ”الحي” جنس للإنسان أم لا ؟ “ فإن العبارة تكون مسألة.”[8]، أي مشكلة. كما يضيف أرسطو بعد ذلك تمييزا آخر بين المقدمة المنطقية وبين المسألة المنطقية بأن يقول : “والمقدمة المنطقية هي مسئلة ذائعة إما عند جميع الناس، أو عند أكثرهم، أو عند جماعة الفلاسفة … وجميع الآراء أيضا الموجودة في الصناعات المستخرجة قد تكون مقدمات منطقية” [9]، أما المسألة المنطقية فهي “طلب معنى ينتفع به في الإيثار للشيء والهرب منه، أو في الحق والمعرفة؛ مثال ذلك قولنا هل اللذة مؤثرة أم لا.” [10].
الوضع والمسألة
والوضع هو رأي مبدَع لبعض المشهورين بالفلسفة، فالوضع أيضا مسألة، وليس كل مسألة وضعا، لأن بعض المسائل يجري مجرى ما لا يعتقد فيها أن الأمر فيها كذا أو كذا” [11] . وللسؤال أهمية خاصة في الفلسفة، فهو المدخل الأساسي إلى الحكمة، إلى الفلسفة. والسؤال هو الذي يشكل المشكلة ؛ فالمشكلة في نهاية الأمر سؤال يبحث عن إجابة. وقد حظي مفهوم ” السؤال “ بأهمية خاصة في الفلسفة الوجودية، وبوجه خاص لدى هيدجر الذي ذهب إلى تأويله على أنه سؤال عن الكينونة (بالألمانية: Seinsfrage) أو سؤال عن معنى الكينونة(بالألمانية: Sinn von Sein) يعود إلى ماهية الوجود الإنساني [11]
أهلية السؤال
يحدد ديكارت ثلاثة شروط لأهلية السؤال كتمهيد للمعرفة وهي :
ينبغي أن يكون في كل سؤال شيء غير معروف.
أن يكون هذا المجهول معروفا على نحو معين أو إلى حد معين.
أن هذا المجهول لا يمكنه أن يصبح معروفا إلا بواسطة ما هو معروف.
وفي السؤال يتحدد أيضا الفرق بين العلم والفلسفة، فالعلم يطرح السؤال حول ما هو جزئي في الظاهرة التي يبحثها، ولا يبتعد بالمسالة وحلها إلى “الشمول الكلي”، كما هو الحال في الفلسفة، وإنما يظل مقيدا بحدود المسألة كما يجري طرحها ضمن نطاقه الخاص. “إن المشكلة بمثابة سؤال تأزم وتعذر الوصول إلى حل متفق عليه، فإذا كان هذا التأزم على المستوى النظري فيسمى مشكلة، وإذا تعلق بأمور الحياة الإنسانية فيسمى إشكالية، وغالبا ما يتعذر الوصول إلى حل للإشكالية.[12]
يصاغ السؤال في اللغة العربية من جملة خبرية أو إنشائية بإضافة أداة استفهام إلى أولها : ” سقراط معلم أفلاطون.”، ” هل سقراط معلم أفلاطون ؟ ” ؛ ومن أدوات السؤال : هل، لماذا، كيف، لم، لمن، ماذا، متى، من أين، إلى أين … أما في اللغات الأجنبية (الهندو – أوربية) فيصاغ السؤال عادة من خلال عكس الجملة فيأتي الفعل أو الفعل المساعد في أول الجملة.
علاقة السؤال بالجواب
قد يبدو بأن بين السؤال والجواب علاقة تضايف، فبما أن لكل جواب سؤال، فيظن بأن لكل سؤال جواب، ولكن الواقع غير ذلك وهذا يقودنا إلى مسالة الأسبقية المنطقية بين السؤال والجواب، ففي حين تبدأ الفلسفة بوصفها نسق شامل بالجواب، إلا أن النشاط الفلسفي ذاته قد يبدأ بالسؤال أولاً. وقد اعتبر هيدجر السؤال نقطة البداية الحقة في الفلسفة. والسؤال الفلسفي كان دائما يتميز عن باقي أنواع الأسئلة بكونه أعم وأشمل، شأنه بذلك شأن الفلسفة ذاتها واختلافها عن باقي الفروع العلمية الخاصة.
العلاقة بين السؤال والتفكير
كل سؤال لا بد وأن يصاغ بلغة سليمة، واللغة السليمة ترتبط بالتفكير السليم، وبالتالي، ثمة علاقة بين المشكلة (كونها سؤال متأزم) وبين التفكير. يقول هيدجر : “إننا لا نستطيع أن نفكر إلا حينما نحب ما يكون في ذاته” الشيء الذي هو محط عناية ” وحتى نصل إلى هذا الفكر يجب علينا من جانبنا أن نتعلم التفكير … سندعو ما هو في ذاته ” الشيء الذي يعنى به ” ب : بؤرة التوتر. كل ما هو متوتر يسمح بالتفكير. [13]، يقود هذا إلى مسألة الأهمية في السؤال، وبالتالي أهمية المشكلة.
المشكلة والحل
الحاجة إلى حل مشكلة ما هي العامل المرشد دائما في عملية التفكير كما أشار جون ديوي، وراء كل مشكلة رغبة في الوصول إلى الحل، وحل المشكلات ما هو إلا محاولة وضع وتنظيم للمفاهيم لكي تصل إلى الحل المناسب. والوصول إلى الحل يرتبط بشكل أساسي بنمط التفكير المتبع والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص. فمشكلة فيضان النيل على سبيل المثال تم حلها من قبل قدماء المصريين من خلال إلقاء عروس النيل بهدف إرضاء الآلهة، في حين عالج المصريين حديثا ذات المشكلة بتفكير علمي من خلال بناء السدود.
ثمة أمر آخر يتعلق ” بالحل “، وهو السلطة التي يستند عليها ؛ فكان التساؤل عن مصدر الحل هل هو روح الأجداد، أم الآلهة، أم العقل الإنساني. واضح أن هناك علاقة بين مصدر الحل وسلطته من جهة، وبين نوع التفكير المتبع من جهة أخرى.
الأسباب المؤدية لظهور المشكلة
تبدأ الفلسفة عندما نقول شيئا ما، وتبدأ المشكلة الفلسفية عندما نؤكد ذلك “القول”. (كانت)
لكل مجال أو فرع من فروع المعرفة مشكلاته الخاصة، ولكل مشكلة أسبابها المتعلقة بها أيضا، أما فيما يتعلق بالمشكلات الفلسفية، فقد حدد ديكارت أربعة أسباب رئيسية يرى أن المشكلات الفلسفية قد تنشأ بسببها وهي :
الأحكام المبتسرة التي اتخذناها في مقتبل عمرنا.
أننا لا نستطيع نسيان هذه الأحكام المبتسرة.
أن ذهننا يعتريه التعب من إطالة الانتباه إلى جميع الأشياء التي نحكم عليها.
أننا نربط أفكارنا بألفاظ لا نعبر عنها تعبيرا دقيقاً [14]
و تقود النقطة الرابعة بالتحديد إلى مسألة هامة ظهرت في منتصف هذا القرن مع حركة الوضعية المنطقية، وهي مسألة إنكار ورفض معظم المشكلات الفلسفية، بل وكل مشكلات الميتافيزيقا، بحجة أنها لغو فارغ من المعنى.
المشكلات الزائفة في الفلسفة
انطلق أصحاب الوضعية المنطقية في رفضهم لمعظم المشكلات الفلسفية بحجة أنها لغو فارغ من المعنى من معيار التحقق (بالإنجليزية: Verification) والذي وضعه رودولف كارنب (بالإنجليزية: Rudolf Carnap) في كتابه المشكلات الزائفة عام 1966، وخلاصة هذا المبدأ أن كل عبارة لا نستطيع أن ” نتحقق “ منها تجريبيا – أي أن يكون لها مقابل في الواقع – هي عبارة فارغة من المعنى، ولذلك تم إنكار كل قضايا الميتافيزيقا على اعتبار أنه لا يمكن التحقق من عباراتها تجريبيا. كما أرجع لودفيج فتجنشتين، في كتابه “بحوث فلسفية” معظم المشكلات الفلسفية إلى “سوء استخدام اللغة”، وهو يقول في ذلك : “إن المشكلات التي تنشأ نتيجة لسوء تفسير صورنا الخاصة باللغة، تتصف بأنها ذات عمق. إنها اضطرابات عميقة، جذورها ضاربة في أعماقنا بعمق صور لغتنا، ودلالتها كبيرة بنفس قدر أهمية لغتنا.” [15]
ولما كانت المشكلات الفلسفية في نظر فتجنشتين هي مشكلات زائفـة ؛ فهي إذن لابد وأن تزول تماما، طالما أن الهدف الذي نطمح إليه في الفلسفة هو الوضوح الكامل. والوضوح الكامل لا يتأتى إلا بلغة سليمة، خالية من العيوب والأخطاء المنطقية، ومنها التحدث عن أشياء لا يمكن التحقق منها تجريبياً. ولذلك قال فتجنشتين مقولته المشهورة : “إن كل ما يمكن التفكير فيه على الإطلاق، يمكن التفكير فيه بوضوح، وكل ما يمكن أن يقال، يمكن قوله بوضوح.” [16]
إن مشكلة القضايا أو “المشكلات الفلسفية” الزائفة التي أظهر فتجنشتين مفارقاتها الممكنة في المرحلتين المبكرة والمتأخرة من فلسفته، وكذلك الحال مع كارنب وبقية المناطقة الوضعيين، إنما ترتبط أساسا بمشكلة المعنى والصدق، أو مشكلة الحقيقة في العلم الميتافيزيقا[17]. ولذلك ستبقى هذه المشكلات الفلسفية ما بقيت الفلسفة ذاتها بوصفها “مشكلة فلسفية”.
ــــــــــــــــــــــ
وجهات نظر في نظرية المعرفة وطرق اكتشافها

لكن أستاذ الفلسفة في جامعة سترلنغ وأستاذ الابستمولوجيا في جامعة أدنبرة «دنكان بريتشارد» حاول تقديم وجمع أكبر كمية من التجارب و التحليلات ضمن إطار هذه النظرية في كتابه «ما المعرفة؟» الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت, محاولاً تبني بعض وجهات النظر الموضوعية إزاء هذا المفهوم.
إذ ركز اهتمامه على المعرفة الافتراضية من أجل التوصل إلى المعرفة بشأن افتراض معين, بشرط أن يكون ذلك الافتراض حقيقياً, ويعتقد فيه الإنسان, فالاعتقاد الحقيقي لا يكفي وحده للتوصل إلى المعرفة, لأنه رجح أن يكون لدى المرء اعتقاد حقيقي بمحض المصادفة, وتنطوي وجهة النظر هذه على القول إن مجرد الاعتقاد في أن شيئاً ما هو حقيقي بالعموم, لا يمكن أن يجعل ذلك الاعتقاد حقيقياً بالفعل. ليوضح لنا أن أحد الاهتمامات الأساسية للابستمولوجيا «أي ما يعرف بنظرية المعرفة» هو تقديم تفسير لقيمة المعرفة لعدم وضوحها تماماًَ, مبيناً وسائل يمكن أن تتبعها في تفسير قيمة المعرفة, كأن يلاحظ المرء أنه إذا كان يعرف افتراضاً معيناً, فذلك يعني أن لديه اعتقاداً حقيقياً بذلك الافتراض, وتكون للاعتقادات الحقيقية فائدة لا يمكن التغاضي عنها, ولهذا فهي ذات قيمة, غير أن الاعتقاد الحقيقي هو قيمة فعالة إذ إنه يتيح السبيل لتحقيق أهدافنا, لكن هناك مشكلة تواجه هذا الافتراض حيث إنه لا يبدو واضحاً إذا كانت كل الاعتقادات الحقيقية ذات قيمة فعالة, إذ إننا نرى بعض الاعتقادات الحقيقية ترتبط بأمور تافهة بحيث يبدو أن تلك الاعتقادات لا قيمة لها, وفي الوقت ذاته يعتبر أنه من المفيد للمرء أحيانا أن يكون لديه اعتقاد زائف, فهذا أفضل مما لو كان لديه اعتقاد حقيقي حسب رأيه, وحتى لو استطعنا تجاوز هذه المشكلة تبقى عقبة المعرفة من الناحية البدهية, لأن قيمتها تصبح أكبر من مجرد اعتقاد حقيقي, عندئذ علينا أن لا نكتفي بالقول ببساطة إن المعرفة تستلزم وجود اعتقاد حقيقي, أو إن للاعتقاد الحقيقي قيمة فعالة, أما السبل المتاحة للتصدي لهذه المشكلة القول إن للمعرفة قيمة فعالة أكبر من مجرد اعتقاد حقيقي, ما دامت المعرفة أكثر فائدة بالنسبة إلينا «إنها تتيح لنا تحقيق الكثير من أهدافنا بشكل أفضل من الاعتقاد الحقيقي وحده» يتمثل جانب من هذا التفسير بما يطرح في هذا الشأن بملاحظة وجود حالة «استقرار» تمتاز بها المعرفة, وهذا ما يفتقر إليه الاعتقاد الحقيقي وحده, فالمرء حين يعرف حقيقة شيء ما في الواقع فذلك لا يمكن أن يحتمل الخطأ بسهولة, إضافة إلى افتراض آخر طرحه مبني على بعض أشكال المعرفة التي تكون ذات قيمة جوهرية, أي إنها ذات قيمة في ذاتها, أما أهم التساؤلات التي تطرحها الابستمولوجيا, تتعلق بالشيء المشترك الذي يربط بين كل الأنواع المتشعبة من المعرفة التي ننسبها إلى أنفسنا «الجغرافية, اللغوية, الجمالية,الرياضية, الأخلاقية» وغيرها، أكد المؤلف في بحثه أنه من الواجبات الأساسية للابستمولوجيا تقديم تعريف للمعرفة, غير أن مشكلة المعايير التي ينبغي أن تتبع تظهر لنا أن هذه المهمة في واقع الأمر بالغة الصعوبة إن لم تكن مستحيلة, فلو حاولنا أن نبدأ مهمة تعريف المعرفة بأن نشير إلى الحالات التي نحصل فيها على معرفة, ثم نحاول تحديد الأشياء المشتركة في تلك الحالات, نجد أن المشكلة التي ترتبط بهذا المقترح, اننا قادرون مسبقاً على تحديد حالات المعرفة, وبهذا نحن نعرف مسبقاًً ما مؤشرات أو معايير المعرفة, أو على النقيض من ذلك, ربما نبدأ مهمة تعريف المعرفة ببساطة من خلال التأمل في طبيعة المعرفة وتحديد جوهرها, أو بعبارة أخرى, عن طريق التأمل قد نتمكن من التوصل إلى معايير المعرفة, أيضاً هناك مشكلة ترتبط بهذا المقترح, وهي صعوبة إيجاد طريقة تتيح لنا تحديد معايير المعرفة من دون أن نتمكن في بداية الأمر من تحديد حالات محددة للمعرفة, يبدو إذاً أنه يتعين على المرء إما الافتراض أنه قد حصل على المعرفة «أو بعض المعرفة» التي يتصور أنه يمتلكها, وإما يتعين عليه الافتراض أنه يعرف, بمعزل عن التفكير في أي مثال محدد للمعرفة, أو ما معايير المعرفة, ولا يعتبر أي واحد من الافتراضات أعلاه مقبولا أو قابلا للتصديق، ويمكن أن تكون معايير المعرفة بسيطة للغاية, أو بسيطة إلى درجة يغدو فيها من المعقول أن نتمكن بعد شيء من التأمل التوصل إليها من دون التطرق إلى حالات محددة للمعرفة، يقول بريتشارد: «إذا أردنا أن نعرف تركيبة المعرفة يتوجب علينا بدايةً طرح تبرير لما نعتقد به» أي ما الذي يمكن أن يبرر هذا الاعتقاد, فطرح لنا سؤال عن ماهية التبرير وفق معضلة الفيلسوف الإغريقي «أغريبا» والتي لخصها بثلاثة بدائل فقط يمكن أن تطرح في هذا المجال, وأي واحد من هذه البدائل لا يبدو مفيدا على وجه التحديد, البديل الأول أن ننظر إلى اعتقاد المرء على أنه غير مبرر بأي شيء مطلقاً, أو أنه لا يستند إلى شيء آخر, المشكلة التي تعترض هذا الاختيار تبدو واضحة, لأنه في حال عدم وجود شيء يدعم الاعتقاد, كيف يمكننا أن نقول عنه إنه اعتقاد مبرر, البديل الثاني أن ننظر إلى الاعتقاد على أنه مبرر بدليل آخر, وهذا الدليل على ما يبدو سوف يكون ذاته عبارة عن اعتقاد آخر, المشكلة في هذا الاقتراح أن ذلك الاعتقاد الآخر سوف يحتاج هو أيضاًَ إلى تبرير, فإذا كان الاعتقاد الأصلي يستند إلى اعتقاد آخر غير مبرر فمن الصعوبة أن نستوعب كيف يمكن للاعتقاد الثاني أن يدعم الاعتقاد الأول, إذا كان الاعتقاد الثاني يحتاج إلى تبرير, فذلك يعني أنه هو أيضاً سوف يحتاج إلى إسناد من اعتقاد إضافي, وهنا نحتاج سلسلة من التبريرات, أما الثالث بخصوص إسناد الاعتقادات في مرحلة معينة من سلسلة التبريرات تظهر اعتقادات سبق أن وردت في مكان آخر من السلسلة, وهذا الاختيار يفسح المجال لظهور سلسلة دائرية من التبريرات, يظهر فيها الدليل المساند أكثر من مرة. هنا أراد الكاتب من هذا اللغز أن يوجهنا على الطرق المختلفة التي تتشكل بها المعرفة, معتمداً على أنواع محددة هي «اللامحدودية, الترابطية المنطقية, التأسيسية» وكلها مستوحاة من النظريات الابستمولوجية.
كما عدّ المؤلف أن أي شخص توصل إلى الحقيقة بمحض المصادفة أو الحظ, لا يمكن اعتباره حاصلاً على المعرفة, لأن المعرفة انجاز إدراكي «فإن توصل اعتقادك عن طبيعة طقس الغد من خلال رمي قطعة نقدية (طرة ونقش, صيف وشتاء) وحتى لو اتضح لاحقاً أنك أصبت واعتقادك صحيح, فهذا لا يعني أنك تعرف, لأنك توصلت إلى الاعتقاد الحقيقي اعتماداً على حسن الحظ فقط, وبمحض المصادفة, وليس بطريقة إدراكية ونحن بحاجة إلى طريقة موثوق بها» والمقصود «بالموثوق» أنه على أقل تقدير أن تكون الطريقة التي تستخدم توصلنا إلى الحقيقة, وهنا يبدو أن هناك شيئاً من العقلانية في فكرة الموثوقية التي تنص على أن المعرفة هي بالأساس اعتقاد حقيقي يتم التوصل إليه بطريقة موثوق بها, لكن هناك مشكلة تعترض وجهة النظر هذه أننا إذا فهمنا تلك الفرضية ببساطة على أنها تتضمن اعتبار المعرفة اعتقاداً حقيقياً موثوقاً به فإننا عندها سنواجه عدد من المشكلات الخطرة, أهمها أنه من الممكن التوصل إلى اعتقاد حقيقي بطريقة موثوق بها, ومع ذلك ربما يكون الأمر مرتبطاً بالحظ الذي يقوض المعرفة أحياناً, لذلك فهذه الموثوقية قد لا تفيدنا في تمييز المعرفة الأصلية المميزة التي تنطوي على إنجاز إدراكي ينسب إلى المرء عن غيرها من الانجازات الإدراكية التي تتحقق بفعل الحظ ليس إلا, والتي لا يمكن اعتبارها من حالات المعرفة، مع كل ما ذكرناه إلا أن هناك شيئاًَ من الصواب بشأن الفكرة الموثوقية لأنها تنص على أن المعرفة ينبغي أن تكتسب ضمن سياق هدفه التوصل إلى الحقيقة, إن السمة البارزة على أي حال التي تميز التفسير القياسي للتبرير الذي تحدثنا عنه هي أنه بإمكان المرء التوصل إلى اعتقاده الحقيقي المبرر بطرق لا تميل بأي شكل من الأشكال باتجاه الحقيقة, وعلينا أن نكون حذرين من استبعاد مقترح الموثوقية بالكامل، الجزء الثاني من الكتاب خصصه الباحث لتعريف القارئ بمصادر المعرفة والتي لخصها بالإدراك الحسي من خلال اعتمادنا على قدراتنا الحسية «النظر، السمع، اللمس» والمعرفة التي نستمدها من تجارب الآخرين, مع تحذيرنا من الخداع الذي يمكن أن تمارسه علينا تلك الحواس «كالانحناء الذي يصيب العصا عندما ندخلها الماء», أما بالنسبة للمعرفة التي نستمدها من شهادة الآخرين فقد أكد ضرورة أن نكون قادرين على تقديم إسناد لا يعتمد على الشهادة فقط, بل يتوجب علينا أن نقدم تبريراً لا يتخذ شكل سلسلة دائرية لاعتقادنا التي تستند إلى الشهادة, أو ما أطلق عليه «الاختزالية», في النهاية نجد أن كل الأفكار, والدلائل التي قدمها لنا الكاتب, كان يعود ليدحضها بوجهات نظر منطقية ليوصلنا في النهاية إلى نظرة واقعية حول ماهية المعرفة.
قدّم المؤلف في نهاية بحثه مقترحات للقراءة حول المعرفة من كتب مرجعية في الفلسفة, ومجموعات ضخمة من المقالات التي تابعت آخر المستجدات بشأن جميع مجالات الابستمولوجيا, إضافة لبعض الكتب المنهجية, ومختارات من مجموعات تغطي الموضوعات الأساسية حول المعرفة وبعض القراءات الكلاسيكية والمعاصرة حول نظرية المعرفة, وبعض وجهات النظر الفلسفية, ومختارات خاصة من مواقع الانترنت تتعلق بالموسوعة الرئيسة للفلسفة, إضافة لملحق خاص بالمصطلحات والأمثلة الرئيسة التي مرت خلال البحث.

























 روشاك أحمد
روشاك أحمد