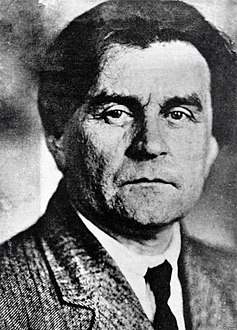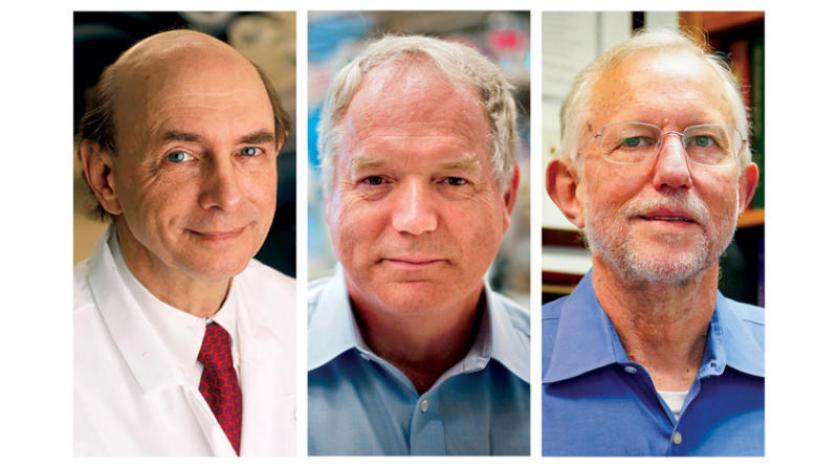شبه جزيرة القرم جذبت كبار الأدباء الروس وتركت فيهم أثرا (1-2)
تولستوي وتشيخوف وبونين وبوشكين وغوركي أبدعوا بين جنباتها أعمالاً باهرة
شبه جزيرة القرم في منظر عام (غيتي)
لا أحد يستطيع تصفح أو مطالعة ما جادت به مواهب عظماء الأدب الروسي من نجوم القرون الفائتة، من دون إشارة أو حديث عن شبه جزيرة القرم التي طالما عاش هؤلاء بين جنباتها منذ دانت للإمبراطورية الروسية في نهايات القرن الثامن عشر. في حياة كل أمة وشعب ودولة توجد الأماكن التي تحظى بإعجاب أبرز رجال الفكر والثقافة وتقديرهم بوصفها أكثر المواطن مبعثاً للإلهام والإبداع، بما تملكه من سبل تأثير في النفس، طبيعةً كانت أو تاريخاً. من هنا كان ارتباط أسماء العظام بهذه البقعة الساحرة من أراضي الوطن، ممن تباينت أسباب أومبررات التواجد بين جنباتها، اضطراراً كانت هذه الأسباب، أو عن إرادة وسبق إصرار، سعيا ًوراء مناخ مناسب للصحة، أو استجابة لفضول ورغبة في التجديد، أو بحثاً عن موطن بديل، بما كادت تكون فيه القرم القاسم المشترك الأعظم للكثير من مؤلفاتهم وإبداعاتهم.
ظلت شبه جزيرة القرم واحدة من أبرز هذه المواطن، بما حباها الله من أجواء فريدة ساحرة، وطبيعة خلاُبة تتميز بها عن سائر مناطق الدولة الروسية المترامية الأطراف، المتباينة المناخ والطبيعة. هذا ما تبدى واضحاً في ما تركه الأسلاف من آثار أدبية وفنية في سنوات تاريخها الذي يمتد قروناً طويلة مضت. وشاءت الأقدار، وتعرجات التاريخ وتضاريس الجغرافيا، أن تكون هذه البقعة الساحرة الواقعة بين أحضان البحر الأسود، مصدر إلهام كل من قصدها، وكانوا كُثُراً من أهم وأشهر رموز الآداب والثقافة والفنون، ممن تفتحت مواهبهم وذاع صيتهم بما سجلوه من إبداعات، تجاوزت حدود ذلك الزمان وهذا المكان. من هؤلاء كان ليف تولستوى شيخ الأدب الروسي والعالمي، وألكسندر بوشكين أمير شعراء روسيا ومؤسس “لغتها الحديثة”، وأنطون تشيخوف الذي حظي بكنية “أمير القصة القصيرة”، وإيفان بونين أول الفائزين من بني جلدته بجائزة نوبل للآداب، وفلاديمير ماياكوفسكي “شاعر الثورة” الذي انتحر كمداً على إنجازاتها وما آلت إليه في ثلاثينيات القرن العشرين، وكثيرون ممن ارتبطوا بهذه البقعة الساحرة من الأراضي الروسية ذات التاريخ الزاخر بمختلف التقلبات.
نستهل القائمة بألكسندر بوشكين الذي وصل هذه المنطقة مرغماً، طريداً ملاحقاً من سلطات الإمبراطورية، لتمرده وانتقاداته ما ساد البلاد من أوضاع، وما لحق بها من متاعب، ما أثار حفيظة القيصر الذي اتخذ قراره بنفيه إلى جنوب البلاد. ولكم صادف القرار توفيقاً سرعان ما أوتي أُكله وثماره، في ما جادت به قريحة الشاعر والأديب الشاب من دُرَر أدبية وأشعار لا تزال تحظى بعظيم الاهتمام. في القوقاز ظهرت قصة “أسير القوقاز”، وفي القرم صدحت أشعار “نافورة باختشي سراي” وما تلى ذلك من قراءات وقصائد وملاحم شعرية منها “يفجيني أونيجين”، التي عكست اهتمامه وولعه بالثقافة العربية، وبمجمل تاريخ الشرق، جلياً في إنتاجه في وقت لاحق من حياته الأدبية التي لم تدم طويلاً، إذ قضى نحبه في مبارزة “تقليدية” من مبارزات ذلك الزمان، ولم يكن بلغ من العمر أكثر من 38.
شيخ الأدباء الروس
نمضي مع الإبداع ورموزه لنتوقف عند شيخ الأدباء الروس ونجم الحياة الأرستقراطية الذائع الصيت، الأديب العالمي ليف تولستوي. لم يخلُ تاريخ ذلك الاقطاعي الأرستقراطي من صلة أو اتصال بمثل هذا الموقع المتفرد في تاريخ الإمبراطورية الروسية والمنطقة. يذكر التاريخ ذلك الصراع الذي احتدم بين الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية، وما اسفرت عنه مخططاتهما التوسعية من صدامات ومواجهات. في ظل هذه الأجواء شدّ ليف تولستوي الرحال إلى هناك، واحداً من جنود جحافل الإمبراطورية التي دفع بها قيصر روسيا نيكولاي الأول إلى القرم في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1854. تقول المصادر أن تولستوي النبيل سليل العائلة الإقطاعية، اختار التطوع ضابطاً بالمدفعية للدفاع عن سيفاستوبول التي تظل حتى اليوم أهم قواعد الأسطول البحري الروسي على ضفاف البحر الأسود. هناك شاهد الضابط الشاب تولستوي ما عاشته المنطقة من ويلات المعارك ومعاناة الحصار، وما حفلت به قصص التضحيات من تفاصيل، وما انتهت إليه تلك الحرب من هزائم منيت بها قوات الإمبراطورية الروسية.

كان ذلك، أو بعضه ممّا أودعه تولستوي الكثير من قصصه وروايته التي اختار لها عناوين “سيفاستوبول ديسمبر1954″، و”سيفاستوبول مايو 1855″، وسيفاستوبول أغسطس 1855”. لم تكن كل تلك القصص سوى تسجيل فريد النمط لما عايشه من وقائع وأحداث، استند في الكثير منه إلى معايشة يومية ومشاركة وجدانية، ساهمت بدرجة كبيرة في إيجاز ما خلص إليه من أسباب عزاها في مجملها إلى تخلف روسيا وحاجتها إلى التغيير. وهذا ما تحقق بعضه خلال سنوات معدودات بعد انتهاء الحرب، حيث اتخذ القيصر ألكسندر الثاني مرسومه حول إلغاء القنانة، أو نظام العبودية عام 1861، فيما جاءت الإمبراطورة كاترينا الثانية لتستكمل المسيرة وتعد العدة للانتقام واستعادة ما ضاع من انتصارات.
لم تمضِ سوى سنوات معدودات حتى اكتملت استعدادات جيوش الإمبراطورية، لتعود إلى ساحة معارك الأمس ولتسجل نجاحها في تعويض ما لحق بروسيا من هزائم في حرب القرم الأولى (1853-1856). خلال الفترة التي لم تمتد إلى ما هو أبعد من 1877-1878 استطاعت جيوش الإمبراطورية استعادة شبه جزيرة القرم التي عاد إليها تولستوي مريضاً مرافقاً أحد أصدقائه وفي حاجة إلى الاستشفاء في أجوائها المتميزة، قبل زيارته الثالثة والأخيرة لها في 1901-1902، التي بدأ خلالها كتابة روايته المعروفة “الحاج مراد” وسجل فيها الكثير الكثير من أحداث الصراع في منطقة القوقاز وتطوراتها. يقول شاهدو العيان إن علاقات تولستوي توطدت على أرض شبه الجزيرة مع الكثيرين من أدباء ذلك الزمان وفي مقدمهم تشيخوف وغوركي وكوبرين ممن كان يقضي معهم أمسيات طويلة، يستمتع خلالها بما يجودون به من أقاصيص وحكايات عن هذه البقاع اتخذها بعضهم وأولهم أنطون تشيخوف موطناً ومحل إقامة.
قصة تشيخوف
يسلمنا ذلك إلى قصة ارتباط “أمير القصة القصيرة” أنطون تشيخوف، بهذه البقعة المتميزة من أرض الوطن، هو الطبيب الذي ذاع صيته ليس من خلال ما حقق من إنجازات في عالم الطب والجراحة، بل من إبداعاته في عالم القصة القصيرة بكل موضوعاتها التي يرتبط الكثير من تفاصيلها بهذا المكان. وكان تشيخوف اختار شبه جزيرة القرم في بداية زياراته لها كمجرد موقع موسمي يلجأ إليه وراء علاج ما يعانيه من متاعب صحية تتعلق بسلبيات مناخ موسكو وسان بطرسبورغ، إلًا أن ما شاهده ولمسه من مميزات المكان ساهمت في التخفيف من حدة ما يعانيه، وفي اتخاذ قراره حول استيطانه مقراً دائماً لإقامته، سرعان ما كان مقصداً لأصحابه ورفاقه من أبرز رموز الأدب والفن والثقافة. لعل ما تركه تشيخوف من إنتاج أدبي يقول إن شبه جزيرة القرم كانت مصدر إلهامه الرئيس، بما ظهر جلياً في نتاجه من شخصيات ومواقف تتجسّد بشكل أكثر وضوحاً في عدد من مسرحياته، منها “الأخوات الثلاث”، قصة “السيدة صاحبة الكلب”، التي سجل فيها الكثير من ملامح حياة المصطافين في منتجع يالطا ذات الشهرة التاريخية.

لعل الإقامة الدائمة لأنطون تشيخوف في القرم، وما أودع من تفاصيل الكثير من أبداعاته، كان في مقدمة الأسباب التي دفعت الكثيرين من أقرانه ورفاقه إلى أن يتقاطروا إلى هذا المكان، الذي سرعان ما تحول إلى “بوتقة أدبية”، انصهرت فيها الأفكار والمشاعر لتقدم للبشرية أفضل نماذج الآداب والفنون. من هؤلاء، ألكسندر كوبرين الصحافي الذي لم يكن ذاع صيته بعد، أو عرفه كثيرون في عوالم الأدب والثقافة. قال كوبرين إن زياراته وتردده على تشيخوف ومنتدياته الفكرية ساهمت في تعرفه على مكسيم جوركي وإيفان بونين وآخرين من نجوم ذلك العصر. وكان التفاعل الذي حفّز اهتمام ذلك الصحافي المتميز ودفعه إلى محاولة استيعاب مفردات المكان ليجول في أنحاء شبه الجزيرة، يلتقط بحواسه ما نطالعه اليوم من إبداعات قصصية صاغها حول حياة الصيادين اليونانيين، وأنماط الحياة المتباينة الأشكال والأطياف ليتحول معها وبها إلى واحد من أشهر أدباء ذلك الزمان. وما إن دانت له الحياة بين ربوع القرم، شان صديقه أنطون تشيخوف، حتى اتخذ قراره باستيطان المكان بين جدران مسكن حرص على اختيار موقعه وبنائه بنفسه. من واقع تجاربه واختلاطه مع سكانه على اختلاف مشاربهم وما يتقنون من حرف ومهن ساهمت في تحديد ملامح وأنماط حياتهم، وُلدت روائع كوبرين وقصصه الكثيرة، منها “في السيرك”، “الجرو الأبيض”، “الجبان”، “منظر من مرتفعات أي بيتري” وغيرها من القصص القصيرة والروايات.
مكسيم غوركي “المر”
تضم قائمة المغرمين من أدباء روسيا بشبه جزيرة القرم وطبيعتها الخلابة مكسيم بيشكوف المعروف بكنيته التي اختارها لنفسه “مكسيم غوركي” وتعني “المر” في إشارة الى ما عايشه من معاناة، وكابده من آلام. قصد غوركي شبه الجزيرة بحثاً عن الرزق في عام 1891. قطعها طولاً وعرضاً، يتلمس السبيل والوسيلة ليقيم أوده. اشتغل في تشييد أحدى الكنائس في عاصمة القرم سيمفروبول، غير بعيد عن باختشي سراي التي كان تغنى بها أمير شعراء روسيا ألكسندر بوشكين في رائعته “نافورة باختشي سراي”. ومن العمالة بين فرق تشييد الطرق والشوارع، توجه إلى يالطا على شاطئ البحر الأسود بحثاً عن مكان بين عمال تفريغ السفن والبواخر في ميناء المدينة. تراكمت الحكايات والانطباعات التي سرعان ما أودعها قصصه ورواياته.
نقل ما عايش واستمع إليه من أساطير وحكايات، دارت وقائعها بين جنبات المكان المتفرد طبيعة وتاريخاً. يقولون في هذه المناسبة إن غوركي الذي كان هجر المكان ليستوطن جزيرة كابري غير بعيد من نابولي جنوب إيطاليا، استلهم الكثير من الأفكار والمشروعات التي طرحها على قيادات ثورة أكتوبر الاشتراكية لتحويل يالطا الى منتجع ومصح لعموم الاتحاد السوفياتي، وهو ما حققته القيادة الحزبية آنذاك، وما عاد بوتين إلى تطويره وتحديثه بعد إعلانه عن ضم القرم إلى روسيا في مارس (آذار) 2014 بعد فترة لم تدم طويلاً ضمن تبعية أوكرانيا من 1954 حتى ذلك التاريخ.
أول نوبل
نصل إلى إيفان بونين أول من حصل على جائزة نوبل للآداب بين أدباء بلاده في عام 1933. لعبت شبه جزيرة القرم الدور الأعظم في موهبته وما حباه به الله من قدرات إبداعية وفنية. جاءها شاباً يافعاً في الثامنة عشرة. عام 1989 وصل إلى ميناء سيفاستوبول، في مستهل حياته الصحافية، مغرماً بما كتبه بوشكين عن القرم، محملاً بأعباء حكايات أبيه عما كابده من آلام خلال مشاركته في معاركها. بين جنبات مقر أقامته في يالطا ضيفاً على صديقه أنطون تشيخوف، كان بونين يستمتع بكل ما يجود به المكان ليس فقط مأكلاً ومشرباً، بل، بما يستخلصه من أفكار من وحي مناقشات المنتديات الفكرية التي كان يتابع وقائعها هناك. أضافت الطبيعة بما تميزت به عن أنحاء روسيا، ما استطاع أن يستخدمه للتميّز به عن نظرائه من أدباء وشعراء الوطن. في قصائده “النبيذ” و”أشجار السرو”، و”السباحون” وغيرها من مجموعة قصائد القرم، الكثير من النماذج والأمثلة التي كشفت عن موهبة وقدرات أدبية متميزة، حملته إلى مصاف عظماء جائزة نوبل للأدب.
للقصة فصول أخرى، منها ما يتعلق بإنتاج ألكسندر غرين، ورائعته “الأشرعة الحمراء”، وفلاديمير ماياكوفسكي شاعر الثورة بكل أتراحه وأحزانه التي قادته إلى النهاية المؤلمة، فضلاً عن سيرة صاحب الريشة المتميزة إيفازوفسكي وأعماله، وغيره من فناني ذلك العصر وأدبائه.




















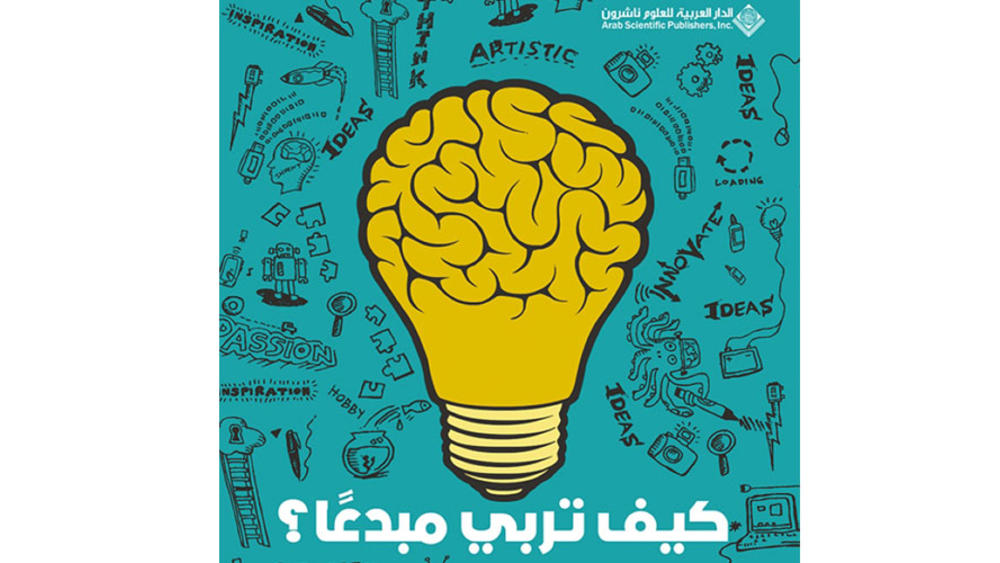
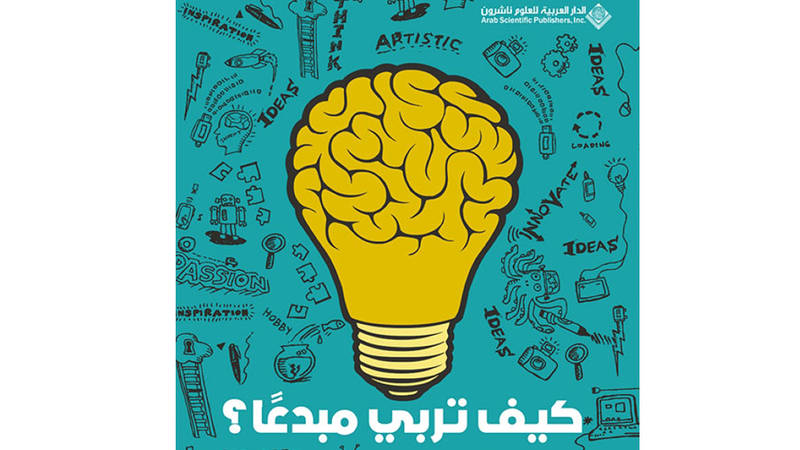









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)