أبو فراس الحمداني
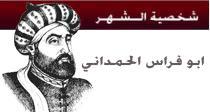
شاعرية أبو فراس:
تفتّقت شاعرية أبي فراس منذ صباه، فنظم الشعر مبكراً، وبرزت إرهاصات النضج الفني في شعره ولا فرق في ذلك، فقد كانت الأرضية مهيأة لتخلق منه شاعراً أصيلاً، يتمه وهو صبي وعناية أمه به، ونشأته في بلاط الأمير، ونسبه العريق وبيئته وموهبته وأسره... كّلها عوامل كانت كفيلة ليصبح أبو فراس أشعر الشعراء، على الرغم من أن الشاعر لم يشأ أن يكون شاعراً لغرض مدح الأمراء وكثيراً ما نفر أميرنا من لقب المستجدين، فقال بعد أن بين أنه ينظم الشعر في مفاخره ومفاخر أبائه، وأّنه في نفسه غاية لا وسيلة، وبلسماً يداوي به كلومه وقد أغناه الله عن السؤال بعزة الملك، ونعيم الدولة، فلم يصطنع المدح ولا الهجاء وإّنما مدح قومه من باب الفخر يقول: نطقت بفضلي وامتدحت عشيرتي ..|.. فما أنا مداح ولا أنا شاعر
والحق يقال، أن الشعر في الأمراء صفة ثانوية لا يعول عليها ولكن أبا فراس انفرد بشعره ليكون لسانه الفصيح وترجمانه البليغ في كلّ الميادين وإلا كيف يعبر عن فخره بنفسه وقومه ومديحه لسيف الدولة الحمداني ورثائه لأمه والكثير من أحيائه وغزله ووصفه لربوع البقاع التي عاش فيها والطبيعة التي كانت تحيط به بنوعيها الصامتة والحية ومجالس الأنس والترف... ولا غرابة في ذلك فهو الأمير والأسير في نفس الوقت بقدر ما عاش رغد الحياة عاش كذلك جور الزمن وجفاء الخلان... وهي ازدواجية قلما نجدها في الشعر العربي ولعل الحديث سيقتصر على الفترة التي قضاها وهو رهين الأسر لأنها فترة تستحق الوقوف، وتختلف جذرياً من فترات الحرية التي عاشها الأمير وتمتع فيها برغد الحياة، فمرحلة الأسر هذه تشد الانتباه وتثير التساؤل لما تميزت به من أهوال ومآسي، وكلوم، تتخللها عواطف القوة واللين.
الروميات:
بلغت روميات أبي فراس، زهاء خمس وأربعين قصيدة ومقطوعة، صور فيها حالة أسره ونفسيته المنكسرة وآلامه وجراحه، وحنينه إلى أهله وأمه، وطلب الفداء من سيف الدولة، وعتابه إلى بعض أصدقاءه، وافتخاره بماضيه، فكانت أشبه بسجل عّذاب وديوان نفس بائسة متمردة تعيش القلق، والانتظار، وتحب الحرية شأنها في ذلك شأن بقية المخلوقات.
وبهذا استطاعت أن تتميز عن باقي الأشعار، وتضع لنفسها طابعاً فريداً وذوقاً خاصاً يتلذذها القارئ والسامع معاً، ونالت رومياته شهرة واسعة جعلت الأدباء يتحدثون عنها بإسهاب كبير فقد روي ابن خالوية «بأن أبا فراس نفح الشعر العربي برومياته التي نظمها، وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل، يرشح بصدق الإحساس، والتصوير الواقعي، والشكوى والتألم، وهذا اللون هو الذي ضمن له الخلود الأدبي»، واعتبرها القيرواني «قصائداً لا تناهض ويصعب الإتيان بمثلها»، ولا عجب في ذلك، فلقد كان الألم ينطق الشاعر، بل ينطق الأمير الأسير، فيرسل أشعاراً عذبة رقيقة تتنازعها عواطف شتى، عاطفة افتخار وإجلال، وعاطفة اعتصام وآمال وعاطفة شكوى وآلام ولهذا جاءت متسمة بالشعور الأليم والحنين إلى الوطن، وقد لا يستطيع ناثر أن يشرح ما فيها من العواطف فهي من أرق أشعار أبي فراس، وقد مهرت الأدب نوعا مميزاً من الشعر الوجداني.
ولم يكن وصف الأدباء لروميات أبي فراس من باب المجاملة أو المبالغة، وإنما هي الحقيقة، فقد عبر الشاعر عن نفسه التواقة إلى الحرية والسكينة، خالية من الأميال الحادة الجبارة، لأن الألم لم يضعف منها بل زادها إباء وصبراً وجمالاً وإن هو اتخذ التغني كوسيلة للتعبير عن جراحه فهو غاية في حدِّ ذاته يحمل دلائل الصبر على البلاء، والاستعطاف لأجل الفداء، والحنين إلى الأم والأحباء، والتفريج عن عقدة الأهواء.
كان إذن صادقاً في تعبيره، مستجيباً لسجتيه، مسترسلاً في أقواله ويشهد له بجودة رومياته وما اشتملت عليه من صدق العاطفة، وإيحاء الألفاظ، ورصانة الأسلوب، وحسن السلوك، وهي الخصائص التي جعلته يستوي عرش الوجدانيات، ويحتل مكانة رفيعة بين شعراء العصر العباسي، أو كلّ العصور ولعّلها عوامل تضافرت لتخلق هذا النَفس المُميز وهذا اللون الرائع من الشعر العربي الأصيل، اللون الباكي الحزين، وقد يكون هذا الحزن والأنين من جراء الأسر هما اللذان ضمنا خلود الروميات، فانفردت بطابع خاص واصطبغت بألوان الحضارة والثقافة والطبيعة وفي هذا المعنى يقول سامي الكيلاني: «إن جمال الروميات واختلاط أبي فراس بالقياصرة، ورؤيته آثار العمران، ومطارف النعيم... وما إلى ذلك مما هو أقرب إلى الحضارة منه إلى البداوة كان من الوسائل التي أنضجت شاعريته الخصبة بمعاني الوحي والآلام».
وربما هذه الألوان نادرة جداً في الروميات، إذ اكتفى الشاعر بتصوير حالته النفسية وما تشتمل عليه من حنين وشوق، وألم وشكوى وصبر وتجّلد، سعياً وراء خير الوطن وطلبا في الحرية، فالألم بنوعيه النفسي والجسدي، هو مصدر روميات الشاعر، وهو الذي أكسبها صبغة جمالية فريدة، وبعداً نفسياً عميقاً، فجعلها تتنوع تنوع نزعاته النفسية من فخر وحنين إلى مناجاة وصبر، وأنين «فيها لنفسه ذكرى وحرقة ولهب ولأمه تعزية وعبره، ولأصدقائه وأنسابه شوق وتحنان».
ولكننا أينما تطلعنا، رأينا وجه الشاعر مفاخراً بنفسه وقومه، متحملاً للصعاب، غير مستسلم للقدر ثابتاً، صامداً جامعاً بين عزة النفس ونخوة العروبة ومن أمثلة ما قاله وهو جريح:
وقد عرفت وقَع المسامير مُهجتي وشُقق عن زُرقي الَنصول إهابي
وعندما نقل إلى خرشنة أسيراً، قال مواسياً نفسه:
إنْ زُرْتُ خَرْشَنَة أسِيرَاً ..|.. فَلَكَمْ أحَطْتُ بها مُغِيرا
وَلَقَدْ رَأيْتُ النّارَ تَنْـ ..|.. ـتَهِبُ المَنَازِلَ وَالقُصُورَا
وَلَقَدْ رَأيْتُ السّبْيَ يُجْ ..|.. ـلبُ نحونا حوَّا، وحورا
نَخْتَارُ مِنْهُ الغَادَة َ الْـ ..|.. حسناءَ، والظبيَ الغريرَا
إنْ طالَ ليلي في ذُرا ..|.. كِ فقدْ نعمتُ بهِ قصيرا
ولئنْ لقيتُ الحزن فيـ ..|.. كَ فقدْ لقيتُ بكِ السرورا
وَلَئِنْ رُمِيتُ بِحادِثٍ، ..|.. فلألفينَّ لهُ صبورا
صبرا ً لعلَّ اللهَ يفـ ..|.. تحُ بعدهُ فتحاً يسيراً
منْ كانَ مثلي لمْ يبتْ ..|.. إلاّ أسِيراً، أوْ أمِيرا
لَيْسَتْ تَحُلّ سَرَاتُنَا ..|.. إلا الصدورَ أو القبورا
ويترّفع أبو فراس عن ذلِّ القيد وتحضره إمارة المجد المؤثل فيجمع بين شاعرية اللغة، وفروسية الميدان، ليرسم لنا صورته الحربية أيام أغار على خرشنة فأحرق القصور وسبى الحور... فلا بأس إذن أن يؤسر فيها، وإّنه على ذلك لصبوراً إما أسيراً أو اميراً.
هكذا يحاول الشاعر أن يخفي مشاعره فيتظاهر بالاعتصام ويفخر بحسن المقام، ولكّنه لم يكن يعلم أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن أمر الفداء لا يزال عسيراً، فراح يطلب الفداء من سيف الدولة، وللمرة الأولى معتقداً أن نداءه سيُلبى وأن الأمير سيف الدولة لن يتخلى عنه، يقول في داليته الرائعة:
دعوُتك للجفْنِ القريح المسهد ..|.. لديَّ وللّنوم القليل المشردِ
وما ذاك بخْلا بالحياة، وإنَّها ..|.. لأولُ مبذولٍ لأول مجتد
وما الأسر مما ضقتْ ذرعا بحمله ..|.. وما الخطْب مما أن أقول له: قدي
..ولكنني أختار موت بني أبي ..|.. على صهوات الخيل غير موسد
وتأبى وآبى أن أموت موسدا ..|.. بأيدي النصارى موت أكْمد أكْبدِ
نضوت على الأيام ثوب جلادتي ..|.. ولكّنني لم أنْض ثوب التجّلُد
..دعوتك، والأبواب ترتج دوننا ..|.. فكُن خَير مدعو وأكرم مُنْجد
ويزداد الشاعر تألماً، ومرارة وتأبى نفسه القوية أن تتذلل فينتفض انتفاضة فخر واعتزاز وهو فخر -لا شك في صدقه- كما قال الدكتور شوقي ضيف: «يمتلأ فخره بالحيوية، لأنه يصور واقعاً لا وهماً من أوهام الخيال».
ولا غرو أن يتحلى أبو فراس بهذه المزيا، فهو الأمير الأسير الذي جمع المجد من أطرفه، فكيف يضحي بإمارته وما يتبعها من صفات العز والأنفة والإباء، وكيف يستغني عنه قومه والظلمة تحتاج إلى البدر، يقول:
سيذكرني قومي إذا جد جدهم ..|.. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
ولو سد غيري ما سددتُ اكتفوا به ..|.. وما كان يغلو الّتبر لو نفق الصفر
ويزداد فخر أبو فراس الحمداني لما بلغه أن الروم قالوا «ما أسرنا أحداً لم نسلب ثيابه غير أبي فراس» فقال:
يمنُّون أن خّلو ثيابي وإّنما ..|.. علي ثياب من دمائهم حمرُ
قائم سيفي فيهم اندق نصله ..|.. وأعقاب رمحي فيهم حُطم الصدرُ
وعلى الرغمَ من تنكر سيف الدولة له، وصمت قومه عنه، فإنه لا ينسى أنه الأمجد بن الأماجد وأّنه ثمرة طيبة لشجرة عريقة، وأّنه من قوم كرام يفضلون الموت على الذل والهوان، يقول في ذلك:
ونحن أناس لا توسط بيننا ..|.. لنا الصدر دون العالمين أو القبر
تهون علينا في المعالي نفوسنا ..|.. ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر
أعز بني الدنيا واعلى ذوي العلى ..|.. وأكرم من فوق الّتراب ولا فخر
ويفتخر كذلك في مناظراته مع دمستق الروم، عندما قال له: أنتم كتاب أصحاب أقلام، ولستم أصحاب سيوف، ومن أين تعرفون الحروب، فقال له أبو فراس: نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام، وأجابه بقصيدة مطلعها:
أتَزْعُمُ، يا ضخمَ اللّغَادِيدِ، أنّنَا ..|.. وَنحن أُسودُ الحرْبِ لا نَعرِفُ الحرْبَا
فويلكَ؛ منْ للحربِ إنْ لمْ نكنْ لها ؟ ..|.. ومنْ ذا الذي يمسي ويضحي لها تربا؟
ومن ذا يقود الجيش من جنباته ..|.. ومن ذا يقود العين أو يصدم القلبا
وويلك من أردى أخاك بمرعشٍ ..|.. وجلل ضربا وجه والدك العصبا
وويلك من خّلى ابن اختك موثقا ..|.. وخلاك "باللقان" تبتدر الشعبا
أتوعدنا بالحرب حتى كأّننا ..|.. وإياك لم يعصب بها قلبناعصبا
ليصل إلى قوله:
بأقلامِنَا أُجْحِرْتَ أمْ بِسُيُوفِنَا؟ ..|.. وأسدَ الشرى قدنا إليكَ أمِ الكتبا؟
وهذه القصيدة مفخرة للحمدانيين، حاول الشاعر بها أن يسمو بقبيلته ذرى المجد ويحطّ من قيمة الروم معّللاً ذلك بذكر أسماء قوادهم، ومواقعهم، غير مبالٍ بالوضعية التي هو عليها ... هي إذن روح القبلية تجري في عروقه وعنفوان الشباب يملي عليه عباراته.
ولكن الوطأة زادت بشدة على أبي فراس، فامتدت غربة الشاعر سنوات، واضطربت روحه النبيلة في نفس ظن صاحبها أنه حبيب أميره وقرة عينه ليستلسلم أخيرا لقضاء الله موجها شوقه وحنينه إلى أمه «الأمومة الساهرة التي لا تخون وإن خان الجميع ولا تنسى، وإن نسي الناس أجمعون ولا تتهاون، وإن تهاون النسيب والقريب».
ومن جملة ما أرسله إلى أمه قوله:
مصابي جليل، والعزاء جميل ..|.. وظني بأن الله سوف يديلُ
جراح تحاماها الأساة مخوفة ..|.. وسقمان: باد منهما ودخيل
وأسر أقاسيه وليل نجومه ..|.. أرى كلّ شيء غيرهن يزول
على قدر المعاناة التي كان يعانيها الشاعر، فإنه يبث في أمه روح الصبر ويضرب لها أمثلة إسلامية عُرفت بالصبر الجميل أمثال أسماء وصفيّة ... وهو في كلّ ذلك يحاول أن يعزي نفسه ويطمئن امه العجوز، وان السبيل الوحيد هو الرجوع إلى الله عز وجل، يظهر هذا في خاتمة قصيدته:
وما لم يُرده الله في الأمر كّله ..|.. فليس لمخلوق إليه سبيل
ويشتعل قلب الشاعر شوًقا إلى مكان إمارته «منبج» ومستقر أهله وأحبابه ولا عجب في ذلك، فثمة صلة تربط النفس بالظرف والمكان بالحدث، يقول:
قفْ في رسوم المستجا ..|.. بِ وحي أكناف المصّلى
.. تلك المنازل والملا ..|.. عبُ لا أراها الله مَحلا
أوطنتها زمنُ الصبا ..|.. وجعلت منبج لي محلا
ويشتد شوقه إلى أهله، فتسكنه الوحشة بهم فيقول:
يا وحشة الدار التي ربها ..|.. أصبح في أثوابِ مَربوبِ
وهذا الشعور بالغربة سار مع الشاعر في كل رومياته، فحتى في تلك القصائد التي كان يبعث بها إلى سيف الدولة كقوله:
فكيف وفيما بيننا ملك قيصر ..|.. ولا أمل يحي الّنفوس ولا وعد
وإذا كان أبو فراس قد تذلل أحيانا في طلبه الفداء فلأجل الترفق بأمه، ونزولا عند رغبتها، وفي ذلك يقول:
لولا العجوز بمنبج ..|.. ما خفتُ أسباب المنية
ولكان لي عمّا سألت ..|.. من الفداء نفس أبيّة
لكن أردت مُرادها ..|.. ولو انجذبت إلى الدنية
وفي سؤالها عن ابنها بل عن الأسد الهصور يقول:
تسأل عّنا الركبان جاهدة ..|.. بأدمعٍ ما تكاد تمهلها
يا منْ رأى لي بحصن خرشةٍ ..|.. أسد ثريّ في القيود أرجلها
يا أيها الراكبان هل لكما ..|.. في حمل نجوى يخفّ محملها
ولكن الشاعر يحاول أن يطمئنها ويخفف عنها رغم الآلام التي تقطع نياط قلبه، فيقول:
قولا لها إن وعت مقالكما ..|.. وإن ذكري لها ليُذهُلها
يا أمتا هذه منازلنا ..|.. نتركها تارة وننزُلها
ومن أحسن قصائده في العتاب لسيف الدولة تلك التي بعث بها إليه بعدما ذهبت أمة ترجوه الفداء فردها خائبة وأعز عليه ذلك فقال:
بأي عذر رددتُ والهةً ..|.. عليك دون الورى مُعوُلها
جاءتك تمتاح رد واحدها ..|.. ينتظر الّناس كيف تقفلُها
إن كنت لم تبذل الفداء لها ..|.. فلم ازل في رضاك أبُذلها
تلك الموداتُ كيف تُمهلها ..|.. تلك المواعيد كيف تغفُلها
تلك العقود التي عقدت لنا ..|.. كيف وقد أحكمت تُحّللها
أرجامنا منك لم تُقطعها ..|.. ولمْ تَزلْ دائباً تُوصُلها
ولم يقتصر أبو فراس في كتابه على سيف الدولة فحسب، بل عتب كذلك على قومه، وشكا منهم جفاءهم فقال:
تمنيتم أن تفقدوني وإّنما ..|.. تمنيتم أن تفقدوا العزأ صيدا
ونراه في قصيدة أخرى، يشكو من الوشاه والحساد الذين وشوا به لدى سيف الدولة فامتنع عن فدائه كما جاء في قوله:
لمنْ جاهد الحساد أجر المجاهد ..|.. وأعجز ما حاولتُ إرضاء حاسد
ولم أر مثلي اليوم أكثر حاسدا ..|.. كأن قلوب الّناس لي قلب واحد
ألم ير هذا الدهر غيري فاضلاً ..|.. ولم يظفر الحساد قبلي بما جد
ثم يعود أبو فراس، ليستعطف سيف الدولة مرة أخرى، ومرات، ومرات يشكو سوء حاله، مستعملا كلّ أساليب العطف والحب والمدح والفخر للتقرب منه وعدم حرمانه من رؤيته مجددا متمنيا أن يعود الصفاء والوئام بينهما فيقول:
لم يبق في الناس أمةٌ عرَفتْ ..|.. وإلا وفضل الأمير يشملها
نحن أحق الورى برأفته ..|.. فأين عّنا؟ وأين معدِلها
يا مُنفق المال لا يدير به ..|.. إلا المعالي التي يؤشُلها
أصبحت تشْري مكارما فضلاً ..|.. فداؤنا قدْ علمت أفضلها
لا يقبل الله قبل فرضك ذا ..|.. نافلة عنده تُنفلها
لقد أصاب أبو فراس في وصفه هذا، وتفوق كثيرا في جمعه بين العتاب والمديح، فجاءت أبياته رصينة الأسلوب، قوية المعنى، ولعّلها أثرت كثيرا في سيف الدولة وكانت من بين أسباب فدائه. غير أن جراح أبي فراس لم تقتصر على الحنين والفخر والشكوى والاستعطاف، بل تعدت ذلك إلى الرثاء، وهو غرض يفيض باللوعة والأسى، طرقه الأمير، لأن بُعده وأسره جعلاه يفقد أعز الّناس لديه وإلى الأبد، وأروع ما قاله في هذا المضمار قصيدة رثاء أمه التي تمنت رؤيته وتمّنى رؤيتها «هو رثاء الترديد والتكرير والمناداة أكثر مما هو رثاء الفيض الوجداني» يقول فيها:
أيّا ام الأسير سقاك غيث ..|.. بكُره منك ما لقي الأسيرُ
أيا أم الأسير، سقاك غيث ..|.. تحير لا يقيمُ، ولا يسيرُ
أيا ام الأسير، سقاك غيث ..|.. إلى من بالفدا يأتي البشيرُ؟
أيا أم الأسير لمن تربى ..|.. وقدمت الّذوائب و الشعور!
إذا ابنك سار في برٍّ وبحرٍ ..|.. فمن يدعو له أو يستجير؟
حرام ان بيت قرير عينٍ ..|.. وُلؤْمٌ أن يلِّم به السرور!
وقد ذُقت المنايا والرزايا ..|.. ولا ولدٌ لديك ولا عشيرُ!
وغاب حبيب قلبك عن مكانٍ ..|.. ملائكة السماء به حضور
وبعد الّنداء ينتقل الشاعر إلى الأمر ليقصد به حث الّنفس على التحمل والعين على البكاء منوها بخصال أمه الرفيعة فيقول:
ليبكِكَ كلّ يومٍ، صمتِ فيه ..|.. مُصابرة وقدْ حمى الهجيرُ
ليبكك كلّ يومٍ قمتِ فيه ..|.. إلى أن يبتدي الفجرُ المنير
ليبكك كلّ مضطهدٍ مخوف ..|.. أجرتيه، وقد قلّ المجُير
ليبكك كلّ مسكين فقير ..|.. أغثتيه وما في العظم ريرُ
جميل جداً ما قاله أبو فراس في مرثيته هذه، التي تزخر بالمشاعر الصادقة والعواطف الجياشة الصادرة عن نفس حزينة متكسرة كسرها الزمن وظلمها القضاء وأبى إلا أن تعيش وحيدة.
ويبدو جلياً أسى الشاعر وتأثره الشديد بموت والدته الرؤوم التي لم ير مثيلاً لها، مستهلاً قصيدته بنداء ودعاء ثم معدداً لمناقبها، فخاتما إياها بالحسرة كما رثى الشاعر أخت سيف الدولة.
ولم تخلو روميات أبي فراس من الاخوانيات، فقلب الشاعر مرهف حساس رغم معاناته واقتصرت اخوانياته على أخويه أبي الهجاء وأبي الفضل وبعض غلمانه، وابني أختيه، وتعددت أغراض الإخوانيات وكثرت وامتزجت بالحسرة والحكمة والفخر، ومجمل مراثي أبي فراس صدرت عن عاطفة صادقة قوية لأنه لم يرث فيها إلا أقرب الأقربين، وكلها أشعار تشع حكمة وتعتصر ألما وشكوى.
وتسيطر على أبى فراس الّنزعة الحربية فيتذكر حروب سيف الدولة مع الروم، وما أحرزه من نصر عظيم، وفوز كبير، مفتخراً بنفسه ونسبه وأميره (سيف الدولة) ولعلّ أجمل ملحمة مثلت هذا الغرض أحسن تمثيل «قصيدته الرائية الكبرى التي مطلعها:
لعل خيال العامرية زائرُ ..|.. فيسعد مهجورٌ ويسعد هاجرُ
وقد سكبها على روي الراء، كلها من بحر واحد في مائتين وخمسة عشر بيتاً، فكانت قصيدته هذه قد جاءت إلى عهده أطول قصيدة محكمة في شعر الحرب، يفيض بها شاعر ملء الشوط في معان قوية ولفظ مكين.
فيتدرج في قصيدته المطولة هذه يستهلها بمقدمة غزلية، لينتقل إلى فخره بأجداده، وعمومته، ثم يتوقف طويلاً عند سيف الدولة، يفخر بمواقفه ومحطاته الحربية وتلك الانتصارات التي حققها على أعدائه، مشيراً إلى أهم الصفات الحميدة التي اشتمل عليها أهله، وقومه كالكرم والشجاعة والنجدة والمروءة... ويختم قصيدته بحكمة جليلة يقول فيها:
وهل تجحد الشمس المنيرة ضوءها ..|.. ويستر نُور اليدر والبدرُ زاهر
أما إذا تحدثنا عن غزل أبي فراس، فإنه قد تمثل في بعض المقدمات التقليدية ناهجا نهج القدامى وكثيرا ما استهل الشاعر قصائده بالنسيب والوقوف على الأطلال والرسوم الدارسة، مخاطبا إياهاً متذكرا الحبيبة وطيفها قائلا:
فرض عليّ لكل دارٍ وقفةٌ ..|.. تقضي حقوقَ الدارِ والأجفانِ
لو تذكّر منْ هويتُ بحاجر ..|.. لم أبكِ فيه مواقد النيران
ولقد أراه قُبيل طارقة لنوى ..|.. مأوى الحسان ومن زل الضيفان
غير أنَّ حب الشاعر، وغزله اقتصر على المقدمات الطليعة وكّلها كانت قبل الأسر، فلم يفرد الشاعر قصيده في الغزل (من أولها إلى آخرها) لا قبل الأسر ولا في الأسر ولا بعد الأسر، ويهمنا كثيراً ما قاله من الغزل وهو أسير فذلك أشد لوعة وأكثر إيلاما وإن كان مختصراً.
وإذا ما نظرنا في روميات أبي فراس فإننا لا نعثر إلا على النزر القليل من الغزل وقد بث معظمه في رائيته المشهورة:
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر ..|.. أما للهوى نهيا عليك ولا أمر
بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ..|.. ولكنّ مثلي لا يذاع له سرُّ
إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى ..|.. وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر
تكاد تضيء النار بين جوانحي ..|.. إذا هي أذكتها الصبابة والفكْر
وكل روميات أبي فراس اشتملت هذا الغرض كما اشتملت الأغراض الأخرى وكثيرا ما كانت تنتهي بالحكمة وكيف لا يصبح الأمير الأسير حكيما وقد عضه الدهر بأنيابه، وهذا النوع من الشّعر لا نجده في قصائد موحدة إنما عبارة عن أبيات متفرقة هنا وهناك. لقوله مفتخرا:
سيذكرني قومي إذا جدَّ جدّهم ..|.. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
هكذا تنوعت روميات أبي فراس وعدت من غرر الشعر وقد حّقت فيها هذه التسمية نظراً لروعة تعبير الشاعر وفصاحة لسانه ومعايشته للظرف، إّنها صورة ناطقة، شخّص فيها الشاعر نفسه المتألمة الكلمة وواقعه المزري وحياته القاسية، إّنها زبدة تجاربه الحية الحقيقية، وخلاصة معاركته للحياة التي اقتصت منه، فأشربته العلقم قطرة قطرة وجرعته الموت أنفاسا، وما بثه الشاعر في قصائده من حنين وشوق ولوعة حب إلى فخر ورثاء وشكوى قلْب أكبر دليل على ما قاساه أميرنا وهو رهين يتخبط بين القضبان الرومية وبين ضلوعه الحمدانية وتمة بؤرة الأسى وفوهة العذاب.
كثرت الدراسات حول روميات أبي فراس الحمداني فتناولتها من نواحي كثيرة وبكل مستويات الخطاب الشعري فيها، ابتداءً من المستوى الصوتي ومروراً بالمستوى التركيبي، وانتهاءً بالمستوى الدلالي.
لقد نهج أبا فراس نهج الشعراء القدماء الذين كانوا يميلون إلى الأوزان الطويلة الكثيرة المقاطع، وظهر ذلك من خلال استخدامه للطويل والبسيط والكامل بشكل لافتٍ للنظر إذ إن الطويل وحده قد شكّل ما نسبته 60% من مجموع أبيات الروميات، وربما يرجع عدم مواكبة الشاعر للتطور الذي طرأ على أوزان الشعر العربي منذ العصر العباسي، وعدم اكتراثه بما أظهره الشعراء العباسيون من اهتمام وعناية بالأوزان القصيرة والمجزوئة التي تلائم نمط الحياة الجديدة وما استجدفيها من غناء ولهو وطرب، إلا أن هذه الأسباب التي دعت الشعراء العباسيون للتجديد في الأوزان قد انتفت في حاضرة الإمارة الحمدانية التي عاش فيها الشاعر وكانت تتطلع إلى إحياء كل ما هو قديم وجميل، علاوة على أن الشاعر قد عزل عن محيطه الاجتماعي بسبب أسره.
وبيَّنت الدراسة أثر التكرار، بوصفه أحد أشكال الموسيقى الداخلية، في الإيقاع الشعري في الروميات وذلك من خلال تسليط الضوء عليه بكل أنماطه وأشكاله من ترديد وتصدير وجناس كما أبرزت الدراسة ما لهذه الأشكال التكرارية من موسيقى، وما ارتبط بها من دلالات مستوحاة من السياقات المتعددة التي وردت فيها.
أما ما يتعلق بالمستوى التركيبي فقد تفنّن أبو فراس في استخدام أساليب العدول التركيبي كالتقديم والتأخير والحذف ليخدم المعنى الشعري، وجاء الاعتراض علامة مميزة في البنية التركيبية للروميات في تنوعه وكثرته وكأنه يشير إلى غنى التجربة لدى الشاعر، فتتنوع لديه دلالات الاعتراض، بين الإبانة والمبالغة والتخصيص، بتنوع حاجات النفس.
كما كثف أبو فراس من استخدام الأساليب الإنشائية في رومياته من استفهام ونداء وأمر ونهي وتمني، وهي أساليب تفرضها الوجدانية الغالبة على رومياته من جهة ومن جهة ثانية أن هذه الأساليب تقيم حواراً مع الآخر الذي يتطلع إليه الشاعر الأسير ليبثه حزنه وشوقه، أو ليعاتبه تركه وحيداً في الأسر أو ليطلب مساعدته في الخروج من مأزق الأسر.
وأظهرت الدراسات أن التراكيب اللغوية في الروميات ـ بشكل عام ـ قد اتسمت بالبساطة التي تؤثر في القلوب وتجذب النفوس إليها.
وبيَّنت الدراسات للصورة الشعرية (مجالاتها ومصدرها) اتكاء الصورة على مجال الحياة الإنسانية الذي تشكلت الصورة فيه من ذات الشاعر بآلامها وآمالها وعلاقاتها بمن حولها وما كان يشغل ذهنه كالموت، كما تشكلت من الإنسان الآخر أهله وأصحابه وسجانيه بشكل لافت للنظر. ويبدو أن الذات المبدعة وما تحمله من هموم وأحزان قد ألقت بنفسها على الشاعر، وتملَّكت مخيلته الشعرية.
وقد جاء مجال الطبيعة ثانياً من حيث عدد صوره إلا أن هنالك تراجعاً واضحاً في مجالي الحياة اليومية والحيوان، وربما يرجع السبب وراء تراجع هذين المجالين إلى حياة السجن الرتيبة والعزلة عن العالم الآخر اللتين عاشهما الشاعر.
ثم إن المتأمل في مصادر الصورة سيرى أن الشاعر قد استعار الكثير من الصفات السلبية من مجال الإنسان ومن مجال الحيوان ومن الحشرات والطيور وأصبغها على صورة الدهر والأهل والأعداء مما يعكس بشكل أو بآخر العلاقة المتأزمة بين الشاعر، وهذا الآخر.
وإذا كانت بنية الصورة الاستعارية ـ وخاصة المكنيةـ بوصفها أداة تصويرية يغلب مجيؤها عند الشعراء الوجدانيين، فقد أظهرت الدراسة أن أبا فراس استطاع أن يوظف هذه البنية التصويرية ببناها المعقدة وقدرتها على ملامسة الأشياء، في تصوير ما يلقاه من عذابات الأسر والبعد عن الأهل والأصحاب وقسوة الأصدقاء وتناسيهم إياه، وأن يكثر من استخدامها في الرُّوميات للوفاء بحاجاته النفسية.
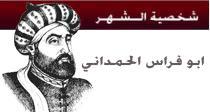
شاعرية أبو فراس:
تفتّقت شاعرية أبي فراس منذ صباه، فنظم الشعر مبكراً، وبرزت إرهاصات النضج الفني في شعره ولا فرق في ذلك، فقد كانت الأرضية مهيأة لتخلق منه شاعراً أصيلاً، يتمه وهو صبي وعناية أمه به، ونشأته في بلاط الأمير، ونسبه العريق وبيئته وموهبته وأسره... كّلها عوامل كانت كفيلة ليصبح أبو فراس أشعر الشعراء، على الرغم من أن الشاعر لم يشأ أن يكون شاعراً لغرض مدح الأمراء وكثيراً ما نفر أميرنا من لقب المستجدين، فقال بعد أن بين أنه ينظم الشعر في مفاخره ومفاخر أبائه، وأّنه في نفسه غاية لا وسيلة، وبلسماً يداوي به كلومه وقد أغناه الله عن السؤال بعزة الملك، ونعيم الدولة، فلم يصطنع المدح ولا الهجاء وإّنما مدح قومه من باب الفخر يقول: نطقت بفضلي وامتدحت عشيرتي ..|.. فما أنا مداح ولا أنا شاعر
والحق يقال، أن الشعر في الأمراء صفة ثانوية لا يعول عليها ولكن أبا فراس انفرد بشعره ليكون لسانه الفصيح وترجمانه البليغ في كلّ الميادين وإلا كيف يعبر عن فخره بنفسه وقومه ومديحه لسيف الدولة الحمداني ورثائه لأمه والكثير من أحيائه وغزله ووصفه لربوع البقاع التي عاش فيها والطبيعة التي كانت تحيط به بنوعيها الصامتة والحية ومجالس الأنس والترف... ولا غرابة في ذلك فهو الأمير والأسير في نفس الوقت بقدر ما عاش رغد الحياة عاش كذلك جور الزمن وجفاء الخلان... وهي ازدواجية قلما نجدها في الشعر العربي ولعل الحديث سيقتصر على الفترة التي قضاها وهو رهين الأسر لأنها فترة تستحق الوقوف، وتختلف جذرياً من فترات الحرية التي عاشها الأمير وتمتع فيها برغد الحياة، فمرحلة الأسر هذه تشد الانتباه وتثير التساؤل لما تميزت به من أهوال ومآسي، وكلوم، تتخللها عواطف القوة واللين.
الروميات:
بلغت روميات أبي فراس، زهاء خمس وأربعين قصيدة ومقطوعة، صور فيها حالة أسره ونفسيته المنكسرة وآلامه وجراحه، وحنينه إلى أهله وأمه، وطلب الفداء من سيف الدولة، وعتابه إلى بعض أصدقاءه، وافتخاره بماضيه، فكانت أشبه بسجل عّذاب وديوان نفس بائسة متمردة تعيش القلق، والانتظار، وتحب الحرية شأنها في ذلك شأن بقية المخلوقات.
وبهذا استطاعت أن تتميز عن باقي الأشعار، وتضع لنفسها طابعاً فريداً وذوقاً خاصاً يتلذذها القارئ والسامع معاً، ونالت رومياته شهرة واسعة جعلت الأدباء يتحدثون عنها بإسهاب كبير فقد روي ابن خالوية «بأن أبا فراس نفح الشعر العربي برومياته التي نظمها، وهو أسير بلون عاطفي لم يعرف من ذي قبل، يرشح بصدق الإحساس، والتصوير الواقعي، والشكوى والتألم، وهذا اللون هو الذي ضمن له الخلود الأدبي»، واعتبرها القيرواني «قصائداً لا تناهض ويصعب الإتيان بمثلها»، ولا عجب في ذلك، فلقد كان الألم ينطق الشاعر، بل ينطق الأمير الأسير، فيرسل أشعاراً عذبة رقيقة تتنازعها عواطف شتى، عاطفة افتخار وإجلال، وعاطفة اعتصام وآمال وعاطفة شكوى وآلام ولهذا جاءت متسمة بالشعور الأليم والحنين إلى الوطن، وقد لا يستطيع ناثر أن يشرح ما فيها من العواطف فهي من أرق أشعار أبي فراس، وقد مهرت الأدب نوعا مميزاً من الشعر الوجداني.
ولم يكن وصف الأدباء لروميات أبي فراس من باب المجاملة أو المبالغة، وإنما هي الحقيقة، فقد عبر الشاعر عن نفسه التواقة إلى الحرية والسكينة، خالية من الأميال الحادة الجبارة، لأن الألم لم يضعف منها بل زادها إباء وصبراً وجمالاً وإن هو اتخذ التغني كوسيلة للتعبير عن جراحه فهو غاية في حدِّ ذاته يحمل دلائل الصبر على البلاء، والاستعطاف لأجل الفداء، والحنين إلى الأم والأحباء، والتفريج عن عقدة الأهواء.
كان إذن صادقاً في تعبيره، مستجيباً لسجتيه، مسترسلاً في أقواله ويشهد له بجودة رومياته وما اشتملت عليه من صدق العاطفة، وإيحاء الألفاظ، ورصانة الأسلوب، وحسن السلوك، وهي الخصائص التي جعلته يستوي عرش الوجدانيات، ويحتل مكانة رفيعة بين شعراء العصر العباسي، أو كلّ العصور ولعّلها عوامل تضافرت لتخلق هذا النَفس المُميز وهذا اللون الرائع من الشعر العربي الأصيل، اللون الباكي الحزين، وقد يكون هذا الحزن والأنين من جراء الأسر هما اللذان ضمنا خلود الروميات، فانفردت بطابع خاص واصطبغت بألوان الحضارة والثقافة والطبيعة وفي هذا المعنى يقول سامي الكيلاني: «إن جمال الروميات واختلاط أبي فراس بالقياصرة، ورؤيته آثار العمران، ومطارف النعيم... وما إلى ذلك مما هو أقرب إلى الحضارة منه إلى البداوة كان من الوسائل التي أنضجت شاعريته الخصبة بمعاني الوحي والآلام».
وربما هذه الألوان نادرة جداً في الروميات، إذ اكتفى الشاعر بتصوير حالته النفسية وما تشتمل عليه من حنين وشوق، وألم وشكوى وصبر وتجّلد، سعياً وراء خير الوطن وطلبا في الحرية، فالألم بنوعيه النفسي والجسدي، هو مصدر روميات الشاعر، وهو الذي أكسبها صبغة جمالية فريدة، وبعداً نفسياً عميقاً، فجعلها تتنوع تنوع نزعاته النفسية من فخر وحنين إلى مناجاة وصبر، وأنين «فيها لنفسه ذكرى وحرقة ولهب ولأمه تعزية وعبره، ولأصدقائه وأنسابه شوق وتحنان».
ولكننا أينما تطلعنا، رأينا وجه الشاعر مفاخراً بنفسه وقومه، متحملاً للصعاب، غير مستسلم للقدر ثابتاً، صامداً جامعاً بين عزة النفس ونخوة العروبة ومن أمثلة ما قاله وهو جريح:
وقد عرفت وقَع المسامير مُهجتي وشُقق عن زُرقي الَنصول إهابي
وعندما نقل إلى خرشنة أسيراً، قال مواسياً نفسه:
إنْ زُرْتُ خَرْشَنَة أسِيرَاً ..|.. فَلَكَمْ أحَطْتُ بها مُغِيرا
وَلَقَدْ رَأيْتُ النّارَ تَنْـ ..|.. ـتَهِبُ المَنَازِلَ وَالقُصُورَا
وَلَقَدْ رَأيْتُ السّبْيَ يُجْ ..|.. ـلبُ نحونا حوَّا، وحورا
نَخْتَارُ مِنْهُ الغَادَة َ الْـ ..|.. حسناءَ، والظبيَ الغريرَا
إنْ طالَ ليلي في ذُرا ..|.. كِ فقدْ نعمتُ بهِ قصيرا
ولئنْ لقيتُ الحزن فيـ ..|.. كَ فقدْ لقيتُ بكِ السرورا
وَلَئِنْ رُمِيتُ بِحادِثٍ، ..|.. فلألفينَّ لهُ صبورا
صبرا ً لعلَّ اللهَ يفـ ..|.. تحُ بعدهُ فتحاً يسيراً
منْ كانَ مثلي لمْ يبتْ ..|.. إلاّ أسِيراً، أوْ أمِيرا
لَيْسَتْ تَحُلّ سَرَاتُنَا ..|.. إلا الصدورَ أو القبورا
ويترّفع أبو فراس عن ذلِّ القيد وتحضره إمارة المجد المؤثل فيجمع بين شاعرية اللغة، وفروسية الميدان، ليرسم لنا صورته الحربية أيام أغار على خرشنة فأحرق القصور وسبى الحور... فلا بأس إذن أن يؤسر فيها، وإّنه على ذلك لصبوراً إما أسيراً أو اميراً.
هكذا يحاول الشاعر أن يخفي مشاعره فيتظاهر بالاعتصام ويفخر بحسن المقام، ولكّنه لم يكن يعلم أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن أمر الفداء لا يزال عسيراً، فراح يطلب الفداء من سيف الدولة، وللمرة الأولى معتقداً أن نداءه سيُلبى وأن الأمير سيف الدولة لن يتخلى عنه، يقول في داليته الرائعة:
دعوُتك للجفْنِ القريح المسهد ..|.. لديَّ وللّنوم القليل المشردِ
وما ذاك بخْلا بالحياة، وإنَّها ..|.. لأولُ مبذولٍ لأول مجتد
وما الأسر مما ضقتْ ذرعا بحمله ..|.. وما الخطْب مما أن أقول له: قدي
..ولكنني أختار موت بني أبي ..|.. على صهوات الخيل غير موسد
وتأبى وآبى أن أموت موسدا ..|.. بأيدي النصارى موت أكْمد أكْبدِ
نضوت على الأيام ثوب جلادتي ..|.. ولكّنني لم أنْض ثوب التجّلُد
..دعوتك، والأبواب ترتج دوننا ..|.. فكُن خَير مدعو وأكرم مُنْجد
ويزداد الشاعر تألماً، ومرارة وتأبى نفسه القوية أن تتذلل فينتفض انتفاضة فخر واعتزاز وهو فخر -لا شك في صدقه- كما قال الدكتور شوقي ضيف: «يمتلأ فخره بالحيوية، لأنه يصور واقعاً لا وهماً من أوهام الخيال».
ولا غرو أن يتحلى أبو فراس بهذه المزيا، فهو الأمير الأسير الذي جمع المجد من أطرفه، فكيف يضحي بإمارته وما يتبعها من صفات العز والأنفة والإباء، وكيف يستغني عنه قومه والظلمة تحتاج إلى البدر، يقول:
سيذكرني قومي إذا جد جدهم ..|.. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
ولو سد غيري ما سددتُ اكتفوا به ..|.. وما كان يغلو الّتبر لو نفق الصفر
ويزداد فخر أبو فراس الحمداني لما بلغه أن الروم قالوا «ما أسرنا أحداً لم نسلب ثيابه غير أبي فراس» فقال:
يمنُّون أن خّلو ثيابي وإّنما ..|.. علي ثياب من دمائهم حمرُ
قائم سيفي فيهم اندق نصله ..|.. وأعقاب رمحي فيهم حُطم الصدرُ
وعلى الرغمَ من تنكر سيف الدولة له، وصمت قومه عنه، فإنه لا ينسى أنه الأمجد بن الأماجد وأّنه ثمرة طيبة لشجرة عريقة، وأّنه من قوم كرام يفضلون الموت على الذل والهوان، يقول في ذلك:
ونحن أناس لا توسط بيننا ..|.. لنا الصدر دون العالمين أو القبر
تهون علينا في المعالي نفوسنا ..|.. ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر
أعز بني الدنيا واعلى ذوي العلى ..|.. وأكرم من فوق الّتراب ولا فخر
ويفتخر كذلك في مناظراته مع دمستق الروم، عندما قال له: أنتم كتاب أصحاب أقلام، ولستم أصحاب سيوف، ومن أين تعرفون الحروب، فقال له أبو فراس: نحن نطأ أرضك منذ سنين بالسيوف أم بالأقلام، وأجابه بقصيدة مطلعها:
أتَزْعُمُ، يا ضخمَ اللّغَادِيدِ، أنّنَا ..|.. وَنحن أُسودُ الحرْبِ لا نَعرِفُ الحرْبَا
فويلكَ؛ منْ للحربِ إنْ لمْ نكنْ لها ؟ ..|.. ومنْ ذا الذي يمسي ويضحي لها تربا؟
ومن ذا يقود الجيش من جنباته ..|.. ومن ذا يقود العين أو يصدم القلبا
وويلك من أردى أخاك بمرعشٍ ..|.. وجلل ضربا وجه والدك العصبا
وويلك من خّلى ابن اختك موثقا ..|.. وخلاك "باللقان" تبتدر الشعبا
أتوعدنا بالحرب حتى كأّننا ..|.. وإياك لم يعصب بها قلبناعصبا
ليصل إلى قوله:
بأقلامِنَا أُجْحِرْتَ أمْ بِسُيُوفِنَا؟ ..|.. وأسدَ الشرى قدنا إليكَ أمِ الكتبا؟
وهذه القصيدة مفخرة للحمدانيين، حاول الشاعر بها أن يسمو بقبيلته ذرى المجد ويحطّ من قيمة الروم معّللاً ذلك بذكر أسماء قوادهم، ومواقعهم، غير مبالٍ بالوضعية التي هو عليها ... هي إذن روح القبلية تجري في عروقه وعنفوان الشباب يملي عليه عباراته.
ولكن الوطأة زادت بشدة على أبي فراس، فامتدت غربة الشاعر سنوات، واضطربت روحه النبيلة في نفس ظن صاحبها أنه حبيب أميره وقرة عينه ليستلسلم أخيرا لقضاء الله موجها شوقه وحنينه إلى أمه «الأمومة الساهرة التي لا تخون وإن خان الجميع ولا تنسى، وإن نسي الناس أجمعون ولا تتهاون، وإن تهاون النسيب والقريب».
ومن جملة ما أرسله إلى أمه قوله:
مصابي جليل، والعزاء جميل ..|.. وظني بأن الله سوف يديلُ
جراح تحاماها الأساة مخوفة ..|.. وسقمان: باد منهما ودخيل
وأسر أقاسيه وليل نجومه ..|.. أرى كلّ شيء غيرهن يزول
على قدر المعاناة التي كان يعانيها الشاعر، فإنه يبث في أمه روح الصبر ويضرب لها أمثلة إسلامية عُرفت بالصبر الجميل أمثال أسماء وصفيّة ... وهو في كلّ ذلك يحاول أن يعزي نفسه ويطمئن امه العجوز، وان السبيل الوحيد هو الرجوع إلى الله عز وجل، يظهر هذا في خاتمة قصيدته:
وما لم يُرده الله في الأمر كّله ..|.. فليس لمخلوق إليه سبيل
ويشتعل قلب الشاعر شوًقا إلى مكان إمارته «منبج» ومستقر أهله وأحبابه ولا عجب في ذلك، فثمة صلة تربط النفس بالظرف والمكان بالحدث، يقول:
قفْ في رسوم المستجا ..|.. بِ وحي أكناف المصّلى
.. تلك المنازل والملا ..|.. عبُ لا أراها الله مَحلا
أوطنتها زمنُ الصبا ..|.. وجعلت منبج لي محلا
ويشتد شوقه إلى أهله، فتسكنه الوحشة بهم فيقول:
يا وحشة الدار التي ربها ..|.. أصبح في أثوابِ مَربوبِ
وهذا الشعور بالغربة سار مع الشاعر في كل رومياته، فحتى في تلك القصائد التي كان يبعث بها إلى سيف الدولة كقوله:
فكيف وفيما بيننا ملك قيصر ..|.. ولا أمل يحي الّنفوس ولا وعد
وإذا كان أبو فراس قد تذلل أحيانا في طلبه الفداء فلأجل الترفق بأمه، ونزولا عند رغبتها، وفي ذلك يقول:
لولا العجوز بمنبج ..|.. ما خفتُ أسباب المنية
ولكان لي عمّا سألت ..|.. من الفداء نفس أبيّة
لكن أردت مُرادها ..|.. ولو انجذبت إلى الدنية
وفي سؤالها عن ابنها بل عن الأسد الهصور يقول:
تسأل عّنا الركبان جاهدة ..|.. بأدمعٍ ما تكاد تمهلها
يا منْ رأى لي بحصن خرشةٍ ..|.. أسد ثريّ في القيود أرجلها
يا أيها الراكبان هل لكما ..|.. في حمل نجوى يخفّ محملها
ولكن الشاعر يحاول أن يطمئنها ويخفف عنها رغم الآلام التي تقطع نياط قلبه، فيقول:
قولا لها إن وعت مقالكما ..|.. وإن ذكري لها ليُذهُلها
يا أمتا هذه منازلنا ..|.. نتركها تارة وننزُلها
ومن أحسن قصائده في العتاب لسيف الدولة تلك التي بعث بها إليه بعدما ذهبت أمة ترجوه الفداء فردها خائبة وأعز عليه ذلك فقال:
بأي عذر رددتُ والهةً ..|.. عليك دون الورى مُعوُلها
جاءتك تمتاح رد واحدها ..|.. ينتظر الّناس كيف تقفلُها
إن كنت لم تبذل الفداء لها ..|.. فلم ازل في رضاك أبُذلها
تلك الموداتُ كيف تُمهلها ..|.. تلك المواعيد كيف تغفُلها
تلك العقود التي عقدت لنا ..|.. كيف وقد أحكمت تُحّللها
أرجامنا منك لم تُقطعها ..|.. ولمْ تَزلْ دائباً تُوصُلها
ولم يقتصر أبو فراس في كتابه على سيف الدولة فحسب، بل عتب كذلك على قومه، وشكا منهم جفاءهم فقال:
تمنيتم أن تفقدوني وإّنما ..|.. تمنيتم أن تفقدوا العزأ صيدا
ونراه في قصيدة أخرى، يشكو من الوشاه والحساد الذين وشوا به لدى سيف الدولة فامتنع عن فدائه كما جاء في قوله:
لمنْ جاهد الحساد أجر المجاهد ..|.. وأعجز ما حاولتُ إرضاء حاسد
ولم أر مثلي اليوم أكثر حاسدا ..|.. كأن قلوب الّناس لي قلب واحد
ألم ير هذا الدهر غيري فاضلاً ..|.. ولم يظفر الحساد قبلي بما جد
ثم يعود أبو فراس، ليستعطف سيف الدولة مرة أخرى، ومرات، ومرات يشكو سوء حاله، مستعملا كلّ أساليب العطف والحب والمدح والفخر للتقرب منه وعدم حرمانه من رؤيته مجددا متمنيا أن يعود الصفاء والوئام بينهما فيقول:
لم يبق في الناس أمةٌ عرَفتْ ..|.. وإلا وفضل الأمير يشملها
نحن أحق الورى برأفته ..|.. فأين عّنا؟ وأين معدِلها
يا مُنفق المال لا يدير به ..|.. إلا المعالي التي يؤشُلها
أصبحت تشْري مكارما فضلاً ..|.. فداؤنا قدْ علمت أفضلها
لا يقبل الله قبل فرضك ذا ..|.. نافلة عنده تُنفلها
لقد أصاب أبو فراس في وصفه هذا، وتفوق كثيرا في جمعه بين العتاب والمديح، فجاءت أبياته رصينة الأسلوب، قوية المعنى، ولعّلها أثرت كثيرا في سيف الدولة وكانت من بين أسباب فدائه. غير أن جراح أبي فراس لم تقتصر على الحنين والفخر والشكوى والاستعطاف، بل تعدت ذلك إلى الرثاء، وهو غرض يفيض باللوعة والأسى، طرقه الأمير، لأن بُعده وأسره جعلاه يفقد أعز الّناس لديه وإلى الأبد، وأروع ما قاله في هذا المضمار قصيدة رثاء أمه التي تمنت رؤيته وتمّنى رؤيتها «هو رثاء الترديد والتكرير والمناداة أكثر مما هو رثاء الفيض الوجداني» يقول فيها:
أيّا ام الأسير سقاك غيث ..|.. بكُره منك ما لقي الأسيرُ
أيا أم الأسير، سقاك غيث ..|.. تحير لا يقيمُ، ولا يسيرُ
أيا ام الأسير، سقاك غيث ..|.. إلى من بالفدا يأتي البشيرُ؟
أيا أم الأسير لمن تربى ..|.. وقدمت الّذوائب و الشعور!
إذا ابنك سار في برٍّ وبحرٍ ..|.. فمن يدعو له أو يستجير؟
حرام ان بيت قرير عينٍ ..|.. وُلؤْمٌ أن يلِّم به السرور!
وقد ذُقت المنايا والرزايا ..|.. ولا ولدٌ لديك ولا عشيرُ!
وغاب حبيب قلبك عن مكانٍ ..|.. ملائكة السماء به حضور
وبعد الّنداء ينتقل الشاعر إلى الأمر ليقصد به حث الّنفس على التحمل والعين على البكاء منوها بخصال أمه الرفيعة فيقول:
ليبكِكَ كلّ يومٍ، صمتِ فيه ..|.. مُصابرة وقدْ حمى الهجيرُ
ليبكك كلّ يومٍ قمتِ فيه ..|.. إلى أن يبتدي الفجرُ المنير
ليبكك كلّ مضطهدٍ مخوف ..|.. أجرتيه، وقد قلّ المجُير
ليبكك كلّ مسكين فقير ..|.. أغثتيه وما في العظم ريرُ
جميل جداً ما قاله أبو فراس في مرثيته هذه، التي تزخر بالمشاعر الصادقة والعواطف الجياشة الصادرة عن نفس حزينة متكسرة كسرها الزمن وظلمها القضاء وأبى إلا أن تعيش وحيدة.
ويبدو جلياً أسى الشاعر وتأثره الشديد بموت والدته الرؤوم التي لم ير مثيلاً لها، مستهلاً قصيدته بنداء ودعاء ثم معدداً لمناقبها، فخاتما إياها بالحسرة كما رثى الشاعر أخت سيف الدولة.
ولم تخلو روميات أبي فراس من الاخوانيات، فقلب الشاعر مرهف حساس رغم معاناته واقتصرت اخوانياته على أخويه أبي الهجاء وأبي الفضل وبعض غلمانه، وابني أختيه، وتعددت أغراض الإخوانيات وكثرت وامتزجت بالحسرة والحكمة والفخر، ومجمل مراثي أبي فراس صدرت عن عاطفة صادقة قوية لأنه لم يرث فيها إلا أقرب الأقربين، وكلها أشعار تشع حكمة وتعتصر ألما وشكوى.
وتسيطر على أبى فراس الّنزعة الحربية فيتذكر حروب سيف الدولة مع الروم، وما أحرزه من نصر عظيم، وفوز كبير، مفتخراً بنفسه ونسبه وأميره (سيف الدولة) ولعلّ أجمل ملحمة مثلت هذا الغرض أحسن تمثيل «قصيدته الرائية الكبرى التي مطلعها:
لعل خيال العامرية زائرُ ..|.. فيسعد مهجورٌ ويسعد هاجرُ
وقد سكبها على روي الراء، كلها من بحر واحد في مائتين وخمسة عشر بيتاً، فكانت قصيدته هذه قد جاءت إلى عهده أطول قصيدة محكمة في شعر الحرب، يفيض بها شاعر ملء الشوط في معان قوية ولفظ مكين.
فيتدرج في قصيدته المطولة هذه يستهلها بمقدمة غزلية، لينتقل إلى فخره بأجداده، وعمومته، ثم يتوقف طويلاً عند سيف الدولة، يفخر بمواقفه ومحطاته الحربية وتلك الانتصارات التي حققها على أعدائه، مشيراً إلى أهم الصفات الحميدة التي اشتمل عليها أهله، وقومه كالكرم والشجاعة والنجدة والمروءة... ويختم قصيدته بحكمة جليلة يقول فيها:
وهل تجحد الشمس المنيرة ضوءها ..|.. ويستر نُور اليدر والبدرُ زاهر
أما إذا تحدثنا عن غزل أبي فراس، فإنه قد تمثل في بعض المقدمات التقليدية ناهجا نهج القدامى وكثيرا ما استهل الشاعر قصائده بالنسيب والوقوف على الأطلال والرسوم الدارسة، مخاطبا إياهاً متذكرا الحبيبة وطيفها قائلا:
فرض عليّ لكل دارٍ وقفةٌ ..|.. تقضي حقوقَ الدارِ والأجفانِ
لو تذكّر منْ هويتُ بحاجر ..|.. لم أبكِ فيه مواقد النيران
ولقد أراه قُبيل طارقة لنوى ..|.. مأوى الحسان ومن زل الضيفان
غير أنَّ حب الشاعر، وغزله اقتصر على المقدمات الطليعة وكّلها كانت قبل الأسر، فلم يفرد الشاعر قصيده في الغزل (من أولها إلى آخرها) لا قبل الأسر ولا في الأسر ولا بعد الأسر، ويهمنا كثيراً ما قاله من الغزل وهو أسير فذلك أشد لوعة وأكثر إيلاما وإن كان مختصراً.
وإذا ما نظرنا في روميات أبي فراس فإننا لا نعثر إلا على النزر القليل من الغزل وقد بث معظمه في رائيته المشهورة:
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر ..|.. أما للهوى نهيا عليك ولا أمر
بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ..|.. ولكنّ مثلي لا يذاع له سرُّ
إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى ..|.. وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر
تكاد تضيء النار بين جوانحي ..|.. إذا هي أذكتها الصبابة والفكْر
وكل روميات أبي فراس اشتملت هذا الغرض كما اشتملت الأغراض الأخرى وكثيرا ما كانت تنتهي بالحكمة وكيف لا يصبح الأمير الأسير حكيما وقد عضه الدهر بأنيابه، وهذا النوع من الشّعر لا نجده في قصائد موحدة إنما عبارة عن أبيات متفرقة هنا وهناك. لقوله مفتخرا:
سيذكرني قومي إذا جدَّ جدّهم ..|.. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
هكذا تنوعت روميات أبي فراس وعدت من غرر الشعر وقد حّقت فيها هذه التسمية نظراً لروعة تعبير الشاعر وفصاحة لسانه ومعايشته للظرف، إّنها صورة ناطقة، شخّص فيها الشاعر نفسه المتألمة الكلمة وواقعه المزري وحياته القاسية، إّنها زبدة تجاربه الحية الحقيقية، وخلاصة معاركته للحياة التي اقتصت منه، فأشربته العلقم قطرة قطرة وجرعته الموت أنفاسا، وما بثه الشاعر في قصائده من حنين وشوق ولوعة حب إلى فخر ورثاء وشكوى قلْب أكبر دليل على ما قاساه أميرنا وهو رهين يتخبط بين القضبان الرومية وبين ضلوعه الحمدانية وتمة بؤرة الأسى وفوهة العذاب.
كثرت الدراسات حول روميات أبي فراس الحمداني فتناولتها من نواحي كثيرة وبكل مستويات الخطاب الشعري فيها، ابتداءً من المستوى الصوتي ومروراً بالمستوى التركيبي، وانتهاءً بالمستوى الدلالي.
لقد نهج أبا فراس نهج الشعراء القدماء الذين كانوا يميلون إلى الأوزان الطويلة الكثيرة المقاطع، وظهر ذلك من خلال استخدامه للطويل والبسيط والكامل بشكل لافتٍ للنظر إذ إن الطويل وحده قد شكّل ما نسبته 60% من مجموع أبيات الروميات، وربما يرجع عدم مواكبة الشاعر للتطور الذي طرأ على أوزان الشعر العربي منذ العصر العباسي، وعدم اكتراثه بما أظهره الشعراء العباسيون من اهتمام وعناية بالأوزان القصيرة والمجزوئة التي تلائم نمط الحياة الجديدة وما استجدفيها من غناء ولهو وطرب، إلا أن هذه الأسباب التي دعت الشعراء العباسيون للتجديد في الأوزان قد انتفت في حاضرة الإمارة الحمدانية التي عاش فيها الشاعر وكانت تتطلع إلى إحياء كل ما هو قديم وجميل، علاوة على أن الشاعر قد عزل عن محيطه الاجتماعي بسبب أسره.
وبيَّنت الدراسة أثر التكرار، بوصفه أحد أشكال الموسيقى الداخلية، في الإيقاع الشعري في الروميات وذلك من خلال تسليط الضوء عليه بكل أنماطه وأشكاله من ترديد وتصدير وجناس كما أبرزت الدراسة ما لهذه الأشكال التكرارية من موسيقى، وما ارتبط بها من دلالات مستوحاة من السياقات المتعددة التي وردت فيها.
أما ما يتعلق بالمستوى التركيبي فقد تفنّن أبو فراس في استخدام أساليب العدول التركيبي كالتقديم والتأخير والحذف ليخدم المعنى الشعري، وجاء الاعتراض علامة مميزة في البنية التركيبية للروميات في تنوعه وكثرته وكأنه يشير إلى غنى التجربة لدى الشاعر، فتتنوع لديه دلالات الاعتراض، بين الإبانة والمبالغة والتخصيص، بتنوع حاجات النفس.
كما كثف أبو فراس من استخدام الأساليب الإنشائية في رومياته من استفهام ونداء وأمر ونهي وتمني، وهي أساليب تفرضها الوجدانية الغالبة على رومياته من جهة ومن جهة ثانية أن هذه الأساليب تقيم حواراً مع الآخر الذي يتطلع إليه الشاعر الأسير ليبثه حزنه وشوقه، أو ليعاتبه تركه وحيداً في الأسر أو ليطلب مساعدته في الخروج من مأزق الأسر.
وأظهرت الدراسات أن التراكيب اللغوية في الروميات ـ بشكل عام ـ قد اتسمت بالبساطة التي تؤثر في القلوب وتجذب النفوس إليها.
وبيَّنت الدراسات للصورة الشعرية (مجالاتها ومصدرها) اتكاء الصورة على مجال الحياة الإنسانية الذي تشكلت الصورة فيه من ذات الشاعر بآلامها وآمالها وعلاقاتها بمن حولها وما كان يشغل ذهنه كالموت، كما تشكلت من الإنسان الآخر أهله وأصحابه وسجانيه بشكل لافت للنظر. ويبدو أن الذات المبدعة وما تحمله من هموم وأحزان قد ألقت بنفسها على الشاعر، وتملَّكت مخيلته الشعرية.
وقد جاء مجال الطبيعة ثانياً من حيث عدد صوره إلا أن هنالك تراجعاً واضحاً في مجالي الحياة اليومية والحيوان، وربما يرجع السبب وراء تراجع هذين المجالين إلى حياة السجن الرتيبة والعزلة عن العالم الآخر اللتين عاشهما الشاعر.
ثم إن المتأمل في مصادر الصورة سيرى أن الشاعر قد استعار الكثير من الصفات السلبية من مجال الإنسان ومن مجال الحيوان ومن الحشرات والطيور وأصبغها على صورة الدهر والأهل والأعداء مما يعكس بشكل أو بآخر العلاقة المتأزمة بين الشاعر، وهذا الآخر.
وإذا كانت بنية الصورة الاستعارية ـ وخاصة المكنيةـ بوصفها أداة تصويرية يغلب مجيؤها عند الشعراء الوجدانيين، فقد أظهرت الدراسة أن أبا فراس استطاع أن يوظف هذه البنية التصويرية ببناها المعقدة وقدرتها على ملامسة الأشياء، في تصوير ما يلقاه من عذابات الأسر والبعد عن الأهل والأصحاب وقسوة الأصدقاء وتناسيهم إياه، وأن يكثر من استخدامها في الرُّوميات للوفاء بحاجاته النفسية.

