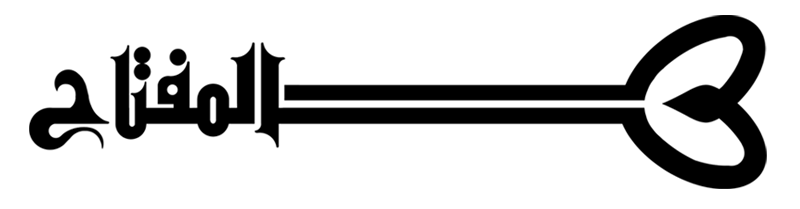محمد نجيم
الوجود والاختلاف من ثلاث زوايا: الأنطولوجية والمعرفية والقيمية
أسئلة الفلسفة وأجوبة جيل دولوز
كتاب: “فلسفة جيل دولوز، عن الوجود والاختلاف
ضمن سلسة “المعرفة الفلسفية”، صدر مؤخراً عن دار توبقال للنشر في الدار البيضاء، كتاب: “فلسفة جيل دولوز، عن الوجود والاختلاف” لمؤلفه الباحث المغربي عادل حدجامي الذي مهّد للكتاب بسؤال إشكالي هو: كيف نبدأ بحثا حول دولوز ومن أين؟ كيف نؤسس لمنطلق في فلسفة كل ما فيها هو بينيات وعلاقات وسيطة؟ كيف نبتدئ مع فكر يؤمن بأن فلسفة لا تبتدئ فعلا ما لم تقطع مع وهم البداية نفسه، وبأن اللاأساس هو الإمكان الأول لكل تأسيس؟ ويرد المؤلف على سؤاله السالف قائلا: “نعتقد أن ذلك لن يكون إلا من حيث ينبغي، أي من الوسط المحض، من قلب فلسفة دولوز العامة، ثم ننحو بعد ذلك شيئاً فشيئاً نحو “الأطراف”، قبل أن نلم الكل إلى أبعاضه في الختام. ولتكن البداية استشكالية نحاول فيها توضيح “إشكالية” هذه الفلسفة ودوافعها، تماماً كما يلح على ذلك دولوز حين يبين بأن التفكير على الحقيقة ليس سوى فن توسيع وتدبير الأسئلة.
النظام ضمن اللانظام
بهذا الاعتبار، سنقول إن ما يبدو لنا مركزيا في تجربة دولوز الفلسفة، وبالتوافق مع التصور القديم عن ماهية الفلسفة، هو على ثلاثة أضرب، أنطولوجي وأكسيولوجي وابستمولوجي. من الناحية الأنطولوجيا ممكنة بعد نيتشه؟ أي كيف تكون الفلسفة كنظام ممكنة في عالم يؤمن باللانظام، وتكون “النظرية الكلية” ممكنة في زمن لا يؤمن بغير الجزئيات؟ ومن هذا السؤال الرئيس تتناسل أسئلة أخرى قاربها عادل حدجامي في مؤلفه القيم من قبيل: كيف نؤسس لفلسفة في واحدية الوجود لا تفرط في التعددات التي يقال عليها؟ وكيف نصوغ نظرية مادية في العالم والطبيعة نتفادى فيها عيبين: أن نقتصر على الموجود وحده وهو ما سيسقطنا في المادية الفجة، أو أن ننظر إلى الوجود كأصل كلي، وهو ما سيسقطنا في نزعة صوفية مثالية؟ أي كيف نثبت التعدد في الاختلاف بالاختلاف والتعدد نفسيهما دون حاجة إلى مفهوم كلي نؤسس عليه هذا التعدد المتنافر؟ ثم، كيف نتكلم عن العالم الذي هو حي فينا، دون أن نوقفه لنتأمله؟ أي كيف نثبت أن كل ما يوجد هو على الحقيقة تعدد حركي حي وشديد، دون أن نستند على أي أساس مجرد صوري أو ميكانيكا مادية مباشرة؟ أي كيف نؤسس لوجود العالم نظريا، دون أن نضيع حيويته وماديته، ودون أن نسقط في الفراغ العدامي أو التأمل الثيولوجي؟ بعبارة مجتمعة، كيف ننشئ أنطولوجيا للسطوح لاتؤمن بالتعالي ولا بالعمق؟
ويسترسل المؤلف في طرح تساؤلاته الإشكالية الأكثر عمقا: “أما من الناحية القيمية، فيبدو لنا أن السؤال الذي حكم هذه الفلسفة كان هو: كيف نثبت الحياة ونؤسس للفعل الخلاف دون أن نسقط مركزية إنسية أو في مذهب لذّي بذيء؟ أي كيف نخلق فكرا يؤمن بالحياة كقوة تعددية اختلافية، وكيف نزكّي العالم كقوة خالصة وكإيتيقا مطلقة، دون أن نستند إلى أي مركزية موضوعية أو ذاتية، أي دون أن نحتاج إلى مفهوم جوهري نؤسس عليه، من مثل الإنسان أو العقل أو التاريخ، ودون أن نسقط من ناحية ثانية في قول “موت الإنسان” أو بالعدمية؟ بصيغة أخرى، كيف نؤكد الرغبة كمسار حي محايث مستقل لا دافع أصلي يحركه ولا غاية أخيرة يستقصدها، وكيف نكوّن بالتالي نظرية كلية إثباتية ومتماسكة في القيم، دون أن نسقط في التجريد الكانتي أو في المادية الفجة؟ وكيف نبني لعقل عملي إثباتي، دون التسليم للتوجهات الرخوة كنظريات “الحوار” أو أخلاق النقاش والتواصل؟
ويرى المؤلف أنه “من الناحية المعرفية، يبدو أن السؤال الناظم كان هو: كيف نبني تصورا في المعرفة دون أن نستند إلى مفاهيم الماهية والجوهر والحقيقة ومعايير الصورة الوثوقية للفكر وإشراطاتها الأخلاقية؟ بصيغة أخرى، كيف تكون الفلسفة كمعرفة ممكنة دون التنازل عن شيء لدعاوى نهاية الفلسفة، أو للمنطق التحليلي العلموي، أو لنسبة الهيرمينوطيقا؟ أي كيف تكون الحقيقة ممكنة دون الاستناد إلى الكوجيتو، ودون السقوط في النزعة النسبية، أو المعيارية التجريبية والمنطقية؟”.
ليس الجواب على أسئلة كهذه ولا تحقيق مشروع كهذا بأركانه الثلاثة ـ الانطولوجية والمعرفية والقيمية ـ كما يظهر، بالأمر الهين، وليس هو كذلك مما يمكن أن نلخصه في أجوبة متسرعة، ولكن من باب التمهيد والتوطئة الأولية، يمكن ان نعرض صيغا أولى مجملة في الجواب، على أن تكون كل الصفحات الآتية من هذا البحث، بسطا وبيانا لهذا الإجمال.
ثلاث زوايا للرؤية
أول أجوبة دولوز ـ من الناحية الأنطولوجية ـ هو القول بمفهوم عن الوجود يحمل بنفس المعنى على كل ما يوجد، أي على كل ما يختلف ويتنافر، ويحيا ويموت، وذلك بالاجتهاد لإثبات تصور خالص عن وجود سمته التواطؤ والاختلاف والتعدد؛ وجود تملؤه التفردات والأحداث غير الدالة التي تأتي بديلاً عن الثنائيات الميتافيزيقية الساكنة. ثاني هذه الأجوبة ـ من الناحية المعرفية ـ هو القول بفلسفة “أرضية”، محايثة، نوولوجية” (الدراسة الفلسفية لمسلمات الفكر وتاريخها)؛ فلسفة تسعى لإثبات الجذامير ضدا على الأشجار، وتعتمد منهاجا لها “التجريبية الفوقية” التي تؤسس لمجال يكون ماديا وغير وضعي في نفس الآن؛ مجال تتحدد فيه المعرفة كحركة وفعل “للافتراضي”، بحيث لا تكون الحقيقة في نفس النهاية إلا جماع الترهنات التي هي نتائج لفعل “الافتراضي”، ولهذا كانت الحقيقة زمانية في جوهرها، أي مسارا يحدث وليست معطى يتأمل، فـ”حقيقة” الحقيقة هي كونها صيرورة “مولدة للفوارق الافتراضية” différentiation وهذه الصيرورة هي ما يصنع ويحل الحقائق التي تترهن في وعي الأشخاص.
ثالث هذه الأجوبة ـ من الناحية القيمية ـ هو القول بالحياة كأصل وغاية، الحياة كقوة إثبات وفعل وشدة تتجاوز الأفراد، كالطاقة خلق تتجاوز الراهن والقائم، وتتطلع لإدراك الحدث الآتي الذي لا نستطيع أن نتحمل وقعه؛ الحياة التي لا تكون فيها الذوات سوى مفعولات للوجود نفسه، ولا يكون فيها الإنسان سوى حركة سطح ينطوي في الخارج، فالخارج عند دولوز هو ما يصنع تفرداتنا ويقدح وعينا، وهذا هو ما كان يعنيه حين قال بأننا لا نفكر ولا نتحقق إلا مرغمين، فلا ذوات ولا موضوعات في فكر دولوز، بل لا ثنائيات أصلا، لأن كل ذات هي تعدد وتركيب عارض يتحقق على السطح، فما الموجودات إلا تنافرات في الخارج تتحقق بالخارج نفسه، وهذا هو ما كان يقصده أيضا بقوله إن كل موجود هو في حقيقته نتيجة علاقة اختلاف.
يتساءل المؤلف: كيف يربط دولوز بين كل هذه العناصر؟ ويجيب: بـ”حركة الذهاب والإياب” التي هي سرعة الربط اللامتناهية بين الوجود والموجود، وبين الأنطولوجي و”الأونطي”، أي بحركة الوصل بين الطرفين والتي ليست إلا حدس الوجود نفسه، أي ما يحقق ويلم الاختلاف بين الشدة الخاصة بالموجود الفرد، و”واحدية الوجود” التي هو متحقق بها وفيها.
ويسأل: ماذا تكون دلالة العالم في النهاية بحسب هذا الذي تقدم؟ ويجيب: تكون هي العود الأبدي لما يختلف، فالعود الأبدي للاختلاف هو الدلالة الكلية غير الدالة للوجود والطبيعة؛ أي هو المعنى، الذي هو في النهاية غير عائد إلى أي معنى أصلي؛ “لا معنى” هو المولد لكل عنصر معطى. فالوجود هو هذا الذي يقدم المعنى دون أن يكون هو في ذاته حاملا لمعنى كلي، لأنه ليس إلا حركة الاختلاف والتكرار. فما يوجد في النهاية هو فقط تعدد المعنى المحمول على الاختلاف؛ أي هو العالم باعتباره ضربة النرد ـ بلغة مالارميه ـ التي تثبت الحظ الخلاق؛ فلا وجود إلا لهذا العالم الواحد الذي تتحقق فيه الموجودات كـ”سيمولاكرات” واختلافات لا تنفك عن التكون والتحلل بقوة الافتراضي الخلاقة.
من الواضح بذاته أن هذه التحديدات المجردة والأجوبة العامة، لا تدرك قيمتها ولا تتبين دلالتها ما لم نسع إلى تفصيلها جزيئيا، أي ما لم نعمل على تبين دقائقها وكيفية تحققها عمليا، وهذا أمر يتفق والطبيعة العامة لفلسفة دولوز، من حيث إن فلسفته هي “نسق جزيئي” يتحدث عن عالم تحكمه الحركات الصغرى، عالم هو عينه ذلك الذي تثبته الفيزياء المعاصرة (الفيزياء الذرية، نظرية الحبال)، ففلسفة دولوز هي ميتافيزيقا للخطوط والانثناءات، وعالمه هو عالم القوى والتلاقيات، وهذا ما يجعل من فكره “فيزياء فلسفية”، وما يفسر بالتالي نزوعه الطبيعاني وولعه بسبينوزا، ونفوره بالمقابل من التجريد. لكن هذه الفيزياء هي فيزياء فوقية، أي فيزياء تنظر في مادة “الحدث”، وليس في مادة الطبيعة، على ألا نفهم الحدث باعتباره ما يقوم ويتحقق في الراهن، بل باعتباره فعلا وقوة افتراضية معلقة دائما في الآتي.
فيلسوف لتاريخ الفلسفة
من المعروف عند المتمرسين بنصوص دولوز انه “فيلسوف لتاريخ الفلسفة”، برأي عادل حدجامي الذي اعتبر دولوز صاحب نظرية في كيفية التأريخ للفكر، فضلا عن كونه مؤرخا للفلسفة بالدلالة التقنية للوصف. واجتماع الصفتين وتداخلهما يجعل من قراءته في الحقيقة مسألة عسيرة، لأن خطابه حينها يصير خطابا فوقيا من درجة ثانية، خطابا لا يكتفي بعرض أفكاره هو أو بعرض أفكار السابقين عليه، بل يعتمد إلى التأريخ لتصورات فلسفية؛ أي أنه يعمد لتقديم كيفيات تاريخية في التفلسف، من خلال استشكالها من زاوية فلسفته هو، إذ إن دولوز لا يكتفي بعرض ما يجده في الفلسفات من أفكار، بل يسائل “الاقتصاد السياسي” المحرك لهذه الفلسفات، ويدمجه في “اقتصاده” الخاص، دون أن يعلن في الغالب عما هو من محض فلسفته، وما هو من صلب فلسفته من يؤرخ له، فيأتي تأريخه مواربا متحولا “ضد الجميع ومن أجل الجميع”، متزامنا مخاتلا لا يحتكم لثنائية “القبل” و”البعد”؛ جغرافيا تركيبيا “مرتقا” يتلازم فيه الابداع بالتأويل وتتفاعل فيه القراءة بالمقروء، ويتداخل الفكر بالفن، ليأتي عمله في النهاية أشبه ما يكون بفن رسم الوجوه عند الانطباعيين؛ رسما واقعيا بمقاييس ذاتية. غير ان هذا التلازم والتداخل والتزامن هو مطلوب عند دولوز، بل وضروري، إذ لمواجهة سديم “الكاووس” ينبغي لكل أفعال الفكر أن “تلتقي” ولكل بسط المقاومة أن تتماس، أكانت هذه الأفعال أحداثا تتحقق بمفاهيم (الفلسفة) أو آثارا تنشأ بانطباعات (الفن)، أو أوضاعا تصاغ بنظم (العلم).
والحقيقة ان هذه الكيفية في الاشتغال والكتابة ليس باعثها نزوة ذاتية، بل هي سعي من دولوز للاتساق مع جوهر فلسفته في المعرفة والقيم، والتي كان يلح دائما على أن غايتها هي التحرر من شروط الصورة الوثوقية للفكر، وبالتالي تجاوز المفهوم الأفلاطوني الهيغلي عن الحقيقة والأصل، ولهذا فضرب التصور المدرسي عن التأريخ الفلسفي ـ من حيث هو رغبة في “التطابق الموضوعي مع أصل” ـ هو سعي لضرب الميتافيزيقا نفسها، من حيث هي تاريخ يتراكم وينمو نحو نهاية جامعة، كما في التصور الثيولوجي، واجتهاد لضرب وهم الهوية والبداية والأساس التي يستند إليها كل تصور وثوقي. والرغبة في تجاوز حركة النمو والاكتمال الغائيين هذه هي أيضاً ليست وليدة نزوة لسبب ثان، وهو أنها تقترح نموذجا منهجيا واضحا يبدو من منظور دولوز هو الأقدر على النهوض بمطلبه، وهو النموذج الذي يمكن أن نسميه بـ “التاريخ الجغرافي”.
جاء هذا الكتاب في ثلاثة أقسام وبعدد كبير من الفصول التي لامس فيها المؤلف فلسفة جيل دولوز من كل الجوانب.
الوجود والاختلاف من ثلاث زوايا: الأنطولوجية والمعرفية والقيمية