بدوي الجبل
إكتشف سوريا

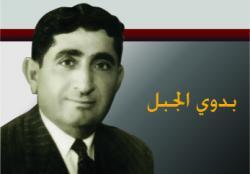
إكتشف سوريا

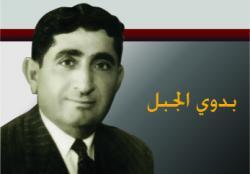
الكيان الشعري عند بدوي الجبل
على هامش الدراسة
نظرة حول ثنائية العقل والقلب في التجربة الصوفية:
ذكرنا في المقدمة أن أبعاد التجربة الصوفية غير محدودة، وأنها تتصل على نحو وثيق بكل تجارب الحياة، وأنه من الصعوبة بمكان أن نحدد أين تبدأ وأين تنتهي. ولكن حين يبدأ الحوار بين العقل والقلب قد يدخل المريد في التأمل، وفي التأمل يقول العارفون أن العقل والقلب يكونان منفتحين كلياً، وهذا التأمل يرتكز على ضبط الانتباه في الدماغ، ويضع الوعي على مستوى التأمل الفلسفي فينقل العقل إلى مدار الرؤى المجردة والخيال.
إلا أن هنالك مستوى آخر، وهو الحالة الصوفية السوية في التجربة الدينية، وهذا ما عبّر عنه أحد متصوفة إيران الكبار حين قال: «تتحقق الهداية باتحاد الدماغ والقلب، والحواس والطبيعة، وضلال النفوس ناجم عن تنافر هذه العناصر الأربعة وتباينها.
وبعد، فإن أنوار المعرفة هي الكاشفة لظلمة الغلفة والجهل. فلتبتعد عن نفسك، ولتنر الطريق الذي يمضي من القلب إلى الدماغ، ولا تترك القلب والعقل يعيشان كجارين بعيدين غير متعارفين، يجهل كل منهما الآخر. وكل هوى يشتد في قلبك اطرده باتحاد قوى القلب والعقل. وحين تصل حواسك مجتمعة إلى موطن القلب ولا تود الرجوع والنكوص، عندئذ تجد ذاتك. وإذا ما ربّيْتَ روحك الكثيفة من منبع الحياة، فسوف ترى صورتك النورانية».
نستخلص إذن، وكما ذكرنا أنه ثمة ثلاثة مراكز أساسية العقل والقلب والجسد، والطريق الصوفي يظهر في اجتذاب العقل إلى القلب حيث يتوحد الإنسان بكليته مع جسده أيضاً، والجسد هنا لا يُلْغَى بل يتوهّج بالنعمة، ولا يبقى ثمَّة انشطار بين عقل وغريزة، بل يغدو واحداً موحداً.
وحين يُجتذب العقل إلى القلب فإنه لا يعقلن الأشياء بل يحيا!!.
وفي أدب النسكيات فإن حالة اللاعقل هي الحفاظ على العقل والقلب نقيين من كل «فكر» وهذا هو النقاء أو الصمت العقلي، ويقول هذا الأدب أن الإنسان الذي لا يملك وعياً داخلياً كافياً يسقط بسهولة تحت سطوة فكر ما ويصير عبداً له!!.
ثالثاً-معنى الصحراء
كما ذكرنا أن الكيان الشعري عند بدوي الجبل قائم على قاعدة أفقية تتمثل «الموقف» فيها، هذا الموقف قد يصبح حضوراً للمكان في شعر البدوي، فالمكان أيضاً بُعْدٌ «أفقي»، هو ذلك البعد الذي يحتوي «التجربة» أو«المعاناة» وهي البعد العمودي الذي يعطي للمكان معناه وألقه، والمكان بدوره يعطيه أي للبعد العمودي تجسّداً وحضوراً من خلاله. هذا «المكان» نراه على نحو صارخ في قصائد البدوي بشكل خاص وقد يكون طاغياً في ما نسميه حضور «الصحراء» في شعره!!.
لاشك أن فهم معنى الصحراء عند بدوي الجبل يشكل مفتاحاً مهماً لاستكناه أبعاد الكيان الشعري عنده.
إن الصحراء عند البدوي هي همزة الوصل أو الجسر الذي يربط البعد السياسي بالبعد الصوفي والبعد الأفقي بالبعد العمودي.
فالصحراء تشكل أكثر من ثلاثة أرباع مساحة الوطن العربي، كما أنها مهد اللغة العربية، ومن ربوعها تفجر الدين الإسلامي، وأخيراً انطلقت منها في بدايات القرن العشرين (1916) الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي.
وهكذا تعكس الصحراء الهوية القومية العربية من جهة، والهوية الروحية من جهة أخرى. ففي الهوية القومية تعكس وحدة الأوطان العربية، وفي الهوية الروحية تعكس وحدة الوجود العميقة التي ينشدها الصوفي في وصاله مع الذات الإلهية من خلال رحلته عبر الصحراء!!.
الأطلال
الصحراء تخبئ سراً عميقاً دفيناً في أعماقها وصمتها، وليس عبثاً كثرة الشعراء الجاهليين الذين وقفوا على الأطلال في لوعةٍ عن ماضٍ ما، عن سرٍّ دفين خبأته رمال الصحراء، ورياحها. هذه الوقفة على الأطلال لم تغب عن شعر بدوي الجبل أيضاً، وامتزجت بكائيات وطنية وقومية في قصائد يشير إليها د.فاروق اسليم مثل «مرابع الأحباب» (1920)، و«على أطلال الجزيرة العربية» (1924)، وأخيراً «أين أين الرعيل من أهل بدر» (1952)، حيث يحدث تبدل في الوقفة من نسبة الطلل إلى الحبيبة الراحلة في الشعر الجاهلي إلى طلل البطولة فيقول فيها:
لا تسلها، فلن تجيب الطلولُ *** ألمغاويرُ مثخنٌ أو قتيلُ
موحشاتٌ يطوف في صمتها الدهرُ، فللدهر وحشةٌ وذهولُ
غاب عند الثرى أحباءُ قلبي فالثرى وحدَه الحبيب الخليلُ
الموت
الصحراء مسألة تحدي تواجه الإنسان العربي خصوصاً، وهي قادرة أن تزلزل أعماق أعماقه، الموت والزوال والاندثار في غياهب النسيان مصير ينتظر لا الأفراد فحسب بل الأمم أيضاً، يقول البدوي
ذرتِ السنون الفاتحين كأنهم *** رملٌ، تناوله مهبُّ رياحِ
وعلى مستوى الأفراد يظهر التحدي الذي تطرحه الصحراء، والموت والزوال والاندثار، فمن خلال هذا التحدي تبدأ المعاناة الوجودية، لماذا أنا موجود؟!، وهل يكفي إحساسي بأنني موجود في معنى أنني حي؟!، ما معنى الحياة؟!، وما معنى الموت؟!.
فثمة وقفة ومواجهة مع الموت لطالما وقف فيها العرب طويلاً، يذكر أ.عريفي عن الغزالي في سراج الطالبين على منهاج العارفين يقول: «رقة القلب وصفوته بذكر الموت»، وعن مولانا جلال الدين الرومي يقول: «إذا تشبثت بحالة، وتمسكت بها، ورفضت الانتقال منها إلى حالة أخرى، بقيت على بدايتك، ولم تصل إلى قمة الإنسانية، وذروة الكمالات الروحية»، وكذلك: «إن الإنسان لم ينل البقاء إلا عن طريق الفناء، فلماذا تفر يا هذا من الفناء الجديد الذي هو مقدمة للبقاء الخالد، ولماذا تتمسك بهذه الحياة وتلتصق بها، مع أنها تخلف حياة لا زوال لها، ولا خوف فيها، ولا أحزان بها، ولا متاعب، العارف لا يتوجع لمفارقة هذه الحياة، ولا يحزن، إن الموت عند العارفين نفحة حياة».
وبالطبع فإن هذه الوقفة لم تغب عن شاعرنا بدوي الجبل الذي يقول:
شبح الموت ما يخيف البرايا
وجد الناس في كؤوسك سُمَّاً
فاسقنيها قد طال صحوي ومكثي *** من حتوف تعانق الأرواحا
غير أني وجدت فيهن راحا
وتمنيـتُ سكراً ورواحا
الازدواجية
الصحراء هي ذلك المكان الذي يشعر فيه الكائن الإنساني بالعزلة عن الآخر، هذا الشعور الذي يولّد القسوة والعدوانية والحقد.
لاشك أن وعي الصحراء يخلق ازدواجية إن عرف المرء أن يصالح بين وجهيها اللذين يعكسان الوعي السيكولوجي لها فإنه يخرج من عزلته وينفتح على الآخر.
هذه الازدواجية يعبّر عنها البدوي في بيتين جميلين من قصيدة «يا وحشة الثأر»، يقول فيها:
عبدتُ فيها إلهَ الشمس منتقماً
الليلُ يخلقُ فيها الحُورَ مُترَفَةً *** ومعــذِّباً، وإله الليل رَحمانا
وتخلق الشمسُ جِنَّاناً وغيلانا
لاشك أن ما يذكره البدوي في هذين البيتين يحتاج إلى وقفة طويلة فهو حين يقول «عبدتُ فيها» أي الصحراء التي تعكس هذه الازدواجية. فهل نستطيع أن نصالح بين إله الشمس المنتقِم والمعذِّب والذي يخلق الجنّان والغيلان، وبين إله الليل الرحمن الذي يخلق الحور مترفةً؟!
إن إله الشمس هذا نراه حاضراً في روح القوة، روح القتال، وفي وقتنا هذا نراه حاضراً في روح النفط التي تخلق جنّاناً وغيلاناًً. في حين أن إله الليل نراه حاضراً في سر الحياة الروحية للإنسان العربي، في صوفيته، في أحلامه ورؤاه، في حياة السلام الداخلي والكمال، والخلاص لا يكمن في أن ننبذ جانباً على حساب جانب آخر، وإنما يكمن في المصالحة بين الجانبين!!.
السراب
في هذه الصحراء يخوض الصوفي والناسك والقديس معركة دامية أشد قسوة وعنفاً بأبعادها الكونية من كل معارك الأرض، إنها مسألة أكون أو لا أكون!!.
معركة قد يدمى الجسد فيها، ويهزل، ويضعف، وتصبح أسماله وثيابه ممزَّقَة – كما رأينا معناها في الفقرة السابقة – إلا أن ما يدمى فيه حقيقة هو «العظم» أي الروح فيه، وهكذا فالجهاد الروحي في الصحراء يأخذ طابع التصوف، طابع تلك التجربة الروحية الخارقة التي عرفها الكبار فينا، والتي نراها عند البعض كالذين ذكرهم أ.عريفي مثل شيخ العاشقين ابن الفارض الذي هام في الصحراء نحو خمس عشرة سنة، أو عند المكزون السنجاري الذي عبّر عنها من خلال قصيدة «تزكية نفس»، أو التي بلغت حدَّ الأسطورة كما نراها عن د.أسعد علي في «أسطورة الصحراء».
والصحراء هي تلك القوة المجهولة فينا أو ما يسميه د.بول شوشار «الحافز السري» الذي يجبرنا على أن نرغب فيما قد لا نود في الواقع أن نرغب فيه، ونقع أسرى له!!.
إنه ما يُسَمَّى بلغة الصحراء «السراب» الذي يخدع المسافر.
يقول د.فاروق اسليم: «السراب ظاهرة بصرية خادعة للمرتحلين عبر الصحراء، تمنحهم الشعور بقرب الوصول إلى الماء والحياة، قبل أن تفجأهم بمزيد من الرمال والهجير والظمأ. والسراب لذلك رمز لخداع قد يفضي إلى الهلاك، فهو خطر وبغيض».
لاشك أن معنى السراب يشير إلى حكمة سرية عميقة، ونلمح له ثلاثة مظاهر نستنبطها من هذه الأبيات التي أوردها د.فاروق اسليم للبدوي.
يقول في قصيدة «السراب المظلم»، ونرى فيها المظهر الأول:
حنا السرابُ على قلبي يخادعه
فكيف رُحتُ ولي علمٌ بباطله *** بالوهم من نشوةِ السقيا، ويغريه
أهوى السرابَ وأرجوه وأغليهِ؟
والمظهر الثاني نراه في هذين البيتين من القصيدة نفسها:
أدعو السرابَ إلى روحي، فقد حليتْ
لهفي عليه أسيراً في يدَيْ قدرٍ *** بها اللبانات ترضيه، وتغويه
يميته كل يومٍ، ثم يحييه
والمظهر الثالث في الخاتمة يقول:
أنتِ السراب، ولكني على ظمأي
محوتُ من قلبيَ الدنيا، فما سَلِمَت *** بأنهرِ الخمرِ في الفردوس أفديهِ
إلا طيوفُ هوانا وحدها فيه
فالسراب في مظهره الثالث الذي يعبر عن العطش، لكن هذا العطش في مظهره الثالث يقود للماء الحقيقي الذي هو «ليلى» الذات الإلهية، وحضورها في خيام ليلى!!.
الإنسان في الحقيقة «مسافر» على هذا الكوكب، ويظن أنه مقيم على هذا الكوكب إلى الأبد، ولكل إنسان «سرابه» الخاص، فهذا يريد أن يستولي على هذا «المكان» أو ذاك.. وآخر يريد «الشهرة» هنا وهناك.. وآخر يريد «اللذة» هنا وهناك.. وفي الحقيقة كله «سراب» وإذا قسنا عمر الإنسان بعمر الكون، ربما يكون جزءاً من أعشار الثانية من عمر الكون إن لم يكن أصغر بكثير.. فهو «مسافر» فقط، "عابر سبيل"، ولن يأخذ شيئاً معه، فهو "مسافر" فقط، "عابر سبيل"..!!. لكنه "مسافر" و«عابر سبيل» في الصحراء، وهذا يعطيه معنى كبيراً لوجوده وحياته وتجربته. فالصحراء هي ذلك المكان الذي يجب المرور فيه واجتيازه نحو الحياة التي لا تموت ولا تفنى.
إن حضارة الإسمنت المسلَّح قد غيَّبَتْ حقيقة الصحراء من وعي الإنسان بشكل عام، والإنسان العربي بشكل خاص، إلا أن حضورها في لا وعيه ما زال قوياً، وذلك البدوي يضجّ في عروقه. إن في جعبته رسالة، ليت الإنسان العربي يستطيع فك رموزها!!.
على هامش الدراسة
نظرة حول ثنائية العقل والقلب في التجربة الصوفية:
ذكرنا في المقدمة أن أبعاد التجربة الصوفية غير محدودة، وأنها تتصل على نحو وثيق بكل تجارب الحياة، وأنه من الصعوبة بمكان أن نحدد أين تبدأ وأين تنتهي. ولكن حين يبدأ الحوار بين العقل والقلب قد يدخل المريد في التأمل، وفي التأمل يقول العارفون أن العقل والقلب يكونان منفتحين كلياً، وهذا التأمل يرتكز على ضبط الانتباه في الدماغ، ويضع الوعي على مستوى التأمل الفلسفي فينقل العقل إلى مدار الرؤى المجردة والخيال.
إلا أن هنالك مستوى آخر، وهو الحالة الصوفية السوية في التجربة الدينية، وهذا ما عبّر عنه أحد متصوفة إيران الكبار حين قال: «تتحقق الهداية باتحاد الدماغ والقلب، والحواس والطبيعة، وضلال النفوس ناجم عن تنافر هذه العناصر الأربعة وتباينها.
وبعد، فإن أنوار المعرفة هي الكاشفة لظلمة الغلفة والجهل. فلتبتعد عن نفسك، ولتنر الطريق الذي يمضي من القلب إلى الدماغ، ولا تترك القلب والعقل يعيشان كجارين بعيدين غير متعارفين، يجهل كل منهما الآخر. وكل هوى يشتد في قلبك اطرده باتحاد قوى القلب والعقل. وحين تصل حواسك مجتمعة إلى موطن القلب ولا تود الرجوع والنكوص، عندئذ تجد ذاتك. وإذا ما ربّيْتَ روحك الكثيفة من منبع الحياة، فسوف ترى صورتك النورانية».
نستخلص إذن، وكما ذكرنا أنه ثمة ثلاثة مراكز أساسية العقل والقلب والجسد، والطريق الصوفي يظهر في اجتذاب العقل إلى القلب حيث يتوحد الإنسان بكليته مع جسده أيضاً، والجسد هنا لا يُلْغَى بل يتوهّج بالنعمة، ولا يبقى ثمَّة انشطار بين عقل وغريزة، بل يغدو واحداً موحداً.
وحين يُجتذب العقل إلى القلب فإنه لا يعقلن الأشياء بل يحيا!!.
وفي أدب النسكيات فإن حالة اللاعقل هي الحفاظ على العقل والقلب نقيين من كل «فكر» وهذا هو النقاء أو الصمت العقلي، ويقول هذا الأدب أن الإنسان الذي لا يملك وعياً داخلياً كافياً يسقط بسهولة تحت سطوة فكر ما ويصير عبداً له!!.
ثالثاً-معنى الصحراء
كما ذكرنا أن الكيان الشعري عند بدوي الجبل قائم على قاعدة أفقية تتمثل «الموقف» فيها، هذا الموقف قد يصبح حضوراً للمكان في شعر البدوي، فالمكان أيضاً بُعْدٌ «أفقي»، هو ذلك البعد الذي يحتوي «التجربة» أو«المعاناة» وهي البعد العمودي الذي يعطي للمكان معناه وألقه، والمكان بدوره يعطيه أي للبعد العمودي تجسّداً وحضوراً من خلاله. هذا «المكان» نراه على نحو صارخ في قصائد البدوي بشكل خاص وقد يكون طاغياً في ما نسميه حضور «الصحراء» في شعره!!.
لاشك أن فهم معنى الصحراء عند بدوي الجبل يشكل مفتاحاً مهماً لاستكناه أبعاد الكيان الشعري عنده.
إن الصحراء عند البدوي هي همزة الوصل أو الجسر الذي يربط البعد السياسي بالبعد الصوفي والبعد الأفقي بالبعد العمودي.
فالصحراء تشكل أكثر من ثلاثة أرباع مساحة الوطن العربي، كما أنها مهد اللغة العربية، ومن ربوعها تفجر الدين الإسلامي، وأخيراً انطلقت منها في بدايات القرن العشرين (1916) الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي.
وهكذا تعكس الصحراء الهوية القومية العربية من جهة، والهوية الروحية من جهة أخرى. ففي الهوية القومية تعكس وحدة الأوطان العربية، وفي الهوية الروحية تعكس وحدة الوجود العميقة التي ينشدها الصوفي في وصاله مع الذات الإلهية من خلال رحلته عبر الصحراء!!.
الأطلال
الصحراء تخبئ سراً عميقاً دفيناً في أعماقها وصمتها، وليس عبثاً كثرة الشعراء الجاهليين الذين وقفوا على الأطلال في لوعةٍ عن ماضٍ ما، عن سرٍّ دفين خبأته رمال الصحراء، ورياحها. هذه الوقفة على الأطلال لم تغب عن شعر بدوي الجبل أيضاً، وامتزجت بكائيات وطنية وقومية في قصائد يشير إليها د.فاروق اسليم مثل «مرابع الأحباب» (1920)، و«على أطلال الجزيرة العربية» (1924)، وأخيراً «أين أين الرعيل من أهل بدر» (1952)، حيث يحدث تبدل في الوقفة من نسبة الطلل إلى الحبيبة الراحلة في الشعر الجاهلي إلى طلل البطولة فيقول فيها:
لا تسلها، فلن تجيب الطلولُ *** ألمغاويرُ مثخنٌ أو قتيلُ
موحشاتٌ يطوف في صمتها الدهرُ، فللدهر وحشةٌ وذهولُ
غاب عند الثرى أحباءُ قلبي فالثرى وحدَه الحبيب الخليلُ
الموت
الصحراء مسألة تحدي تواجه الإنسان العربي خصوصاً، وهي قادرة أن تزلزل أعماق أعماقه، الموت والزوال والاندثار في غياهب النسيان مصير ينتظر لا الأفراد فحسب بل الأمم أيضاً، يقول البدوي
ذرتِ السنون الفاتحين كأنهم *** رملٌ، تناوله مهبُّ رياحِ
وعلى مستوى الأفراد يظهر التحدي الذي تطرحه الصحراء، والموت والزوال والاندثار، فمن خلال هذا التحدي تبدأ المعاناة الوجودية، لماذا أنا موجود؟!، وهل يكفي إحساسي بأنني موجود في معنى أنني حي؟!، ما معنى الحياة؟!، وما معنى الموت؟!.
فثمة وقفة ومواجهة مع الموت لطالما وقف فيها العرب طويلاً، يذكر أ.عريفي عن الغزالي في سراج الطالبين على منهاج العارفين يقول: «رقة القلب وصفوته بذكر الموت»، وعن مولانا جلال الدين الرومي يقول: «إذا تشبثت بحالة، وتمسكت بها، ورفضت الانتقال منها إلى حالة أخرى، بقيت على بدايتك، ولم تصل إلى قمة الإنسانية، وذروة الكمالات الروحية»، وكذلك: «إن الإنسان لم ينل البقاء إلا عن طريق الفناء، فلماذا تفر يا هذا من الفناء الجديد الذي هو مقدمة للبقاء الخالد، ولماذا تتمسك بهذه الحياة وتلتصق بها، مع أنها تخلف حياة لا زوال لها، ولا خوف فيها، ولا أحزان بها، ولا متاعب، العارف لا يتوجع لمفارقة هذه الحياة، ولا يحزن، إن الموت عند العارفين نفحة حياة».
وبالطبع فإن هذه الوقفة لم تغب عن شاعرنا بدوي الجبل الذي يقول:
شبح الموت ما يخيف البرايا
وجد الناس في كؤوسك سُمَّاً
فاسقنيها قد طال صحوي ومكثي *** من حتوف تعانق الأرواحا
غير أني وجدت فيهن راحا
وتمنيـتُ سكراً ورواحا
الازدواجية
الصحراء هي ذلك المكان الذي يشعر فيه الكائن الإنساني بالعزلة عن الآخر، هذا الشعور الذي يولّد القسوة والعدوانية والحقد.
لاشك أن وعي الصحراء يخلق ازدواجية إن عرف المرء أن يصالح بين وجهيها اللذين يعكسان الوعي السيكولوجي لها فإنه يخرج من عزلته وينفتح على الآخر.
هذه الازدواجية يعبّر عنها البدوي في بيتين جميلين من قصيدة «يا وحشة الثأر»، يقول فيها:
عبدتُ فيها إلهَ الشمس منتقماً
الليلُ يخلقُ فيها الحُورَ مُترَفَةً *** ومعــذِّباً، وإله الليل رَحمانا
وتخلق الشمسُ جِنَّاناً وغيلانا
لاشك أن ما يذكره البدوي في هذين البيتين يحتاج إلى وقفة طويلة فهو حين يقول «عبدتُ فيها» أي الصحراء التي تعكس هذه الازدواجية. فهل نستطيع أن نصالح بين إله الشمس المنتقِم والمعذِّب والذي يخلق الجنّان والغيلان، وبين إله الليل الرحمن الذي يخلق الحور مترفةً؟!
إن إله الشمس هذا نراه حاضراً في روح القوة، روح القتال، وفي وقتنا هذا نراه حاضراً في روح النفط التي تخلق جنّاناً وغيلاناًً. في حين أن إله الليل نراه حاضراً في سر الحياة الروحية للإنسان العربي، في صوفيته، في أحلامه ورؤاه، في حياة السلام الداخلي والكمال، والخلاص لا يكمن في أن ننبذ جانباً على حساب جانب آخر، وإنما يكمن في المصالحة بين الجانبين!!.
السراب
في هذه الصحراء يخوض الصوفي والناسك والقديس معركة دامية أشد قسوة وعنفاً بأبعادها الكونية من كل معارك الأرض، إنها مسألة أكون أو لا أكون!!.
معركة قد يدمى الجسد فيها، ويهزل، ويضعف، وتصبح أسماله وثيابه ممزَّقَة – كما رأينا معناها في الفقرة السابقة – إلا أن ما يدمى فيه حقيقة هو «العظم» أي الروح فيه، وهكذا فالجهاد الروحي في الصحراء يأخذ طابع التصوف، طابع تلك التجربة الروحية الخارقة التي عرفها الكبار فينا، والتي نراها عند البعض كالذين ذكرهم أ.عريفي مثل شيخ العاشقين ابن الفارض الذي هام في الصحراء نحو خمس عشرة سنة، أو عند المكزون السنجاري الذي عبّر عنها من خلال قصيدة «تزكية نفس»، أو التي بلغت حدَّ الأسطورة كما نراها عن د.أسعد علي في «أسطورة الصحراء».
والصحراء هي تلك القوة المجهولة فينا أو ما يسميه د.بول شوشار «الحافز السري» الذي يجبرنا على أن نرغب فيما قد لا نود في الواقع أن نرغب فيه، ونقع أسرى له!!.
إنه ما يُسَمَّى بلغة الصحراء «السراب» الذي يخدع المسافر.
يقول د.فاروق اسليم: «السراب ظاهرة بصرية خادعة للمرتحلين عبر الصحراء، تمنحهم الشعور بقرب الوصول إلى الماء والحياة، قبل أن تفجأهم بمزيد من الرمال والهجير والظمأ. والسراب لذلك رمز لخداع قد يفضي إلى الهلاك، فهو خطر وبغيض».
لاشك أن معنى السراب يشير إلى حكمة سرية عميقة، ونلمح له ثلاثة مظاهر نستنبطها من هذه الأبيات التي أوردها د.فاروق اسليم للبدوي.
يقول في قصيدة «السراب المظلم»، ونرى فيها المظهر الأول:
حنا السرابُ على قلبي يخادعه
فكيف رُحتُ ولي علمٌ بباطله *** بالوهم من نشوةِ السقيا، ويغريه
أهوى السرابَ وأرجوه وأغليهِ؟
والمظهر الثاني نراه في هذين البيتين من القصيدة نفسها:
أدعو السرابَ إلى روحي، فقد حليتْ
لهفي عليه أسيراً في يدَيْ قدرٍ *** بها اللبانات ترضيه، وتغويه
يميته كل يومٍ، ثم يحييه
والمظهر الثالث في الخاتمة يقول:
أنتِ السراب، ولكني على ظمأي
محوتُ من قلبيَ الدنيا، فما سَلِمَت *** بأنهرِ الخمرِ في الفردوس أفديهِ
إلا طيوفُ هوانا وحدها فيه
فالسراب في مظهره الثالث الذي يعبر عن العطش، لكن هذا العطش في مظهره الثالث يقود للماء الحقيقي الذي هو «ليلى» الذات الإلهية، وحضورها في خيام ليلى!!.
الإنسان في الحقيقة «مسافر» على هذا الكوكب، ويظن أنه مقيم على هذا الكوكب إلى الأبد، ولكل إنسان «سرابه» الخاص، فهذا يريد أن يستولي على هذا «المكان» أو ذاك.. وآخر يريد «الشهرة» هنا وهناك.. وآخر يريد «اللذة» هنا وهناك.. وفي الحقيقة كله «سراب» وإذا قسنا عمر الإنسان بعمر الكون، ربما يكون جزءاً من أعشار الثانية من عمر الكون إن لم يكن أصغر بكثير.. فهو «مسافر» فقط، "عابر سبيل"، ولن يأخذ شيئاً معه، فهو "مسافر" فقط، "عابر سبيل"..!!. لكنه "مسافر" و«عابر سبيل» في الصحراء، وهذا يعطيه معنى كبيراً لوجوده وحياته وتجربته. فالصحراء هي ذلك المكان الذي يجب المرور فيه واجتيازه نحو الحياة التي لا تموت ولا تفنى.
إن حضارة الإسمنت المسلَّح قد غيَّبَتْ حقيقة الصحراء من وعي الإنسان بشكل عام، والإنسان العربي بشكل خاص، إلا أن حضورها في لا وعيه ما زال قوياً، وذلك البدوي يضجّ في عروقه. إن في جعبته رسالة، ليت الإنسان العربي يستطيع فك رموزها!!.
